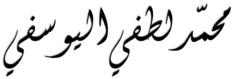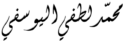ماريو سكاليزي شاعر اختار لنفسه اسم الشاعر الملعون عن روية وفكر واختيار. فلقد كان على يقين من أن القدر قد رشحه للقيام بأمرين لا يقل أحدهما عن الآخر عنفا: مواجهة رعب الوجود وكتابة الشعر. كانت إقامته على الأرض ملحمة صراع ضد الفاقة والمرض والظلم الاجتماعي. وكان شعره مواجهة عنيدة لقدر لم يختره لكنه اختار أن ينازله. كان ماريو سكاليزي على يقين من أن لا معنى للكائن ولا معنى لحياته أصلا إن هو لم يثأر للكرامة البشرية المنتهكة في الأرض قاطبة. كان على يقين أيضا من أن الشعر واللعب بالكلمات هو آخر ما يتبقى بين يدي الانسان حين تعصف به المحن والرزايا.
ولد ماريو سكاليزي يوم 6 شباط (فبراير) سنة 1892 في تونس، ومنذ نعومة أظفاره تلقّفته الرزايا أشكالا وألوانا. فلقد أصيب بداء التواء العمود الفقري قبل أن يتجاوز سن الخامسة. وقضى ما تبقّى من عمره يعاني من تشوّه شكله ووهن جسده. ولطالما احتمى بالشعر وبالكلمات ليتطهّر من إحساسه العاتي بأن الأقدار قد ابتلته ظلما، إذ حكمت عليه بأن يجرجر جسده الأحدب الملتوي كالصليب حتى القبر.
لذلك كثيرا ما تحوّلت الكتابة لديه إلى نشيد أسود يرفع احتجاجا على البلية. فلئن تحدّثت كتب التاريخ والقصص التي دوّنت أخبار القديسين والمصطفين والمصلحين عما تعرّضوا له في حيواتهم من تنكيل وصلب وتقتيل، فإنها لم تحدّث عن شخص شُوّه جسده حتى اتخذ شكل صليب ملتو. لم تحدّث عن شخص أرغمت روحه على أن تقطن جسدا صار من شدّة تشوّهه مثل الصليب تماما. عديدة هي المرّات التي عبّر فيها سكاليزي عن ضجره بقدره ومقته لجسده فجاءت أشعاره طافحة بالنوح والنحيب. يكتب مثلا:
كان ظلّه، كان ظلّ جسده يمتدّ قدّامه مثل صليب مخز
هي ذي، هي ذي الروح تنتفض ضدّ جسدها
روح تواجه اللعنة الأبدية بالنحيب.
عن نية وقصد سيختار ماريو سكاليزي لقب الشاعر الرجيم حينا، ولقب الشاعر الملعون حينا آخر. وسيعدّ أشعاره أناشيد طالعة من غياهب الجحيم ويضع لديوانه عنوانا دالاّ على وعيه الدرامي بأن اللعنة التي حلّت به ليست سوى الفصل الأبشع في مأساة بني البشر أجمعين. ”قصائد شاعر ملعون- أشعار من غياهب الجحيم“. هكذا نعت نفسه ونعت ديوانه. وسيواجه عدمه الخاص باعتباره عتبة مفتوحة على العدم المتربّص بالوجود ذاته منذ الأزل. والراجح أن هذا الوعي المأساوي الفاجع لم يتولّد عما آل إليه أمر جسده من تشوّهات وما آلت إليه حاله من عذابات فحسب، بل كان مردّه شظف العيش وقلّة الرزق ورقّة الحال. أب بالكاد يكسب قوت عياله. أمّ قابعة في البيت ترعى طفلا متوقّد الذكاء لكنه مقعد محدودب الظهر. فتلوذ بالدمع حينا، وحينا ترفع يديها إلى السماء وهي على يقين من أن باب الشفاء قد أقفل في وجه ابنها إلى الأبد.
كان والد ماريو سكاليزي يشتغل بالسكك الحديدية التي كان أغلب عمالها من الإيطاليين. وهو يتحدّث عنه لا باعتباره إيطاليا بل باعتباره تونسيا قدم من جزيرة صقلية. لكنه يومئ إيماء إلى أن ما حلّ به من عذاب ليس سوى جزء من العقاب الذي أنزلته السماء على والده الذي وصل إلى تونس فارّا من العدالة الإيطالية على إثر جريمة ارتكبها بجزيرة صقلية. لذلك كثيرا ما حرص على أن يرسم لوالده صورة الكادح الذي انتدبته الحياة للبؤس. لكنه يظلّ رغم شظف العيش وشحّ المال وانعدام الأمل رمزا لما تنبني عليه المنزلة البشرية ذاتها من عناد وقدرة على منح الحياة فرصة الاستمرار. يكتب في قصيدة بعنوان ”عقاب“:
رأيت من خلال المطر المدرار الهائل، رأيته في العتمة
أبي العجوز محدّبا داخل معطفه الداكن.
ها هنا كان يمارس عمله كمحوّل سير.
لم يكن لديه أمل في غد أفضل.
لم يكن له مأوى. كان الماء المتلألئ الجبان
يسيل فوق رقبته، ويبلل شواربه.
ويرسم سكاليزي لأمه صورة تكشف حياة خاضعة مستكينة طافحة بالمرارات لكنها لا تخلو من الرقة والحنان. يكتب في قصيدة بعنوان ”أمّي“:
هل اهترأ قلبك، يا أمّي
لا أجرؤ أمام عينيك الباردتين،
أن أتضرع إليك راجيا
أن تقبّليني كما كنت تفعلين.
…………………….
ما تبقّى لي من شباب
اختطفه مني أساك.
وكثيرا ما تعود صورة الأمّ في قصائد سكاليزي مقترنة بفكرة البؤس والفاقة والعذاب. يكتب في قصيدة تحمل عنوان ”تمرّد“:
الماء الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه يؤجّج جوعي.
أمي أما عادت لديك
قطعة واحدة من خبز؟
وراء هذا الحزن تتراءى أحيانا نادرة بعض لحظات الفرح المرتبط بالحياة الجماعية للعائلات الإيطالية في شتاءات تونس. يكتب في قصيدة بعنوان ”حادث“ محدّثا عن احتفالات عيد الميلاد:
كان عيد الميلاد. شتاء أفريقيا،
هذا الشتاء ذو النيسانات المتشابهة،
كان يزهر في الهواء البلسمي
تحت توهّجات الشمس.
……………….
كنت أذهب هناك بحثا عن أوراق اللعب.
قانون عرفي قديم
استدعى أن نلعب بالكعكة
والفول المطهو والجوز.
تتحدّر أمّ ماريو سكاليزي من أسرة مالطية من أصل إيطالي. أما أبوه فهو إيطالي خالص. وقد وصلا تونس خلسة هربا من العدالة الإيطالية. وكان العديد من الإيطاليين قد توطّنوا البلاد التونسية حين سدّت في وجوههم أبواب الرزق بإيطاليا. كان أغلبهم من مدن الجنوب ولاسيما جزيرة صقلية المتاخمة للسواحل التونسية. والثابت تاريخيا أن السلطات الإيطالية وقتها كانت تغض الطرف عن هذه الهجرات السرية وتشجّعها أحيانا كثيرة ليقينها أن الفرنسيين قد أقروا العزم على احتلال المغرب العربي بأسره وتكاثر عدد الإيطاليين في تونس سيمنحها فرصة احتلالها بدعوى حماية الجالية الإيطالية.
لم يكن والد سكاليزي ينتمي إلى رجال الأعمال القائمين على عالم التجارة أو الصناعة أو المهن الحرّة وهم فئة قد سيطرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتونس منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ وما كان جزءا من حركة الهجرة السياسية التي سبقت توحيد إيطاليا، وقد تكونت في معظمها من مثقفين وجنود وتقنيين ينتمون إلى البرجوازية الإيطالية ويحاولون الهرب من هيمنة الدولة وتسلّطها. بل كان مقدمه إلى تونس في نطاق هجرة البروليتاريا المدقعة من جنوب إيطاليا باتجاه أفريقيا بحثا عن العمل في موطن بديل. كان هؤلاء الوافدون الطليان قادمين من المناطق الأكثر فقرا ولاسيما جزيرتي صقلية وسردينيا. ومثلما يفعل المهاجرون عادة تجمّع الإيطاليون داخل أحياء مغلقة تقريبا كثيرا ما أطلقوا عليها اسم صقلية الصغرى. وقد تغلغلت هذه الفئة من المهاجرين بين التونسيين تقاسمهم ظروف الحياة البائسة ذاتها، والمعاناة نفسها.
أمضى سكاليزي طفولته في قلب الجالية الإيطالية. وهي جالية متكونة من مجموعة من المعدمين الذين رست بهم سفن إيطالية في موانئ تونس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولشدّة فقرهم وفاقتهم دعاهم المؤرخ الإيطالي نولو بازوتي Nullo Pasotti الجنس العاري le nude braccia (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
ولما كان سكاليزي متحدّرا من هذا الجنس العاري فقد اضطر أن يكسب رزقه منذ سن مبكرة جدّا. فاشتغل محاسبا في العديد من المتاجر بتونس. ولم يكن وضعه ليعرف الاستقرار أبدا، حتى أنه لم يكن دائما يجد ما به يسد رمقه.
لم يلتحق بالمدرسة إلا لماما. فلم يدم بقاؤه في المدرسة الفرنسية إلا قليلا. واضطرّ إلى أن يقوم بمفرده بجهود متواصلة للتحصيل الثقافي وتوسيع آفاق معارفه. كانت القراءات الغزيرة والمتنوعة سبيله إلى ذلك، إلى أن اشتعلت فيه شعلة الشعر. وفيما كان يتمرّس بالشعر والقصائد تنقاد إليه وتنثال عليه انثيالا كان سخطه يزداد كلما ارتطم بالواقع المرير وكلما تلفّت إلى بؤسه الخاص وبؤس الناس من حوله.
لذلك ظل الموضوع القار في كتابات ماريو سكاليزي التعبير عن الأسى والجهد والبؤس وانعدام العدالة والاستنهاض للثورة والتمرّد. عديدة هي القصائد التي تختفي منها نبرة التأسّي والنوح على الذات فتصبح الكتابة عبارة عن تمجيد للحياة وإعلاء للحياة واحتفاء بالشعب باعتباره حامل جذوة القوة المقدسة التي ستهدم عالم الطغاة والمستبدّين وتثأر للكرامة البشرية المنتهكة. هذا التوجّه الثوري هو الذي جعل ماريو سكاليزي يتعامل مع مأساته الذاتية باعتبارها جزءا من مأساة المقهورين والمضطهدين. وهو الذي جعله يتخلى عن الطابع الغنائي ويشرع في كتابة الملحمة حيث يقوم بتجسيد الصراع الذي يخوضه العمال والفقراء والمقهورون بحثا عن فسحة من نور في ليل وجودهم العاثر. اختار لنصّه عنوان ”ملحمة الفقير“ وتناول فيها بؤس بني البشر في العهد الإقطاعي وبؤسهم آن استولت البورجوازية على مقاليد الأمور وتناول بؤس زنوج أمريكا واعتبر تمثال الحرية مجرّد فكاهة. ذلك أن عذاب الزنوج يكشف أن حلم البشرية بعالم أقل ويلا قد تبخّر حتى في العالم الجديد الذي قصده الناس هربا من الفاقة والظلم الاجتماعي. لذلك يصوّر أمريكا على أنها حاملة مشعل الحرية ثم يهزّئ هذا التصوّر ويحتفي بالسود ونضالاتهم فيكتب محتفيا بالصراع الذي يخوضه الزنوج:
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
وتعد ”ملحمة الفقير“ أبرز قصيدة طويلة متكونة من 36 مقطوعة أنشدها سكاليزي للعمّال والمضطهدين الذين كانوا يكوّنون وسطه التونسي-الإيطالي. كانت الملحمة فاتحة. كانت طريقا مؤدّية إلى كتابة أشعار تستنهض الهمم لرفض فكرة الظلم الاجتماعي نفسها. كتب مثلا:
في حين ينتشي الثراء بعماء،
أحييك، يا نهر العرق المهيب،
باسم الأمل والمنتقمين القادمين،
باسم الراضخين الذين يضنيهم العمل العبثيّ.
وحالما شرع سكاليزي في كتابة هذه الملاحم ذاعت شهرته في أوروبا ذاتها إذ قامت جريدة إيطالي من تونس LItaliano di Tunisi وهي إحدى الجرائد الأوروبية القليلة بتقديمه إلى القراء الأوروبيين على أنه ”شاعر بروليتاريا تونس“. ثم تلقفت الجرائد والدوريات الفرنسية أشعاره. (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
حين نبحث في أرشيف المكتبة الوطنية بتونس عن العلامات التي وسمت الحياة الثقافية والاجتماعية في تونس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يبرز اسم سكاليزي باعتباره شخصيّة متفردة متعددة الأبعاد والانتماءات الثقافية. فهو شاعر تونسي من أصل إيطالي يكتب باللغة الفرنسية ويطرق من الموضوعات ما يجعله شاعرا ناطقا بلسان حال التونسيين والإيطاليين المضطهدين ويحوّل أشعاره إلى مدائح ترفع تمجيدا للحياة وفضحا للمستعمرين والطغاة. يعمد مثلا في نص بعنوان ”سونيتا الاستعمار“ إلى التنديد بفرنسا وجبروتها فيتوجّه بالكلام إلى والد شهيد:
الوطن شبيه بعرائس البحر العتيقة
التي كانت أصواتها تضيع البحّارة.
الوطن يجحد الأغنيات: لكن نحيبه الإلهي
يلهم النفس رغبة النخل السيّد
نواقيس الخطر تقرع في فجرنا الهادئ الصافي
الحرائق تبهر البراري والبحار
فيما فرنسا في ثوب الحداد تلثم العيون المغمضة،
عيون شباب في ربيع العمر هلكوا في حلبات النزال الحمراء
أيها الأب الذي بقي وحيدا في عزّ المساء
نيسان ابنك، حمرة دمه
زهر سيورق على رايات الملحمة
ابنك اختار على شعاع السماء ونورها
الرقة الوحشية لرقدة الأبطال،
الرقدة الرميم في أرض حيث الأجداد ناموا.
إن تنوّع المصادر التي عرّفت بسكاليزي وتناولت أشعاره ومقالاته بالنقد يؤكّد في حدّ ذاته هذا الانتماء الحضاري المتعدّد. لقد كتب سكاليزي بالفرنسية لغة المستعمر. وكان من الطبيعي أن يعدّه النقد الفرنسي أحد الوجوه البارزة في الحركة الفكرية الفرنسية بتونس. وهذا ما ذهب إليه إيف شاتلان Yves Châtelain مثلا في كتابه الحياة الأدبية والفكرية بتونس بين 1900 و1937 (Vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937). ولكنه يذكره أيضا ضمن الصفحات المخصصة للحركة الفكرية الإيطالية، رغم أنه يفعل ذلك بهدف التركيز على هجرة الأقلام الإيطالية نحو التعبير باللغة الفرنسية كنتيجة للهيمنة الحضارية واللغوية للمستعمر الفرنسي.
ولأن سكاليزي من أصل إيطالي عمد غاسبار داغوانو Gaspare DAguanno إلى اعتباره شاعرا إيطاليا خالصا فكتب عنه دراسة مطولة بالفرنسية ونشرها بمدينة تراباني في صقلية مسقط رأس أب سكاليزي، فصارت مدينة تراباني تفاخر بسكاليزي وتحتفي به باعتباره أحد مواطنيها الذين أصبحوا مشهورين. وفي الوقت ذاته سيواصل المغرب العربي في دوريّاته تمسّكه بسكاليزي باعتباره ابن البيئة التونسية والناطق بآمال شعوب المغرب في التحرر والكرامة.
لذلك ستعتبر جمعية أدباء شمال أفريقيا أعمال سكاليزي جزءا من الموروث الثقافي التونسي، وتعدّه أمارة على وجود أدب قائم بذاته بالمغرب العربي، وشاهدا على ثراء الحياة الأدبية بتونس وتفردها في تلك المرحلة من تاريخها، لأن سكاليزي شاعر يجسد هذا التفرّد باعتبار أن أشعاره تكشف بعنف أبعاد هذه الهويّة المتعدّدة.
أما ماريو سكاليزي فإنه صنّف نفسه واختار عائلته حين وضع لديوانه عنوان ”قصائد شاعر ملعون“. وهو عنوان يشير صراحة إلى أنه يعتبر نفسه ملعونا لا بسبب الوشائج الروحية التي تربطه بالمدرسة الفرنسية للشعراء الملاعين، بل أيضا بسبب ارتباطه بالبؤس الذي وسم حياة المهاجرين الإيطاليين بتونس، وخاصة منهم القادمين من صقلية، وبسبب إقامته في بلاد تآمر الطغاة والغزاة على ناسها وغدها. ولهذا أيضا جاء العنوان الفرعي ”أشعار من غياهب الجحيم“ بمثابة إلحاح على أن الشاعر الحق إنما هو ذاك الذي يقاسم المغلوبين والمقهورين جحيمهم ولا يفرّ من المنازلة حتى إذا كان بإمكانه تحقيق خلاصه الفردي. لذلك سيلتصق سكاليزي بالمكان ولن يحدّث عن أمجاد العرب والمسلمين كما يحدّث الرومانسيون الغربيون الذين تعاملوا مع الشرق باعتباره موطن الخرافة والسحر وتدويخ الحواس وبلسم الإنسان الأوروبي الذي ضجر بعقلانية عصر الأنوار، بل سيتغنى بالمكان وبالمعمار الشرقي ويعتبر العرب حمالة حقيقة وبناة حضارة. يكتب في نص بعنوان ”الصومعات“:
أيتها الصومعات، بهاء أنت فوق الدكاكين
صرخة من حجر دافقة من قلب الشرق العظيم
أيتها الأبراج البيضاء
أنت مثل حراس من المتصوّفة ترقبين
رعشة الأمل في قلب السماء الضحوك
منارات أنت نورها قُـدَّ من صلوات
منارات تشعّ التقوى فيها مثل بيت طهور
من بعيد ترسمين في وجه القادمين من السماء
محيط اللازورد
الدرب السالكة للأرض
كم أهوى أن أراك منتصبة قبالة المغيب وهو يحترق
مثل حرّاس مدينة من ذهب
كم أهوى أن أراك في الأفق الرائع وقت المغيب
حين نحلم بحدائق يزهر فيها الموت والعدم.
نداء المؤذنين الذي يبلغ حتى مسامع الراقدين في القبور
يبدو كأنه سؤال تطرحينه على الأثير الأزرق
وحين الحمائم تأتي وتحطّ على أكتافك
توشوشك إجابة الله.
هجرات تتلوها هجرات. هكذا كانت حياة سكاليزي. فمنذ اللحظة التي هاجر فيها والداه من إيطاليا تلقفت الهجرة حياة ماريو سكاليزي وصارت قدرا ومصيرا. هاجر من الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية الإسلامية وعشقها. هاجر من لغته الإيطالية فكتب بالفرنسية وأتقنها. وكانت الهجرة الأخيرة مميتة فبعد عمر مليء بالأحزان مات سكاليزي يوم 31 مارس 1922 وهو في الثلاثين من عمره، في مشفى عقلي بمدينة باليرمو الايطالية، فريسة للسل والجنون.
طبعت مجموعة سكاليزي مرات عديدة. ظهرت المجموعة أولا سنة 1923 ضمن منشورات بال لاترBelles Lettres ، وسنة 1930 نشرتها الكاهنة، وسنة 1935 نشرتها سندباد. ونشرها سنة 1996 عبد الرزاق بنور في تونس وقدّم لها الإيطالي إيفون فرانكاسيتي بروندين. وقد احتوت هذه الطبعة الرابعة على كل قصائد سكاليزي باستثناء قصيدة واحدة، وهي سونيتة على الأرجح، لم يتم العثور عليها كاملة. وقد ذكر بعض معاصري سكاليزي هذه المقاطع منها:
لقد غذيتني من عقل حكمائك،
من لحمك، من دمك، من شمسك المحرقة،
آه، فرنسا! وحين لم يكن قلبي غير صفحات بيض،
ارتسم اسمك فوقها، ملتمعا بنار قرمزية.
………………………………………
أيها الظهور الأشقر، أعلم من أين يأتي هدوؤك،
من أعياد فصح السلام سيخضرّ جرحك
جرحك هو النبع الذي سيرتوي منه المستقبل.
يظل ماريو سكاليزي رمزا للشاعر الذي لم يختر قدره لكنه اختار أن ينازله حتى النهاية. وهو يعتبر الشعر هبة السماء. لكنه يعتبر الشاعر شخصا منذورا للخيانة الأفظع. فما من شاعر إلا وهو يحمل في ذاته ملمحا من ملامح يهوذا. غير أن الشاعر لا يخون الآخرين بل يغدر بنفسه لأنه ينشغل بالشعر على حساب العيش. يكتب في نص بعنوان ”يهوذا“:
هل تغفرين لي أيتها الورود الرقيقة
أيتها الزنابق، أيتها الزرقة البكر للسماء صيفا
هل تغفرين الجريمة البشعة التي أضمر إتيانها أحيانا
حين الكآبة تستبدّ بي وقشعريرة الرعب تهزّني هزّا
أنا شخصان: المغني صانع الأنغام الذي يعبر
هناك، في تلك الطريق العابقة بالأمجاد والمُثُل
ذاك الشاعر الجوال الذي تحوي عيناه الفضاءات جميعها
ذاك الذي يداه مثقلتان بأزهار فردوس البداية
ذاك أنا. لكن هذا الذي يقضي دهره محكوما بالأشغال الشاقة
هذا البائس التائه بين قطعان البشر
هذا الذي يمضي مطأطئ الرأس جبان القلب باحثا
في مستنقع الحياة عن كسرة خبز
هو أيضا أنا. غدا أو ربما هذا المساء
الناس الذين سأحبهم سيهبونني -ويا لشقوتي-
حتى أهجر الفنّ، أجرة الخائن
وبثلاثين فلسا سأبيع المغني.
مختارات من أشعار سكاليزي
أغنية
أيها الطفل الصغير، ابق نائما في قماطك
لا تفتح عينيك المدهوشتين
عينيك التي ألفت رؤية الملائكة
لا تفتحهما عينيك على عالم الملاعين عالمنا.
يا ابن البشر الأنجاس المناكيد
البشر المسطولين بحبّ الذهب حتى الشقاء
لتهدهدك أحلامك المقدودة من نسغ الورود
أيها الطفل الصغير، استمرّ في النوم.
إنا هنا لنألم حين يسرقون منا
بهجة الربيع القرمزي الوهّاج
أيها الطفل الصغير، فلتكن بسمتك
نداء الشمس فينا.
الديوان ص71
ثــورة
أمي منذ فجري الأول وأنا أكدح
الضنى قدري والضجر يكاد يفنيني
اطرحي من أجلي فستانك القديم
على البلاط.
البلاط لا يهب دفئا أبدا
والشتاء غضوب شرس! إنها تمطر الآن
يرتد النظر كسيرا قدّام الدياجير، هلاّ أوقدت لي
نارا؟
الماء البارد الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه سعار في الحشى يوقظ جوعي
أمّي أما زالت عندك كسرة
خبز؟
لا خبز. لا نار. الحياة دياجير تكرّ
لعناتي عليها أصبّ ولا أملك غير اللعنات
إني لأسمع الأطفال في العتمة
ينوحون.
أختي أصغر أخواتي حين رأت شقوتي،
أختي ذات العينيين العذبتين،
قالت لي: ”هات يدك خذ بسرعة، ما في جيبي غير
فلسين“.
قالت ثانية في نبرة حنون:
”ماذا تريد أن أشتري لك أخي الأكبر
هل أشتري لك خبزا؟ قلت: ”لا… بل
كأسا مترعة“.
الديوان، ص73-74
حفار القبور
رأيته بفأس حادة يحفر الأرض الصمّاء
رأيته حفار القبور الكئيب، الشيخ الأبدي
حطّمت طلعته الشقية مثل قبضة ثقيلة
شعاع الأمل الكريستالي في قاع روحي.
كيف يمكننا أن نعيش غير مبالين، أن نضحك
بينما يداه توسّعان تحت أقدامنا
الحفرة الباردة حيث الموت يستدرجنا
نحن الألى فقدنا الأمل في رحمة ما، في خلاص ما؟
……
كيف يمكننا أن نؤمن بالربيع، بالفجر،
بالأفق اللازوردي، بالشمس، بالأنهار، بالمستقبل؟
كيف يمكننا أن نظل سذّجا غافلين
حتى ننفق أيامنا في الزرع والتشييد؟
في حين يكفي أن نصيخ السمع قليلا صامتين
إلى الإيقاع الرتيب لدقّات قلوبنا
حتى نسمع ضربات فأس حفار القبور
تدوّي في وجيب الدمّ في قلوبنا.
شعر أبيض، ظهر أحدب، لكن قوّته ظلت خارقة
معطفه الأسود يلف الأمس ويلف الغد،
رأيته حفار القبور منتفخ الصدر يكدّ
مفتول العضلات لا يكلّ.
الحفرة التي كان يوسّعها بدت من عمقها هاوية
لا شيء في الدنيا يمكن أن يملأها إلا الكون كلّه.
كلّ الدروب في الدنيا ستنتهي إلى هذه الحفرة،
والناس الطيبون والأوغاد المارقون فيها سينتهون.
أجل ههنا ستسقط البشرية جمعاء، هذا نهر
من وجوه، نهر من أصوات، من أصابع ملتوية، نهر من قلوب،
والليل يهدهد جباهنا في حضن امرأة ثكلى،
والشمس مذبح تنزف على مدارجه دماؤنا،
رأيت الناس يعبرون، مجانين أوعقلاء،
رأيت الأطفال المأخوذين بالأمجاد والمسرّات،
النساء اللاتي تحلّين صدرياتهن بالورود،
النساء اللاتي تسمعن نداء العطر فتهبن من خيراتهن.
……
أموات المستقبل، الألى نفوسهم تتقي بكل طيش
تحذيرات أشجار السرو
أموات المستقبل يكادون لا يلمسون
على الطريق
آثار العبور الأبدي لمن كانوا أحياء في الماضي.
٭ ٭ ٭
الشكر لك يا إلهي، الشكر لك، أيها الإله الرحيم، الإله العادل جدّا،
يا من تقبض الأنفس جميعها.
شكرا لك فقد عجنت بيدك الطاهرة
زهرة أعوامي العشرين.
بفضلك وحدك سأستطيع أن أنزلق داخل الحفرة المعتمة
دون حسرة على نور النهار.
سأُزَفّ إلى الليل، وسأحيي ظلّ
قُبلتي الأولى.
لكن اسمح أن تجعل قلبي دمعة حمراء
اسمح أن أرفع الصوت عتابا
حين أسمع النشيد المخادع الذي يغذي
أمل المحكومين بالإعدام.
ملحمة الفقير
في سالف الأيام عندما كانت الأشعة الحمراء المنبعثة من المشاعل العملاقة
تنعكس مثل القبل على بلور الشبابيك الكريستالي ذي اللون النهدي،
كان البارونات المترفون يلتهمون في صالوناتهم
لحم الخنازير البرية التي اصطادوها في حقولي المزروعة قمحا.
كان أطفالي يجيبون بأنّات الجياع
على الترانيم المنبعثة من الشفاه المخمورة
على ضحكات المهرّجين … على اعترافات النساء العاشقات العطرة.
كان أطفالي يجيبونهم بأنّات الجياع مثل كلاب ضائعة تعوي عواء مريرا في الغابات.
حين كنت ضجرا من التضرّع للأفق اللازوردي، متهالكا على الأرض،
حين كنت أتوسّل الأرض كي تنشق وتبتلعني
خاطبني امرؤ قدم للتو من المعبد: ”أيْ بنيّ
تعلّم على الأقلّ أن تطلب المغفرة لذنوبك دون ضجّة أو أنين“.
أطلب المغفرة، أطلب المغفرة، أيّ جرم اقترفت يداي
هل تعكّر أنفاسي البائسة صفو السماء؟
أما صلّيت للسماء وسدّدت الدين كاملا؟
أما تعرّيت حملا وديعا كي أزيد سدنة المعبد ثراء على ثراء؟
مرّة أحدّث نفسي هكذا: ”إلهي، سيّد الدنيا والعالمين
سيّد لآلئ السماوات وكنوز البحار
ما الذي يجنيه من كل هذا الذهب الذي رصّعت به المعابد
لماذا يحرم أبناءه البررة، لماذا يحرم قرّة عينه؟
وأحيانا أحدّث نفسي قائلا: ”أَعدلٌ ما يجري،
أعدل أن يرتدي المرء أسمالا رثّة وينعم غيره في الدمقس وفي الحرير؟
أليس من أجل البشر أجمعين تمنح الطبيعة
حبّا، وسنابل وصباحات مشرقة؟
ذات مساء كانت ذئاب ضخمة هزيلة تدور من حولي
وريح حاصب صرصر تدوي كأنها تذكّرني
بأن خدم البارونات بضحكاتهم الصفراء
قد فرغوا للتو من اختطاف ابنتي والعبث بشرفها.
ذاك المساء حين كنت أتهاوى ساقطا تحت نير رزيتي وشقائي
ذاك المساء حين عيناي استعادتا واحدا واحدا
أيّامي الخوالي، أيامي التي تشبه حبّات مسبحة سوداء
ذاك المساء بعطرها الوحشي الضغينة تعتعتني.
الثورة المتوقّدة في روحي المتحفّزة
علّمتني أن السعادة وقف على الأقوياء
ومن الغروب الغارق في بحر دماء وصهاريج ذهب
أُلهمتُ الجريمة والحرائق.
في تلك الساعة تحت الأشعة المسائية الحمراء:
جمّعت أولادي، آلافا آلافا،
أفواجا أفوجا يمّمنا، مثل جدار مرصوص، صوب برج الإقطاعي
خَبباً سرنا عبر المروج الكليلة ذات الأخاديد الأليفة.
منّينا النفس بأن نرد النبع الأحلى: الحرية
نبع يشبه خمرة جديدة قرمزية
منينا النفس بإبطال بالعصيان الأبدي، إبطال الضرائب كلها، كسر سلاسل العبيد
منينا النفس بأن نرفع عاليا حقّنا في نور الشمس.
لكن الفرسان ذوي الطلعات البهيّة والمتاريس المنيعة
واجهوا عصيّنا بأسلحة فتّاكة
وأثخنوا بجراح لا تشفى
صدورنا العارية المدماة والمكدودة بالنحيب.
هكذا فزنا بالجمال الذي يكسو الضحيّة،
وهكذا عمّقت النصال الأخاديد فوق جباهنا
في حين كانت جثث الكادحين العظماء المسجّاة
تملأ بالبهجة قلوب رهط البارونات.
ها أن جاك بونوم يصرخ: ”سيدفع ثمن ما اقترفت يداه! “
هكذا صوّت إعصار الفولاذ ذاك.
طويلا رافقني جزعي من تلك الصرخات…
وحين انهزمنا رجعنا إلى الجحيم.
وبظهر محنيّ عدت إلى الزراعة
هناك، حيث سكّة المحراث تنبش قبور الشهداء المعدمين.
دموع المسيح، دموع عامّة الناس،
كانت تتلألأ في عيوني المثقلة بالذكريات.
وعشت سنينا طوالا، مئات السنين الطوال،
سليبا، خاضعا،
وكلّ يوم يمرّ يعمّق أغلالي
ويمرّر فوق جسدي خيول عربات الملوك.
رغم أن الكل يعرف أنه لو أغار معتد على سهول بلادي
لنادتني البنادق والمدافع مدوّية فوق القلاع
لأن الكلّ يعلم أن الدم المتدفّق في عروقي
دم غير فاسد، دم أحمر، دم الأقوياء.
الجشع، الكِـبْـر، البذخ، التّهتّك،
جاذبيّة السماوات الغريبة والمدائن الغريبة
يا وطني، يا وطني اللاجئ في قلبي
لم تبدّل أبدا فخارَك العنيد.
وحدهم، أيتها الأم العتيقة، أيتها الأم القديسة، وحدهم يقدرون على حبّك
أولئك الذين لبساطتهم وعوزهم،
لا يملكون من عزاء على مرارة أيامهم
سوى أحلامك الخريفية وضحكاتك الصيفية.
رجال، أزواج، عرقهم المهيب يُخصب أحشاءك وحناياك
رجال، أزواج، يصيخون السمع إليك، تقولين حين تخلدين إلى السكينة:
”إني لمشدودة إليكم شدّا بحقّ الخبز الذي بذرتم حبّاته
وأنتم مشدودون إليّ شدّا بحقّ السرير المهيب، القبر هو السرير“.
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
ومثل مركب صريرُ ألواحه يزعزع هيكلُه
تحت ضربات الأمواه الهائجة ورياح الشتاءات
تُسمَع صرخات الطبيعة الصبور
حين قبضتي المعروقة تعيد تشكيل العالم.
كانت تلك بهجة عظيمة تلت صوما طويلا
كنت قد صرت بدوري ملكا، العين صارخة، والكلمة عالية
اخترت الأرجوان الأعظم عرشا
أرجوان الدم ذاته، الدم الذي يكسو المقصلة.
كنت قد صرت النسر النشوان بالفضاءات المشرقة
كانت جناحاي تحملانني أعلى علّيين
كنت أتشرّب الأثير من تحليقي النهم
حين أردتني رصاصة صياد غادر.
وقتها، أفقت من حلمي البهيّ.
كان دمي قد سُفك من أجل مصالح الآخرين.
كان آخرون غيري قد ثمّنوا ذهب قوّتي، قوّتي الخلّب العابرة
حين كبّلوني بأصفاد دبّرت في الليالي الداجية.
بعد شمس أشرقت طويلا يصير الظلّ أكثر عتمة وسوادا.
النهار! النهار ثانية! سيدي ومولاي الجديد
لا يملك، كي يبهرني، سراب أمجاد
ولا يملك، ليُحني جبيني، قفّاز زرد فولاذي.
سيدي هو ذاك الذي يسنده عجل من ذهب.
وسواء كنت كادحا أو تاجرا، حدّادا أو عاملا في منجم،
سأظلّ على الدوام القنّ الحزين، القنّ المشؤوم
ذاك الذي يأكل الخبز الأسود مغموسا في العرق.
وفي حين كنت أرزح تحت وقع فاقتي
كانت ثريّات الكريستال المطعّم بالذهب والمسرّات
تضيء تحت عيني الولائم والرقصات:
الكراهية من يومها صارت لذّتي الوحيدة.
متى يأتي يوم يلتمع فيه نجمي، ومتى يغيب
عن ناظري مشهد أفقي وهو يسود بالكواسر،
مشهد أولادي يموتون جوعا، في الأوحال أو الثلوج
ومشهد بناتي يسقن إلى زوايا الطرقات حيث يتم بيعهن؟
أيها المموّلون الشرهون، وأنت، أيّتها الحوريّات الباردات
اللواتي تضفين نقاء جبينكن الساطع على المنكرات جميعها،
لأكسرنّ أسنانكم بكؤوسكم الملأى،
ولأرمينّ الصواعق إلى قلب سمائكم!
لأنني، أيها الشعب، أحفظ
في ذاتي المتعذّر سبر غورها
الذكرى الملتهبة للكلمات التي قدّت من نار،
أنا الإيمان، أنا القوّة، والعدد، والفكرة،
أنا، بفضل عملي الدؤوب، شبه إله!
داخل هذا العرين السري الذي نما فيه غضبي،
أمزج في قلبي الشعلة والفولاذ،
وأدرك أنني أنا الذي ظللت مقموعا لأحقاب،
سأصبح، أيها الحكّام، المنصف الأخير.
سأحكمكم بالفأس والهراوة،
وسأحكمكم بالرعب والقرف الباعث على الغثيان،
سآتيكم، بكلّ الوسخ الذي حمّلنيه عملي العتيق،
سأجلس إلى مائدتكم
مثقلا بكوارثي ومصائبي.
سأخرج من أحشاء الحقول والمدن
أفواج كلّ المجوّعين الذين أكلوا ملوكا.
حتى أُعلي كلمة الكتاب المقدّس الجديد،
أيّها المجتمع المعتم، ها أننا ننصب لك صليبا، ونعلقك عليه.
ماريو سكاليزي شاعر اختار لنفسه اسم الشاعر الملعون عن روية وفكر واختيار. فلقد كان على يقين من أن القدر قد رشحه للقيام بأمرين لا يقل أحدهما عن الآخر عنفا: مواجهة رعب الوجود وكتابة الشعر. كانت إقامته على الأرض ملحمة صراع ضد الفاقة والمرض والظلم الاجتماعي. وكان شعره مواجهة عنيدة لقدر لم يختره لكنه اختار أن ينازله. كان ماريو سكاليزي على يقين من أن لا معنى للكائن ولا معنى لحياته أصلا إن هو لم يثأر للكرامة البشرية المنتهكة في الأرض قاطبة. كان على يقين أيضا من أن الشعر واللعب بالكلمات هو آخر ما يتبقى بين يدي الانسان حين تعصف به المحن والرزايا.
ولد ماريو سكاليزي يوم 6 شباط (فبراير) سنة 1892 في تونس، ومنذ نعومة أظفاره تلقّفته الرزايا أشكالا وألوانا. فلقد أصيب بداء التواء العمود الفقري قبل أن يتجاوز سن الخامسة. وقضى ما تبقّى من عمره يعاني من تشوّه شكله ووهن جسده. ولطالما احتمى بالشعر وبالكلمات ليتطهّر من إحساسه العاتي بأن الأقدار قد ابتلته ظلما، إذ حكمت عليه بأن يجرجر جسده الأحدب الملتوي كالصليب حتى القبر.
لذلك كثيرا ما تحوّلت الكتابة لديه إلى نشيد أسود يرفع احتجاجا على البلية. فلئن تحدّثت كتب التاريخ والقصص التي دوّنت أخبار القديسين والمصطفين والمصلحين عما تعرّضوا له في حيواتهم من تنكيل وصلب وتقتيل، فإنها لم تحدّث عن شخص شُوّه جسده حتى اتخذ شكل صليب ملتو. لم تحدّث عن شخص أرغمت روحه على أن تقطن جسدا صار من شدّة تشوّهه مثل الصليب تماما. عديدة هي المرّات التي عبّر فيها سكاليزي عن ضجره بقدره ومقته لجسده فجاءت أشعاره طافحة بالنوح والنحيب. يكتب مثلا:
كان ظلّه، كان ظلّ جسده يمتدّ قدّامه مثل صليب مخز
هي ذي، هي ذي الروح تنتفض ضدّ جسدها
روح تواجه اللعنة الأبدية بالنحيب.
عن نية وقصد سيختار ماريو سكاليزي لقب الشاعر الرجيم حينا، ولقب الشاعر الملعون حينا آخر. وسيعدّ أشعاره أناشيد طالعة من غياهب الجحيم ويضع لديوانه عنوانا دالاّ على وعيه الدرامي بأن اللعنة التي حلّت به ليست سوى الفصل الأبشع في مأساة بني البشر أجمعين. ”قصائد شاعر ملعون- أشعار من غياهب الجحيم“. هكذا نعت نفسه ونعت ديوانه. وسيواجه عدمه الخاص باعتباره عتبة مفتوحة على العدم المتربّص بالوجود ذاته منذ الأزل. والراجح أن هذا الوعي المأساوي الفاجع لم يتولّد عما آل إليه أمر جسده من تشوّهات وما آلت إليه حاله من عذابات فحسب، بل كان مردّه شظف العيش وقلّة الرزق ورقّة الحال. أب بالكاد يكسب قوت عياله. أمّ قابعة في البيت ترعى طفلا متوقّد الذكاء لكنه مقعد محدودب الظهر. فتلوذ بالدمع حينا، وحينا ترفع يديها إلى السماء وهي على يقين من أن باب الشفاء قد أقفل في وجه ابنها إلى الأبد.
كان والد ماريو سكاليزي يشتغل بالسكك الحديدية التي كان أغلب عمالها من الإيطاليين. وهو يتحدّث عنه لا باعتباره إيطاليا بل باعتباره تونسيا قدم من جزيرة صقلية. لكنه يومئ إيماء إلى أن ما حلّ به من عذاب ليس سوى جزء من العقاب الذي أنزلته السماء على والده الذي وصل إلى تونس فارّا من العدالة الإيطالية على إثر جريمة ارتكبها بجزيرة صقلية. لذلك كثيرا ما حرص على أن يرسم لوالده صورة الكادح الذي انتدبته الحياة للبؤس. لكنه يظلّ رغم شظف العيش وشحّ المال وانعدام الأمل رمزا لما تنبني عليه المنزلة البشرية ذاتها من عناد وقدرة على منح الحياة فرصة الاستمرار. يكتب في قصيدة بعنوان ”عقاب“:
رأيت من خلال المطر المدرار الهائل، رأيته في العتمة
أبي العجوز محدّبا داخل معطفه الداكن.
ها هنا كان يمارس عمله كمحوّل سير.
لم يكن لديه أمل في غد أفضل.
لم يكن له مأوى. كان الماء المتلألئ الجبان
يسيل فوق رقبته، ويبلل شواربه.
ويرسم سكاليزي لأمه صورة تكشف حياة خاضعة مستكينة طافحة بالمرارات لكنها لا تخلو من الرقة والحنان. يكتب في قصيدة بعنوان ”أمّي“:
هل اهترأ قلبك، يا أمّي
لا أجرؤ أمام عينيك الباردتين،
أن أتضرع إليك راجيا
أن تقبّليني كما كنت تفعلين.
…………………….
ما تبقّى لي من شباب
اختطفه مني أساك.
وكثيرا ما تعود صورة الأمّ في قصائد سكاليزي مقترنة بفكرة البؤس والفاقة والعذاب. يكتب في قصيدة تحمل عنوان ”تمرّد“:
الماء الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه يؤجّج جوعي.
أمي أما عادت لديك
قطعة واحدة من خبز؟
وراء هذا الحزن تتراءى أحيانا نادرة بعض لحظات الفرح المرتبط بالحياة الجماعية للعائلات الإيطالية في شتاءات تونس. يكتب في قصيدة بعنوان ”حادث“ محدّثا عن احتفالات عيد الميلاد:
كان عيد الميلاد. شتاء أفريقيا،
هذا الشتاء ذو النيسانات المتشابهة،
كان يزهر في الهواء البلسمي
تحت توهّجات الشمس.
……………….
كنت أذهب هناك بحثا عن أوراق اللعب.
قانون عرفي قديم
استدعى أن نلعب بالكعكة
والفول المطهو والجوز.
تتحدّر أمّ ماريو سكاليزي من أسرة مالطية من أصل إيطالي. أما أبوه فهو إيطالي خالص. وقد وصلا تونس خلسة هربا من العدالة الإيطالية. وكان العديد من الإيطاليين قد توطّنوا البلاد التونسية حين سدّت في وجوههم أبواب الرزق بإيطاليا. كان أغلبهم من مدن الجنوب ولاسيما جزيرة صقلية المتاخمة للسواحل التونسية. والثابت تاريخيا أن السلطات الإيطالية وقتها كانت تغض الطرف عن هذه الهجرات السرية وتشجّعها أحيانا كثيرة ليقينها أن الفرنسيين قد أقروا العزم على احتلال المغرب العربي بأسره وتكاثر عدد الإيطاليين في تونس سيمنحها فرصة احتلالها بدعوى حماية الجالية الإيطالية.
لم يكن والد سكاليزي ينتمي إلى رجال الأعمال القائمين على عالم التجارة أو الصناعة أو المهن الحرّة وهم فئة قد سيطرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتونس منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ وما كان جزءا من حركة الهجرة السياسية التي سبقت توحيد إيطاليا، وقد تكونت في معظمها من مثقفين وجنود وتقنيين ينتمون إلى البرجوازية الإيطالية ويحاولون الهرب من هيمنة الدولة وتسلّطها. بل كان مقدمه إلى تونس في نطاق هجرة البروليتاريا المدقعة من جنوب إيطاليا باتجاه أفريقيا بحثا عن العمل في موطن بديل. كان هؤلاء الوافدون الطليان قادمين من المناطق الأكثر فقرا ولاسيما جزيرتي صقلية وسردينيا. ومثلما يفعل المهاجرون عادة تجمّع الإيطاليون داخل أحياء مغلقة تقريبا كثيرا ما أطلقوا عليها اسم صقلية الصغرى. وقد تغلغلت هذه الفئة من المهاجرين بين التونسيين تقاسمهم ظروف الحياة البائسة ذاتها، والمعاناة نفسها.
أمضى سكاليزي طفولته في قلب الجالية الإيطالية. وهي جالية متكونة من مجموعة من المعدمين الذين رست بهم سفن إيطالية في موانئ تونس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولشدّة فقرهم وفاقتهم دعاهم المؤرخ الإيطالي نولو بازوتي Nullo Pasotti الجنس العاري le nude braccia (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
ولما كان سكاليزي متحدّرا من هذا الجنس العاري فقد اضطر أن يكسب رزقه منذ سن مبكرة جدّا. فاشتغل محاسبا في العديد من المتاجر بتونس. ولم يكن وضعه ليعرف الاستقرار أبدا، حتى أنه لم يكن دائما يجد ما به يسد رمقه.
لم يلتحق بالمدرسة إلا لماما. فلم يدم بقاؤه في المدرسة الفرنسية إلا قليلا. واضطرّ إلى أن يقوم بمفرده بجهود متواصلة للتحصيل الثقافي وتوسيع آفاق معارفه. كانت القراءات الغزيرة والمتنوعة سبيله إلى ذلك، إلى أن اشتعلت فيه شعلة الشعر. وفيما كان يتمرّس بالشعر والقصائد تنقاد إليه وتنثال عليه انثيالا كان سخطه يزداد كلما ارتطم بالواقع المرير وكلما تلفّت إلى بؤسه الخاص وبؤس الناس من حوله.
لذلك ظل الموضوع القار في كتابات ماريو سكاليزي التعبير عن الأسى والجهد والبؤس وانعدام العدالة والاستنهاض للثورة والتمرّد. عديدة هي القصائد التي تختفي منها نبرة التأسّي والنوح على الذات فتصبح الكتابة عبارة عن تمجيد للحياة وإعلاء للحياة واحتفاء بالشعب باعتباره حامل جذوة القوة المقدسة التي ستهدم عالم الطغاة والمستبدّين وتثأر للكرامة البشرية المنتهكة. هذا التوجّه الثوري هو الذي جعل ماريو سكاليزي يتعامل مع مأساته الذاتية باعتبارها جزءا من مأساة المقهورين والمضطهدين. وهو الذي جعله يتخلى عن الطابع الغنائي ويشرع في كتابة الملحمة حيث يقوم بتجسيد الصراع الذي يخوضه العمال والفقراء والمقهورون بحثا عن فسحة من نور في ليل وجودهم العاثر. اختار لنصّه عنوان ”ملحمة الفقير“ وتناول فيها بؤس بني البشر في العهد الإقطاعي وبؤسهم آن استولت البورجوازية على مقاليد الأمور وتناول بؤس زنوج أمريكا واعتبر تمثال الحرية مجرّد فكاهة. ذلك أن عذاب الزنوج يكشف أن حلم البشرية بعالم أقل ويلا قد تبخّر حتى في العالم الجديد الذي قصده الناس هربا من الفاقة والظلم الاجتماعي. لذلك يصوّر أمريكا على أنها حاملة مشعل الحرية ثم يهزّئ هذا التصوّر ويحتفي بالسود ونضالاتهم فيكتب محتفيا بالصراع الذي يخوضه الزنوج:
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
وتعد ”ملحمة الفقير“ أبرز قصيدة طويلة متكونة من 36 مقطوعة أنشدها سكاليزي للعمّال والمضطهدين الذين كانوا يكوّنون وسطه التونسي-الإيطالي. كانت الملحمة فاتحة. كانت طريقا مؤدّية إلى كتابة أشعار تستنهض الهمم لرفض فكرة الظلم الاجتماعي نفسها. كتب مثلا:
في حين ينتشي الثراء بعماء،
أحييك، يا نهر العرق المهيب،
باسم الأمل والمنتقمين القادمين،
باسم الراضخين الذين يضنيهم العمل العبثيّ.
وحالما شرع سكاليزي في كتابة هذه الملاحم ذاعت شهرته في أوروبا ذاتها إذ قامت جريدة إيطالي من تونس LItaliano di Tunisi وهي إحدى الجرائد الأوروبية القليلة بتقديمه إلى القراء الأوروبيين على أنه ”شاعر بروليتاريا تونس“. ثم تلقفت الجرائد والدوريات الفرنسية أشعاره. (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
حين نبحث في أرشيف المكتبة الوطنية بتونس عن العلامات التي وسمت الحياة الثقافية والاجتماعية في تونس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يبرز اسم سكاليزي باعتباره شخصيّة متفردة متعددة الأبعاد والانتماءات الثقافية. فهو شاعر تونسي من أصل إيطالي يكتب باللغة الفرنسية ويطرق من الموضوعات ما يجعله شاعرا ناطقا بلسان حال التونسيين والإيطاليين المضطهدين ويحوّل أشعاره إلى مدائح ترفع تمجيدا للحياة وفضحا للمستعمرين والطغاة. يعمد مثلا في نص بعنوان ”سونيتا الاستعمار“ إلى التنديد بفرنسا وجبروتها فيتوجّه بالكلام إلى والد شهيد:
الوطن شبيه بعرائس البحر العتيقة
التي كانت أصواتها تضيع البحّارة.
الوطن يجحد الأغنيات: لكن نحيبه الإلهي
يلهم النفس رغبة النخل السيّد
نواقيس الخطر تقرع في فجرنا الهادئ الصافي
الحرائق تبهر البراري والبحار
فيما فرنسا في ثوب الحداد تلثم العيون المغمضة،
عيون شباب في ربيع العمر هلكوا في حلبات النزال الحمراء
أيها الأب الذي بقي وحيدا في عزّ المساء
نيسان ابنك، حمرة دمه
زهر سيورق على رايات الملحمة
ابنك اختار على شعاع السماء ونورها
الرقة الوحشية لرقدة الأبطال،
الرقدة الرميم في أرض حيث الأجداد ناموا.
إن تنوّع المصادر التي عرّفت بسكاليزي وتناولت أشعاره ومقالاته بالنقد يؤكّد في حدّ ذاته هذا الانتماء الحضاري المتعدّد. لقد كتب سكاليزي بالفرنسية لغة المستعمر. وكان من الطبيعي أن يعدّه النقد الفرنسي أحد الوجوه البارزة في الحركة الفكرية الفرنسية بتونس. وهذا ما ذهب إليه إيف شاتلان Yves Châtelain مثلا في كتابه الحياة الأدبية والفكرية بتونس بين 1900 و1937 (Vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937). ولكنه يذكره أيضا ضمن الصفحات المخصصة للحركة الفكرية الإيطالية، رغم أنه يفعل ذلك بهدف التركيز على هجرة الأقلام الإيطالية نحو التعبير باللغة الفرنسية كنتيجة للهيمنة الحضارية واللغوية للمستعمر الفرنسي.
ولأن سكاليزي من أصل إيطالي عمد غاسبار داغوانو Gaspare DAguanno إلى اعتباره شاعرا إيطاليا خالصا فكتب عنه دراسة مطولة بالفرنسية ونشرها بمدينة تراباني في صقلية مسقط رأس أب سكاليزي، فصارت مدينة تراباني تفاخر بسكاليزي وتحتفي به باعتباره أحد مواطنيها الذين أصبحوا مشهورين. وفي الوقت ذاته سيواصل المغرب العربي في دوريّاته تمسّكه بسكاليزي باعتباره ابن البيئة التونسية والناطق بآمال شعوب المغرب في التحرر والكرامة.
لذلك ستعتبر جمعية أدباء شمال أفريقيا أعمال سكاليزي جزءا من الموروث الثقافي التونسي، وتعدّه أمارة على وجود أدب قائم بذاته بالمغرب العربي، وشاهدا على ثراء الحياة الأدبية بتونس وتفردها في تلك المرحلة من تاريخها، لأن سكاليزي شاعر يجسد هذا التفرّد باعتبار أن أشعاره تكشف بعنف أبعاد هذه الهويّة المتعدّدة.
أما ماريو سكاليزي فإنه صنّف نفسه واختار عائلته حين وضع لديوانه عنوان ”قصائد شاعر ملعون“. وهو عنوان يشير صراحة إلى أنه يعتبر نفسه ملعونا لا بسبب الوشائج الروحية التي تربطه بالمدرسة الفرنسية للشعراء الملاعين، بل أيضا بسبب ارتباطه بالبؤس الذي وسم حياة المهاجرين الإيطاليين بتونس، وخاصة منهم القادمين من صقلية، وبسبب إقامته في بلاد تآمر الطغاة والغزاة على ناسها وغدها. ولهذا أيضا جاء العنوان الفرعي ”أشعار من غياهب الجحيم“ بمثابة إلحاح على أن الشاعر الحق إنما هو ذاك الذي يقاسم المغلوبين والمقهورين جحيمهم ولا يفرّ من المنازلة حتى إذا كان بإمكانه تحقيق خلاصه الفردي. لذلك سيلتصق سكاليزي بالمكان ولن يحدّث عن أمجاد العرب والمسلمين كما يحدّث الرومانسيون الغربيون الذين تعاملوا مع الشرق باعتباره موطن الخرافة والسحر وتدويخ الحواس وبلسم الإنسان الأوروبي الذي ضجر بعقلانية عصر الأنوار، بل سيتغنى بالمكان وبالمعمار الشرقي ويعتبر العرب حمالة حقيقة وبناة حضارة. يكتب في نص بعنوان ”الصومعات“:
أيتها الصومعات، بهاء أنت فوق الدكاكين
صرخة من حجر دافقة من قلب الشرق العظيم
أيتها الأبراج البيضاء
أنت مثل حراس من المتصوّفة ترقبين
رعشة الأمل في قلب السماء الضحوك
منارات أنت نورها قُـدَّ من صلوات
منارات تشعّ التقوى فيها مثل بيت طهور
من بعيد ترسمين في وجه القادمين من السماء
محيط اللازورد
الدرب السالكة للأرض
كم أهوى أن أراك منتصبة قبالة المغيب وهو يحترق
مثل حرّاس مدينة من ذهب
كم أهوى أن أراك في الأفق الرائع وقت المغيب
حين نحلم بحدائق يزهر فيها الموت والعدم.
نداء المؤذنين الذي يبلغ حتى مسامع الراقدين في القبور
يبدو كأنه سؤال تطرحينه على الأثير الأزرق
وحين الحمائم تأتي وتحطّ على أكتافك
توشوشك إجابة الله.
هجرات تتلوها هجرات. هكذا كانت حياة سكاليزي. فمنذ اللحظة التي هاجر فيها والداه من إيطاليا تلقفت الهجرة حياة ماريو سكاليزي وصارت قدرا ومصيرا. هاجر من الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية الإسلامية وعشقها. هاجر من لغته الإيطالية فكتب بالفرنسية وأتقنها. وكانت الهجرة الأخيرة مميتة فبعد عمر مليء بالأحزان مات سكاليزي يوم 31 مارس 1922 وهو في الثلاثين من عمره، في مشفى عقلي بمدينة باليرمو الايطالية، فريسة للسل والجنون.
طبعت مجموعة سكاليزي مرات عديدة. ظهرت المجموعة أولا سنة 1923 ضمن منشورات بال لاترBelles Lettres ، وسنة 1930 نشرتها الكاهنة، وسنة 1935 نشرتها سندباد. ونشرها سنة 1996 عبد الرزاق بنور في تونس وقدّم لها الإيطالي إيفون فرانكاسيتي بروندين. وقد احتوت هذه الطبعة الرابعة على كل قصائد سكاليزي باستثناء قصيدة واحدة، وهي سونيتة على الأرجح، لم يتم العثور عليها كاملة. وقد ذكر بعض معاصري سكاليزي هذه المقاطع منها:
لقد غذيتني من عقل حكمائك،
من لحمك، من دمك، من شمسك المحرقة،
آه، فرنسا! وحين لم يكن قلبي غير صفحات بيض،
ارتسم اسمك فوقها، ملتمعا بنار قرمزية.
………………………………………
أيها الظهور الأشقر، أعلم من أين يأتي هدوؤك،
من أعياد فصح السلام سيخضرّ جرحك
جرحك هو النبع الذي سيرتوي منه المستقبل.
يظل ماريو سكاليزي رمزا للشاعر الذي لم يختر قدره لكنه اختار أن ينازله حتى النهاية. وهو يعتبر الشعر هبة السماء. لكنه يعتبر الشاعر شخصا منذورا للخيانة الأفظع. فما من شاعر إلا وهو يحمل في ذاته ملمحا من ملامح يهوذا. غير أن الشاعر لا يخون الآخرين بل يغدر بنفسه لأنه ينشغل بالشعر على حساب العيش. يكتب في نص بعنوان ”يهوذا“:
هل تغفرين لي أيتها الورود الرقيقة
أيتها الزنابق، أيتها الزرقة البكر للسماء صيفا
هل تغفرين الجريمة البشعة التي أضمر إتيانها أحيانا
حين الكآبة تستبدّ بي وقشعريرة الرعب تهزّني هزّا
أنا شخصان: المغني صانع الأنغام الذي يعبر
هناك، في تلك الطريق العابقة بالأمجاد والمُثُل
ذاك الشاعر الجوال الذي تحوي عيناه الفضاءات جميعها
ذاك الذي يداه مثقلتان بأزهار فردوس البداية
ذاك أنا. لكن هذا الذي يقضي دهره محكوما بالأشغال الشاقة
هذا البائس التائه بين قطعان البشر
هذا الذي يمضي مطأطئ الرأس جبان القلب باحثا
في مستنقع الحياة عن كسرة خبز
هو أيضا أنا. غدا أو ربما هذا المساء
الناس الذين سأحبهم سيهبونني -ويا لشقوتي-
حتى أهجر الفنّ، أجرة الخائن
وبثلاثين فلسا سأبيع المغني.
مختارات من أشعار سكاليزي
أغنية
أيها الطفل الصغير، ابق نائما في قماطك
لا تفتح عينيك المدهوشتين
عينيك التي ألفت رؤية الملائكة
لا تفتحهما عينيك على عالم الملاعين عالمنا.
يا ابن البشر الأنجاس المناكيد
البشر المسطولين بحبّ الذهب حتى الشقاء
لتهدهدك أحلامك المقدودة من نسغ الورود
أيها الطفل الصغير، استمرّ في النوم.
إنا هنا لنألم حين يسرقون منا
بهجة الربيع القرمزي الوهّاج
أيها الطفل الصغير، فلتكن بسمتك
نداء الشمس فينا.
الديوان ص71
ثــورة
أمي منذ فجري الأول وأنا أكدح
الضنى قدري والضجر يكاد يفنيني
اطرحي من أجلي فستانك القديم
على البلاط.
البلاط لا يهب دفئا أبدا
والشتاء غضوب شرس! إنها تمطر الآن
يرتد النظر كسيرا قدّام الدياجير، هلاّ أوقدت لي
نارا؟
الماء البارد الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه سعار في الحشى يوقظ جوعي
أمّي أما زالت عندك كسرة
خبز؟
لا خبز. لا نار. الحياة دياجير تكرّ
لعناتي عليها أصبّ ولا أملك غير اللعنات
إني لأسمع الأطفال في العتمة
ينوحون.
أختي أصغر أخواتي حين رأت شقوتي،
أختي ذات العينيين العذبتين،
قالت لي: ”هات يدك خذ بسرعة، ما في جيبي غير
فلسين“.
قالت ثانية في نبرة حنون:
”ماذا تريد أن أشتري لك أخي الأكبر
هل أشتري لك خبزا؟ قلت: ”لا… بل
كأسا مترعة“.
الديوان، ص73-74
حفار القبور
رأيته بفأس حادة يحفر الأرض الصمّاء
رأيته حفار القبور الكئيب، الشيخ الأبدي
حطّمت طلعته الشقية مثل قبضة ثقيلة
شعاع الأمل الكريستالي في قاع روحي.
كيف يمكننا أن نعيش غير مبالين، أن نضحك
بينما يداه توسّعان تحت أقدامنا
الحفرة الباردة حيث الموت يستدرجنا
نحن الألى فقدنا الأمل في رحمة ما، في خلاص ما؟
……
كيف يمكننا أن نؤمن بالربيع، بالفجر،
بالأفق اللازوردي، بالشمس، بالأنهار، بالمستقبل؟
كيف يمكننا أن نظل سذّجا غافلين
حتى ننفق أيامنا في الزرع والتشييد؟
في حين يكفي أن نصيخ السمع قليلا صامتين
إلى الإيقاع الرتيب لدقّات قلوبنا
حتى نسمع ضربات فأس حفار القبور
تدوّي في وجيب الدمّ في قلوبنا.
شعر أبيض، ظهر أحدب، لكن قوّته ظلت خارقة
معطفه الأسود يلف الأمس ويلف الغد،
رأيته حفار القبور منتفخ الصدر يكدّ
مفتول العضلات لا يكلّ.
الحفرة التي كان يوسّعها بدت من عمقها هاوية
لا شيء في الدنيا يمكن أن يملأها إلا الكون كلّه.
كلّ الدروب في الدنيا ستنتهي إلى هذه الحفرة،
والناس الطيبون والأوغاد المارقون فيها سينتهون.
أجل ههنا ستسقط البشرية جمعاء، هذا نهر
من وجوه، نهر من أصوات، من أصابع ملتوية، نهر من قلوب،
والليل يهدهد جباهنا في حضن امرأة ثكلى،
والشمس مذبح تنزف على مدارجه دماؤنا،
رأيت الناس يعبرون، مجانين أوعقلاء،
رأيت الأطفال المأخوذين بالأمجاد والمسرّات،
النساء اللاتي تحلّين صدرياتهن بالورود،
النساء اللاتي تسمعن نداء العطر فتهبن من خيراتهن.
……
أموات المستقبل، الألى نفوسهم تتقي بكل طيش
تحذيرات أشجار السرو
أموات المستقبل يكادون لا يلمسون
على الطريق
آثار العبور الأبدي لمن كانوا أحياء في الماضي.
٭ ٭ ٭
الشكر لك يا إلهي، الشكر لك، أيها الإله الرحيم، الإله العادل جدّا،
يا من تقبض الأنفس جميعها.
شكرا لك فقد عجنت بيدك الطاهرة
زهرة أعوامي العشرين.
بفضلك وحدك سأستطيع أن أنزلق داخل الحفرة المعتمة
دون حسرة على نور النهار.
سأُزَفّ إلى الليل، وسأحيي ظلّ
قُبلتي الأولى.
لكن اسمح أن تجعل قلبي دمعة حمراء
اسمح أن أرفع الصوت عتابا
حين أسمع النشيد المخادع الذي يغذي
أمل المحكومين بالإعدام.
ملحمة الفقير
في سالف الأيام عندما كانت الأشعة الحمراء المنبعثة من المشاعل العملاقة
تنعكس مثل القبل على بلور الشبابيك الكريستالي ذي اللون النهدي،
كان البارونات المترفون يلتهمون في صالوناتهم
لحم الخنازير البرية التي اصطادوها في حقولي المزروعة قمحا.
كان أطفالي يجيبون بأنّات الجياع
على الترانيم المنبعثة من الشفاه المخمورة
على ضحكات المهرّجين … على اعترافات النساء العاشقات العطرة.
كان أطفالي يجيبونهم بأنّات الجياع مثل كلاب ضائعة تعوي عواء مريرا في الغابات.
حين كنت ضجرا من التضرّع للأفق اللازوردي، متهالكا على الأرض،
حين كنت أتوسّل الأرض كي تنشق وتبتلعني
خاطبني امرؤ قدم للتو من المعبد: ”أيْ بنيّ
تعلّم على الأقلّ أن تطلب المغفرة لذنوبك دون ضجّة أو أنين“.
أطلب المغفرة، أطلب المغفرة، أيّ جرم اقترفت يداي
هل تعكّر أنفاسي البائسة صفو السماء؟
أما صلّيت للسماء وسدّدت الدين كاملا؟
أما تعرّيت حملا وديعا كي أزيد سدنة المعبد ثراء على ثراء؟
مرّة أحدّث نفسي هكذا: ”إلهي، سيّد الدنيا والعالمين
سيّد لآلئ السماوات وكنوز البحار
ما الذي يجنيه من كل هذا الذهب الذي رصّعت به المعابد
لماذا يحرم أبناءه البررة، لماذا يحرم قرّة عينه؟
وأحيانا أحدّث نفسي قائلا: ”أَعدلٌ ما يجري،
أعدل أن يرتدي المرء أسمالا رثّة وينعم غيره في الدمقس وفي الحرير؟
أليس من أجل البشر أجمعين تمنح الطبيعة
حبّا، وسنابل وصباحات مشرقة؟
ذات مساء كانت ذئاب ضخمة هزيلة تدور من حولي
وريح حاصب صرصر تدوي كأنها تذكّرني
بأن خدم البارونات بضحكاتهم الصفراء
قد فرغوا للتو من اختطاف ابنتي والعبث بشرفها.
ذاك المساء حين كنت أتهاوى ساقطا تحت نير رزيتي وشقائي
ذاك المساء حين عيناي استعادتا واحدا واحدا
أيّامي الخوالي، أيامي التي تشبه حبّات مسبحة سوداء
ذاك المساء بعطرها الوحشي الضغينة تعتعتني.
الثورة المتوقّدة في روحي المتحفّزة
علّمتني أن السعادة وقف على الأقوياء
ومن الغروب الغارق في بحر دماء وصهاريج ذهب
أُلهمتُ الجريمة والحرائق.
في تلك الساعة تحت الأشعة المسائية الحمراء:
جمّعت أولادي، آلافا آلافا،
أفواجا أفوجا يمّمنا، مثل جدار مرصوص، صوب برج الإقطاعي
خَبباً سرنا عبر المروج الكليلة ذات الأخاديد الأليفة.
منّينا النفس بأن نرد النبع الأحلى: الحرية
نبع يشبه خمرة جديدة قرمزية
منينا النفس بإبطال بالعصيان الأبدي، إبطال الضرائب كلها، كسر سلاسل العبيد
منينا النفس بأن نرفع عاليا حقّنا في نور الشمس.
لكن الفرسان ذوي الطلعات البهيّة والمتاريس المنيعة
واجهوا عصيّنا بأسلحة فتّاكة
وأثخنوا بجراح لا تشفى
صدورنا العارية المدماة والمكدودة بالنحيب.
هكذا فزنا بالجمال الذي يكسو الضحيّة،
وهكذا عمّقت النصال الأخاديد فوق جباهنا
في حين كانت جثث الكادحين العظماء المسجّاة
تملأ بالبهجة قلوب رهط البارونات.
ها أن جاك بونوم يصرخ: ”سيدفع ثمن ما اقترفت يداه! “
هكذا صوّت إعصار الفولاذ ذاك.
طويلا رافقني جزعي من تلك الصرخات…
وحين انهزمنا رجعنا إلى الجحيم.
وبظهر محنيّ عدت إلى الزراعة
هناك، حيث سكّة المحراث تنبش قبور الشهداء المعدمين.
دموع المسيح، دموع عامّة الناس،
كانت تتلألأ في عيوني المثقلة بالذكريات.
وعشت سنينا طوالا، مئات السنين الطوال،
سليبا، خاضعا،
وكلّ يوم يمرّ يعمّق أغلالي
ويمرّر فوق جسدي خيول عربات الملوك.
رغم أن الكل يعرف أنه لو أغار معتد على سهول بلادي
لنادتني البنادق والمدافع مدوّية فوق القلاع
لأن الكلّ يعلم أن الدم المتدفّق في عروقي
دم غير فاسد، دم أحمر، دم الأقوياء.
الجشع، الكِـبْـر، البذخ، التّهتّك،
جاذبيّة السماوات الغريبة والمدائن الغريبة
يا وطني، يا وطني اللاجئ في قلبي
لم تبدّل أبدا فخارَك العنيد.
وحدهم، أيتها الأم العتيقة، أيتها الأم القديسة، وحدهم يقدرون على حبّك
أولئك الذين لبساطتهم وعوزهم،
لا يملكون من عزاء على مرارة أيامهم
سوى أحلامك الخريفية وضحكاتك الصيفية.
رجال، أزواج، عرقهم المهيب يُخصب أحشاءك وحناياك
رجال، أزواج، يصيخون السمع إليك، تقولين حين تخلدين إلى السكينة:
”إني لمشدودة إليكم شدّا بحقّ الخبز الذي بذرتم حبّاته
وأنتم مشدودون إليّ شدّا بحقّ السرير المهيب، القبر هو السرير“.
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
ومثل مركب صريرُ ألواحه يزعزع هيكلُه
تحت ضربات الأمواه الهائجة ورياح الشتاءات
تُسمَع صرخات الطبيعة الصبور
حين قبضتي المعروقة تعيد تشكيل العالم.
كانت تلك بهجة عظيمة تلت صوما طويلا
كنت قد صرت بدوري ملكا، العين صارخة، والكلمة عالية
اخترت الأرجوان الأعظم عرشا
أرجوان الدم ذاته، الدم الذي يكسو المقصلة.
كنت قد صرت النسر النشوان بالفضاءات المشرقة
كانت جناحاي تحملانني أعلى علّيين
كنت أتشرّب الأثير من تحليقي النهم
حين أردتني رصاصة صياد غادر.
وقتها، أفقت من حلمي البهيّ.
كان دمي قد سُفك من أجل مصالح الآخرين.
كان آخرون غيري قد ثمّنوا ذهب قوّتي، قوّتي الخلّب العابرة
حين كبّلوني بأصفاد دبّرت في الليالي الداجية.
بعد شمس أشرقت طويلا يصير الظلّ أكثر عتمة وسوادا.
النهار! النهار ثانية! سيدي ومولاي الجديد
لا يملك، كي يبهرني، سراب أمجاد
ولا يملك، ليُحني جبيني، قفّاز زرد فولاذي.
سيدي هو ذاك الذي يسنده عجل من ذهب.
وسواء كنت كادحا أو تاجرا، حدّادا أو عاملا في منجم،
سأظلّ على الدوام القنّ الحزين، القنّ المشؤوم
ذاك الذي يأكل الخبز الأسود مغموسا في العرق.
وفي حين كنت أرزح تحت وقع فاقتي
كانت ثريّات الكريستال المطعّم بالذهب والمسرّات
تضيء تحت عيني الولائم والرقصات:
الكراهية من يومها صارت لذّتي الوحيدة.
متى يأتي يوم يلتمع فيه نجمي، ومتى يغيب
عن ناظري مشهد أفقي وهو يسود بالكواسر،
مشهد أولادي يموتون جوعا، في الأوحال أو الثلوج
ومشهد بناتي يسقن إلى زوايا الطرقات حيث يتم بيعهن؟
أيها المموّلون الشرهون، وأنت، أيّتها الحوريّات الباردات
اللواتي تضفين نقاء جبينكن الساطع على المنكرات جميعها،
لأكسرنّ أسنانكم بكؤوسكم الملأى،
ولأرمينّ الصواعق إلى قلب سمائكم!
لأنني، أيها الشعب، أحفظ
في ذاتي المتعذّر سبر غورها
الذكرى الملتهبة للكلمات التي قدّت من نار،
أنا الإيمان، أنا القوّة، والعدد، والفكرة،
أنا، بفضل عملي الدؤوب، شبه إله!
داخل هذا العرين السري الذي نما فيه غضبي،
أمزج في قلبي الشعلة والفولاذ،
وأدرك أنني أنا الذي ظللت مقموعا لأحقاب،
سأصبح، أيها الحكّام، المنصف الأخير.
سأحكمكم بالفأس والهراوة،
وسأحكمكم بالرعب والقرف الباعث على الغثيان،
سآتيكم، بكلّ الوسخ الذي حمّلنيه عملي العتيق،
سأجلس إلى مائدتكم
مثقلا بكوارثي ومصائبي.
سأخرج من أحشاء الحقول والمدن
أفواج كلّ المجوّعين الذين أكلوا ملوكا.
حتى أُعلي كلمة الكتاب المقدّس الجديد،
أيّها المجتمع المعتم، ها أننا ننصب لك صليبا، ونعلقك عليه.
ماريو سكاليزي شاعر اختار لنفسه اسم الشاعر الملعون عن روية وفكر واختيار. فلقد كان على يقين من أن القدر قد رشحه للقيام بأمرين لا يقل أحدهما عن الآخر عنفا: مواجهة رعب الوجود وكتابة الشعر. كانت إقامته على الأرض ملحمة صراع ضد الفاقة والمرض والظلم الاجتماعي. وكان شعره مواجهة عنيدة لقدر لم يختره لكنه اختار أن ينازله. كان ماريو سكاليزي على يقين من أن لا معنى للكائن ولا معنى لحياته أصلا إن هو لم يثأر للكرامة البشرية المنتهكة في الأرض قاطبة. كان على يقين أيضا من أن الشعر واللعب بالكلمات هو آخر ما يتبقى بين يدي الانسان حين تعصف به المحن والرزايا.
ولد ماريو سكاليزي يوم 6 شباط (فبراير) سنة 1892 في تونس، ومنذ نعومة أظفاره تلقّفته الرزايا أشكالا وألوانا. فلقد أصيب بداء التواء العمود الفقري قبل أن يتجاوز سن الخامسة. وقضى ما تبقّى من عمره يعاني من تشوّه شكله ووهن جسده. ولطالما احتمى بالشعر وبالكلمات ليتطهّر من إحساسه العاتي بأن الأقدار قد ابتلته ظلما، إذ حكمت عليه بأن يجرجر جسده الأحدب الملتوي كالصليب حتى القبر.
لذلك كثيرا ما تحوّلت الكتابة لديه إلى نشيد أسود يرفع احتجاجا على البلية. فلئن تحدّثت كتب التاريخ والقصص التي دوّنت أخبار القديسين والمصطفين والمصلحين عما تعرّضوا له في حيواتهم من تنكيل وصلب وتقتيل، فإنها لم تحدّث عن شخص شُوّه جسده حتى اتخذ شكل صليب ملتو. لم تحدّث عن شخص أرغمت روحه على أن تقطن جسدا صار من شدّة تشوّهه مثل الصليب تماما. عديدة هي المرّات التي عبّر فيها سكاليزي عن ضجره بقدره ومقته لجسده فجاءت أشعاره طافحة بالنوح والنحيب. يكتب مثلا:
كان ظلّه، كان ظلّ جسده يمتدّ قدّامه مثل صليب مخز
هي ذي، هي ذي الروح تنتفض ضدّ جسدها
روح تواجه اللعنة الأبدية بالنحيب.
عن نية وقصد سيختار ماريو سكاليزي لقب الشاعر الرجيم حينا، ولقب الشاعر الملعون حينا آخر. وسيعدّ أشعاره أناشيد طالعة من غياهب الجحيم ويضع لديوانه عنوانا دالاّ على وعيه الدرامي بأن اللعنة التي حلّت به ليست سوى الفصل الأبشع في مأساة بني البشر أجمعين. ”قصائد شاعر ملعون- أشعار من غياهب الجحيم“. هكذا نعت نفسه ونعت ديوانه. وسيواجه عدمه الخاص باعتباره عتبة مفتوحة على العدم المتربّص بالوجود ذاته منذ الأزل. والراجح أن هذا الوعي المأساوي الفاجع لم يتولّد عما آل إليه أمر جسده من تشوّهات وما آلت إليه حاله من عذابات فحسب، بل كان مردّه شظف العيش وقلّة الرزق ورقّة الحال. أب بالكاد يكسب قوت عياله. أمّ قابعة في البيت ترعى طفلا متوقّد الذكاء لكنه مقعد محدودب الظهر. فتلوذ بالدمع حينا، وحينا ترفع يديها إلى السماء وهي على يقين من أن باب الشفاء قد أقفل في وجه ابنها إلى الأبد.
كان والد ماريو سكاليزي يشتغل بالسكك الحديدية التي كان أغلب عمالها من الإيطاليين. وهو يتحدّث عنه لا باعتباره إيطاليا بل باعتباره تونسيا قدم من جزيرة صقلية. لكنه يومئ إيماء إلى أن ما حلّ به من عذاب ليس سوى جزء من العقاب الذي أنزلته السماء على والده الذي وصل إلى تونس فارّا من العدالة الإيطالية على إثر جريمة ارتكبها بجزيرة صقلية. لذلك كثيرا ما حرص على أن يرسم لوالده صورة الكادح الذي انتدبته الحياة للبؤس. لكنه يظلّ رغم شظف العيش وشحّ المال وانعدام الأمل رمزا لما تنبني عليه المنزلة البشرية ذاتها من عناد وقدرة على منح الحياة فرصة الاستمرار. يكتب في قصيدة بعنوان ”عقاب“:
رأيت من خلال المطر المدرار الهائل، رأيته في العتمة
أبي العجوز محدّبا داخل معطفه الداكن.
ها هنا كان يمارس عمله كمحوّل سير.
لم يكن لديه أمل في غد أفضل.
لم يكن له مأوى. كان الماء المتلألئ الجبان
يسيل فوق رقبته، ويبلل شواربه.
ويرسم سكاليزي لأمه صورة تكشف حياة خاضعة مستكينة طافحة بالمرارات لكنها لا تخلو من الرقة والحنان. يكتب في قصيدة بعنوان ”أمّي“:
هل اهترأ قلبك، يا أمّي
لا أجرؤ أمام عينيك الباردتين،
أن أتضرع إليك راجيا
أن تقبّليني كما كنت تفعلين.
…………………….
ما تبقّى لي من شباب
اختطفه مني أساك.
وكثيرا ما تعود صورة الأمّ في قصائد سكاليزي مقترنة بفكرة البؤس والفاقة والعذاب. يكتب في قصيدة تحمل عنوان ”تمرّد“:
الماء الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه يؤجّج جوعي.
أمي أما عادت لديك
قطعة واحدة من خبز؟
وراء هذا الحزن تتراءى أحيانا نادرة بعض لحظات الفرح المرتبط بالحياة الجماعية للعائلات الإيطالية في شتاءات تونس. يكتب في قصيدة بعنوان ”حادث“ محدّثا عن احتفالات عيد الميلاد:
كان عيد الميلاد. شتاء أفريقيا،
هذا الشتاء ذو النيسانات المتشابهة،
كان يزهر في الهواء البلسمي
تحت توهّجات الشمس.
……………….
كنت أذهب هناك بحثا عن أوراق اللعب.
قانون عرفي قديم
استدعى أن نلعب بالكعكة
والفول المطهو والجوز.
تتحدّر أمّ ماريو سكاليزي من أسرة مالطية من أصل إيطالي. أما أبوه فهو إيطالي خالص. وقد وصلا تونس خلسة هربا من العدالة الإيطالية. وكان العديد من الإيطاليين قد توطّنوا البلاد التونسية حين سدّت في وجوههم أبواب الرزق بإيطاليا. كان أغلبهم من مدن الجنوب ولاسيما جزيرة صقلية المتاخمة للسواحل التونسية. والثابت تاريخيا أن السلطات الإيطالية وقتها كانت تغض الطرف عن هذه الهجرات السرية وتشجّعها أحيانا كثيرة ليقينها أن الفرنسيين قد أقروا العزم على احتلال المغرب العربي بأسره وتكاثر عدد الإيطاليين في تونس سيمنحها فرصة احتلالها بدعوى حماية الجالية الإيطالية.
لم يكن والد سكاليزي ينتمي إلى رجال الأعمال القائمين على عالم التجارة أو الصناعة أو المهن الحرّة وهم فئة قد سيطرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتونس منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ وما كان جزءا من حركة الهجرة السياسية التي سبقت توحيد إيطاليا، وقد تكونت في معظمها من مثقفين وجنود وتقنيين ينتمون إلى البرجوازية الإيطالية ويحاولون الهرب من هيمنة الدولة وتسلّطها. بل كان مقدمه إلى تونس في نطاق هجرة البروليتاريا المدقعة من جنوب إيطاليا باتجاه أفريقيا بحثا عن العمل في موطن بديل. كان هؤلاء الوافدون الطليان قادمين من المناطق الأكثر فقرا ولاسيما جزيرتي صقلية وسردينيا. ومثلما يفعل المهاجرون عادة تجمّع الإيطاليون داخل أحياء مغلقة تقريبا كثيرا ما أطلقوا عليها اسم صقلية الصغرى. وقد تغلغلت هذه الفئة من المهاجرين بين التونسيين تقاسمهم ظروف الحياة البائسة ذاتها، والمعاناة نفسها.
أمضى سكاليزي طفولته في قلب الجالية الإيطالية. وهي جالية متكونة من مجموعة من المعدمين الذين رست بهم سفن إيطالية في موانئ تونس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولشدّة فقرهم وفاقتهم دعاهم المؤرخ الإيطالي نولو بازوتي Nullo Pasotti الجنس العاري le nude braccia (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
ولما كان سكاليزي متحدّرا من هذا الجنس العاري فقد اضطر أن يكسب رزقه منذ سن مبكرة جدّا. فاشتغل محاسبا في العديد من المتاجر بتونس. ولم يكن وضعه ليعرف الاستقرار أبدا، حتى أنه لم يكن دائما يجد ما به يسد رمقه.
لم يلتحق بالمدرسة إلا لماما. فلم يدم بقاؤه في المدرسة الفرنسية إلا قليلا. واضطرّ إلى أن يقوم بمفرده بجهود متواصلة للتحصيل الثقافي وتوسيع آفاق معارفه. كانت القراءات الغزيرة والمتنوعة سبيله إلى ذلك، إلى أن اشتعلت فيه شعلة الشعر. وفيما كان يتمرّس بالشعر والقصائد تنقاد إليه وتنثال عليه انثيالا كان سخطه يزداد كلما ارتطم بالواقع المرير وكلما تلفّت إلى بؤسه الخاص وبؤس الناس من حوله.
لذلك ظل الموضوع القار في كتابات ماريو سكاليزي التعبير عن الأسى والجهد والبؤس وانعدام العدالة والاستنهاض للثورة والتمرّد. عديدة هي القصائد التي تختفي منها نبرة التأسّي والنوح على الذات فتصبح الكتابة عبارة عن تمجيد للحياة وإعلاء للحياة واحتفاء بالشعب باعتباره حامل جذوة القوة المقدسة التي ستهدم عالم الطغاة والمستبدّين وتثأر للكرامة البشرية المنتهكة. هذا التوجّه الثوري هو الذي جعل ماريو سكاليزي يتعامل مع مأساته الذاتية باعتبارها جزءا من مأساة المقهورين والمضطهدين. وهو الذي جعله يتخلى عن الطابع الغنائي ويشرع في كتابة الملحمة حيث يقوم بتجسيد الصراع الذي يخوضه العمال والفقراء والمقهورون بحثا عن فسحة من نور في ليل وجودهم العاثر. اختار لنصّه عنوان ”ملحمة الفقير“ وتناول فيها بؤس بني البشر في العهد الإقطاعي وبؤسهم آن استولت البورجوازية على مقاليد الأمور وتناول بؤس زنوج أمريكا واعتبر تمثال الحرية مجرّد فكاهة. ذلك أن عذاب الزنوج يكشف أن حلم البشرية بعالم أقل ويلا قد تبخّر حتى في العالم الجديد الذي قصده الناس هربا من الفاقة والظلم الاجتماعي. لذلك يصوّر أمريكا على أنها حاملة مشعل الحرية ثم يهزّئ هذا التصوّر ويحتفي بالسود ونضالاتهم فيكتب محتفيا بالصراع الذي يخوضه الزنوج:
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
وتعد ”ملحمة الفقير“ أبرز قصيدة طويلة متكونة من 36 مقطوعة أنشدها سكاليزي للعمّال والمضطهدين الذين كانوا يكوّنون وسطه التونسي-الإيطالي. كانت الملحمة فاتحة. كانت طريقا مؤدّية إلى كتابة أشعار تستنهض الهمم لرفض فكرة الظلم الاجتماعي نفسها. كتب مثلا:
في حين ينتشي الثراء بعماء،
أحييك، يا نهر العرق المهيب،
باسم الأمل والمنتقمين القادمين،
باسم الراضخين الذين يضنيهم العمل العبثيّ.
وحالما شرع سكاليزي في كتابة هذه الملاحم ذاعت شهرته في أوروبا ذاتها إذ قامت جريدة إيطالي من تونس LItaliano di Tunisi وهي إحدى الجرائد الأوروبية القليلة بتقديمه إلى القراء الأوروبيين على أنه ”شاعر بروليتاريا تونس“. ثم تلقفت الجرائد والدوريات الفرنسية أشعاره. (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
حين نبحث في أرشيف المكتبة الوطنية بتونس عن العلامات التي وسمت الحياة الثقافية والاجتماعية في تونس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يبرز اسم سكاليزي باعتباره شخصيّة متفردة متعددة الأبعاد والانتماءات الثقافية. فهو شاعر تونسي من أصل إيطالي يكتب باللغة الفرنسية ويطرق من الموضوعات ما يجعله شاعرا ناطقا بلسان حال التونسيين والإيطاليين المضطهدين ويحوّل أشعاره إلى مدائح ترفع تمجيدا للحياة وفضحا للمستعمرين والطغاة. يعمد مثلا في نص بعنوان ”سونيتا الاستعمار“ إلى التنديد بفرنسا وجبروتها فيتوجّه بالكلام إلى والد شهيد:
الوطن شبيه بعرائس البحر العتيقة
التي كانت أصواتها تضيع البحّارة.
الوطن يجحد الأغنيات: لكن نحيبه الإلهي
يلهم النفس رغبة النخل السيّد
نواقيس الخطر تقرع في فجرنا الهادئ الصافي
الحرائق تبهر البراري والبحار
فيما فرنسا في ثوب الحداد تلثم العيون المغمضة،
عيون شباب في ربيع العمر هلكوا في حلبات النزال الحمراء
أيها الأب الذي بقي وحيدا في عزّ المساء
نيسان ابنك، حمرة دمه
زهر سيورق على رايات الملحمة
ابنك اختار على شعاع السماء ونورها
الرقة الوحشية لرقدة الأبطال،
الرقدة الرميم في أرض حيث الأجداد ناموا.
إن تنوّع المصادر التي عرّفت بسكاليزي وتناولت أشعاره ومقالاته بالنقد يؤكّد في حدّ ذاته هذا الانتماء الحضاري المتعدّد. لقد كتب سكاليزي بالفرنسية لغة المستعمر. وكان من الطبيعي أن يعدّه النقد الفرنسي أحد الوجوه البارزة في الحركة الفكرية الفرنسية بتونس. وهذا ما ذهب إليه إيف شاتلان Yves Châtelain مثلا في كتابه الحياة الأدبية والفكرية بتونس بين 1900 و1937 (Vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937). ولكنه يذكره أيضا ضمن الصفحات المخصصة للحركة الفكرية الإيطالية، رغم أنه يفعل ذلك بهدف التركيز على هجرة الأقلام الإيطالية نحو التعبير باللغة الفرنسية كنتيجة للهيمنة الحضارية واللغوية للمستعمر الفرنسي.
ولأن سكاليزي من أصل إيطالي عمد غاسبار داغوانو Gaspare DAguanno إلى اعتباره شاعرا إيطاليا خالصا فكتب عنه دراسة مطولة بالفرنسية ونشرها بمدينة تراباني في صقلية مسقط رأس أب سكاليزي، فصارت مدينة تراباني تفاخر بسكاليزي وتحتفي به باعتباره أحد مواطنيها الذين أصبحوا مشهورين. وفي الوقت ذاته سيواصل المغرب العربي في دوريّاته تمسّكه بسكاليزي باعتباره ابن البيئة التونسية والناطق بآمال شعوب المغرب في التحرر والكرامة.
لذلك ستعتبر جمعية أدباء شمال أفريقيا أعمال سكاليزي جزءا من الموروث الثقافي التونسي، وتعدّه أمارة على وجود أدب قائم بذاته بالمغرب العربي، وشاهدا على ثراء الحياة الأدبية بتونس وتفردها في تلك المرحلة من تاريخها، لأن سكاليزي شاعر يجسد هذا التفرّد باعتبار أن أشعاره تكشف بعنف أبعاد هذه الهويّة المتعدّدة.
أما ماريو سكاليزي فإنه صنّف نفسه واختار عائلته حين وضع لديوانه عنوان ”قصائد شاعر ملعون“. وهو عنوان يشير صراحة إلى أنه يعتبر نفسه ملعونا لا بسبب الوشائج الروحية التي تربطه بالمدرسة الفرنسية للشعراء الملاعين، بل أيضا بسبب ارتباطه بالبؤس الذي وسم حياة المهاجرين الإيطاليين بتونس، وخاصة منهم القادمين من صقلية، وبسبب إقامته في بلاد تآمر الطغاة والغزاة على ناسها وغدها. ولهذا أيضا جاء العنوان الفرعي ”أشعار من غياهب الجحيم“ بمثابة إلحاح على أن الشاعر الحق إنما هو ذاك الذي يقاسم المغلوبين والمقهورين جحيمهم ولا يفرّ من المنازلة حتى إذا كان بإمكانه تحقيق خلاصه الفردي. لذلك سيلتصق سكاليزي بالمكان ولن يحدّث عن أمجاد العرب والمسلمين كما يحدّث الرومانسيون الغربيون الذين تعاملوا مع الشرق باعتباره موطن الخرافة والسحر وتدويخ الحواس وبلسم الإنسان الأوروبي الذي ضجر بعقلانية عصر الأنوار، بل سيتغنى بالمكان وبالمعمار الشرقي ويعتبر العرب حمالة حقيقة وبناة حضارة. يكتب في نص بعنوان ”الصومعات“:
أيتها الصومعات، بهاء أنت فوق الدكاكين
صرخة من حجر دافقة من قلب الشرق العظيم
أيتها الأبراج البيضاء
أنت مثل حراس من المتصوّفة ترقبين
رعشة الأمل في قلب السماء الضحوك
منارات أنت نورها قُـدَّ من صلوات
منارات تشعّ التقوى فيها مثل بيت طهور
من بعيد ترسمين في وجه القادمين من السماء
محيط اللازورد
الدرب السالكة للأرض
كم أهوى أن أراك منتصبة قبالة المغيب وهو يحترق
مثل حرّاس مدينة من ذهب
كم أهوى أن أراك في الأفق الرائع وقت المغيب
حين نحلم بحدائق يزهر فيها الموت والعدم.
نداء المؤذنين الذي يبلغ حتى مسامع الراقدين في القبور
يبدو كأنه سؤال تطرحينه على الأثير الأزرق
وحين الحمائم تأتي وتحطّ على أكتافك
توشوشك إجابة الله.
هجرات تتلوها هجرات. هكذا كانت حياة سكاليزي. فمنذ اللحظة التي هاجر فيها والداه من إيطاليا تلقفت الهجرة حياة ماريو سكاليزي وصارت قدرا ومصيرا. هاجر من الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية الإسلامية وعشقها. هاجر من لغته الإيطالية فكتب بالفرنسية وأتقنها. وكانت الهجرة الأخيرة مميتة فبعد عمر مليء بالأحزان مات سكاليزي يوم 31 مارس 1922 وهو في الثلاثين من عمره، في مشفى عقلي بمدينة باليرمو الايطالية، فريسة للسل والجنون.
طبعت مجموعة سكاليزي مرات عديدة. ظهرت المجموعة أولا سنة 1923 ضمن منشورات بال لاترBelles Lettres ، وسنة 1930 نشرتها الكاهنة، وسنة 1935 نشرتها سندباد. ونشرها سنة 1996 عبد الرزاق بنور في تونس وقدّم لها الإيطالي إيفون فرانكاسيتي بروندين. وقد احتوت هذه الطبعة الرابعة على كل قصائد سكاليزي باستثناء قصيدة واحدة، وهي سونيتة على الأرجح، لم يتم العثور عليها كاملة. وقد ذكر بعض معاصري سكاليزي هذه المقاطع منها:
لقد غذيتني من عقل حكمائك،
من لحمك، من دمك، من شمسك المحرقة،
آه، فرنسا! وحين لم يكن قلبي غير صفحات بيض،
ارتسم اسمك فوقها، ملتمعا بنار قرمزية.
………………………………………
أيها الظهور الأشقر، أعلم من أين يأتي هدوؤك،
من أعياد فصح السلام سيخضرّ جرحك
جرحك هو النبع الذي سيرتوي منه المستقبل.
يظل ماريو سكاليزي رمزا للشاعر الذي لم يختر قدره لكنه اختار أن ينازله حتى النهاية. وهو يعتبر الشعر هبة السماء. لكنه يعتبر الشاعر شخصا منذورا للخيانة الأفظع. فما من شاعر إلا وهو يحمل في ذاته ملمحا من ملامح يهوذا. غير أن الشاعر لا يخون الآخرين بل يغدر بنفسه لأنه ينشغل بالشعر على حساب العيش. يكتب في نص بعنوان ”يهوذا“:
هل تغفرين لي أيتها الورود الرقيقة
أيتها الزنابق، أيتها الزرقة البكر للسماء صيفا
هل تغفرين الجريمة البشعة التي أضمر إتيانها أحيانا
حين الكآبة تستبدّ بي وقشعريرة الرعب تهزّني هزّا
أنا شخصان: المغني صانع الأنغام الذي يعبر
هناك، في تلك الطريق العابقة بالأمجاد والمُثُل
ذاك الشاعر الجوال الذي تحوي عيناه الفضاءات جميعها
ذاك الذي يداه مثقلتان بأزهار فردوس البداية
ذاك أنا. لكن هذا الذي يقضي دهره محكوما بالأشغال الشاقة
هذا البائس التائه بين قطعان البشر
هذا الذي يمضي مطأطئ الرأس جبان القلب باحثا
في مستنقع الحياة عن كسرة خبز
هو أيضا أنا. غدا أو ربما هذا المساء
الناس الذين سأحبهم سيهبونني -ويا لشقوتي-
حتى أهجر الفنّ، أجرة الخائن
وبثلاثين فلسا سأبيع المغني.
مختارات من أشعار سكاليزي
أغنية
أيها الطفل الصغير، ابق نائما في قماطك
لا تفتح عينيك المدهوشتين
عينيك التي ألفت رؤية الملائكة
لا تفتحهما عينيك على عالم الملاعين عالمنا.
يا ابن البشر الأنجاس المناكيد
البشر المسطولين بحبّ الذهب حتى الشقاء
لتهدهدك أحلامك المقدودة من نسغ الورود
أيها الطفل الصغير، استمرّ في النوم.
إنا هنا لنألم حين يسرقون منا
بهجة الربيع القرمزي الوهّاج
أيها الطفل الصغير، فلتكن بسمتك
نداء الشمس فينا.
الديوان ص71
ثــورة
أمي منذ فجري الأول وأنا أكدح
الضنى قدري والضجر يكاد يفنيني
اطرحي من أجلي فستانك القديم
على البلاط.
البلاط لا يهب دفئا أبدا
والشتاء غضوب شرس! إنها تمطر الآن
يرتد النظر كسيرا قدّام الدياجير، هلاّ أوقدت لي
نارا؟
الماء البارد الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه سعار في الحشى يوقظ جوعي
أمّي أما زالت عندك كسرة
خبز؟
لا خبز. لا نار. الحياة دياجير تكرّ
لعناتي عليها أصبّ ولا أملك غير اللعنات
إني لأسمع الأطفال في العتمة
ينوحون.
أختي أصغر أخواتي حين رأت شقوتي،
أختي ذات العينيين العذبتين،
قالت لي: ”هات يدك خذ بسرعة، ما في جيبي غير
فلسين“.
قالت ثانية في نبرة حنون:
”ماذا تريد أن أشتري لك أخي الأكبر
هل أشتري لك خبزا؟ قلت: ”لا… بل
كأسا مترعة“.
الديوان، ص73-74
حفار القبور
رأيته بفأس حادة يحفر الأرض الصمّاء
رأيته حفار القبور الكئيب، الشيخ الأبدي
حطّمت طلعته الشقية مثل قبضة ثقيلة
شعاع الأمل الكريستالي في قاع روحي.
كيف يمكننا أن نعيش غير مبالين، أن نضحك
بينما يداه توسّعان تحت أقدامنا
الحفرة الباردة حيث الموت يستدرجنا
نحن الألى فقدنا الأمل في رحمة ما، في خلاص ما؟
……
كيف يمكننا أن نؤمن بالربيع، بالفجر،
بالأفق اللازوردي، بالشمس، بالأنهار، بالمستقبل؟
كيف يمكننا أن نظل سذّجا غافلين
حتى ننفق أيامنا في الزرع والتشييد؟
في حين يكفي أن نصيخ السمع قليلا صامتين
إلى الإيقاع الرتيب لدقّات قلوبنا
حتى نسمع ضربات فأس حفار القبور
تدوّي في وجيب الدمّ في قلوبنا.
شعر أبيض، ظهر أحدب، لكن قوّته ظلت خارقة
معطفه الأسود يلف الأمس ويلف الغد،
رأيته حفار القبور منتفخ الصدر يكدّ
مفتول العضلات لا يكلّ.
الحفرة التي كان يوسّعها بدت من عمقها هاوية
لا شيء في الدنيا يمكن أن يملأها إلا الكون كلّه.
كلّ الدروب في الدنيا ستنتهي إلى هذه الحفرة،
والناس الطيبون والأوغاد المارقون فيها سينتهون.
أجل ههنا ستسقط البشرية جمعاء، هذا نهر
من وجوه، نهر من أصوات، من أصابع ملتوية، نهر من قلوب،
والليل يهدهد جباهنا في حضن امرأة ثكلى،
والشمس مذبح تنزف على مدارجه دماؤنا،
رأيت الناس يعبرون، مجانين أوعقلاء،
رأيت الأطفال المأخوذين بالأمجاد والمسرّات،
النساء اللاتي تحلّين صدرياتهن بالورود،
النساء اللاتي تسمعن نداء العطر فتهبن من خيراتهن.
……
أموات المستقبل، الألى نفوسهم تتقي بكل طيش
تحذيرات أشجار السرو
أموات المستقبل يكادون لا يلمسون
على الطريق
آثار العبور الأبدي لمن كانوا أحياء في الماضي.
٭ ٭ ٭
الشكر لك يا إلهي، الشكر لك، أيها الإله الرحيم، الإله العادل جدّا،
يا من تقبض الأنفس جميعها.
شكرا لك فقد عجنت بيدك الطاهرة
زهرة أعوامي العشرين.
بفضلك وحدك سأستطيع أن أنزلق داخل الحفرة المعتمة
دون حسرة على نور النهار.
سأُزَفّ إلى الليل، وسأحيي ظلّ
قُبلتي الأولى.
لكن اسمح أن تجعل قلبي دمعة حمراء
اسمح أن أرفع الصوت عتابا
حين أسمع النشيد المخادع الذي يغذي
أمل المحكومين بالإعدام.
ملحمة الفقير
في سالف الأيام عندما كانت الأشعة الحمراء المنبعثة من المشاعل العملاقة
تنعكس مثل القبل على بلور الشبابيك الكريستالي ذي اللون النهدي،
كان البارونات المترفون يلتهمون في صالوناتهم
لحم الخنازير البرية التي اصطادوها في حقولي المزروعة قمحا.
كان أطفالي يجيبون بأنّات الجياع
على الترانيم المنبعثة من الشفاه المخمورة
على ضحكات المهرّجين … على اعترافات النساء العاشقات العطرة.
كان أطفالي يجيبونهم بأنّات الجياع مثل كلاب ضائعة تعوي عواء مريرا في الغابات.
حين كنت ضجرا من التضرّع للأفق اللازوردي، متهالكا على الأرض،
حين كنت أتوسّل الأرض كي تنشق وتبتلعني
خاطبني امرؤ قدم للتو من المعبد: ”أيْ بنيّ
تعلّم على الأقلّ أن تطلب المغفرة لذنوبك دون ضجّة أو أنين“.
أطلب المغفرة، أطلب المغفرة، أيّ جرم اقترفت يداي
هل تعكّر أنفاسي البائسة صفو السماء؟
أما صلّيت للسماء وسدّدت الدين كاملا؟
أما تعرّيت حملا وديعا كي أزيد سدنة المعبد ثراء على ثراء؟
مرّة أحدّث نفسي هكذا: ”إلهي، سيّد الدنيا والعالمين
سيّد لآلئ السماوات وكنوز البحار
ما الذي يجنيه من كل هذا الذهب الذي رصّعت به المعابد
لماذا يحرم أبناءه البررة، لماذا يحرم قرّة عينه؟
وأحيانا أحدّث نفسي قائلا: ”أَعدلٌ ما يجري،
أعدل أن يرتدي المرء أسمالا رثّة وينعم غيره في الدمقس وفي الحرير؟
أليس من أجل البشر أجمعين تمنح الطبيعة
حبّا، وسنابل وصباحات مشرقة؟
ذات مساء كانت ذئاب ضخمة هزيلة تدور من حولي
وريح حاصب صرصر تدوي كأنها تذكّرني
بأن خدم البارونات بضحكاتهم الصفراء
قد فرغوا للتو من اختطاف ابنتي والعبث بشرفها.
ذاك المساء حين كنت أتهاوى ساقطا تحت نير رزيتي وشقائي
ذاك المساء حين عيناي استعادتا واحدا واحدا
أيّامي الخوالي، أيامي التي تشبه حبّات مسبحة سوداء
ذاك المساء بعطرها الوحشي الضغينة تعتعتني.
الثورة المتوقّدة في روحي المتحفّزة
علّمتني أن السعادة وقف على الأقوياء
ومن الغروب الغارق في بحر دماء وصهاريج ذهب
أُلهمتُ الجريمة والحرائق.
في تلك الساعة تحت الأشعة المسائية الحمراء:
جمّعت أولادي، آلافا آلافا،
أفواجا أفوجا يمّمنا، مثل جدار مرصوص، صوب برج الإقطاعي
خَبباً سرنا عبر المروج الكليلة ذات الأخاديد الأليفة.
منّينا النفس بأن نرد النبع الأحلى: الحرية
نبع يشبه خمرة جديدة قرمزية
منينا النفس بإبطال بالعصيان الأبدي، إبطال الضرائب كلها، كسر سلاسل العبيد
منينا النفس بأن نرفع عاليا حقّنا في نور الشمس.
لكن الفرسان ذوي الطلعات البهيّة والمتاريس المنيعة
واجهوا عصيّنا بأسلحة فتّاكة
وأثخنوا بجراح لا تشفى
صدورنا العارية المدماة والمكدودة بالنحيب.
هكذا فزنا بالجمال الذي يكسو الضحيّة،
وهكذا عمّقت النصال الأخاديد فوق جباهنا
في حين كانت جثث الكادحين العظماء المسجّاة
تملأ بالبهجة قلوب رهط البارونات.
ها أن جاك بونوم يصرخ: ”سيدفع ثمن ما اقترفت يداه! “
هكذا صوّت إعصار الفولاذ ذاك.
طويلا رافقني جزعي من تلك الصرخات…
وحين انهزمنا رجعنا إلى الجحيم.
وبظهر محنيّ عدت إلى الزراعة
هناك، حيث سكّة المحراث تنبش قبور الشهداء المعدمين.
دموع المسيح، دموع عامّة الناس،
كانت تتلألأ في عيوني المثقلة بالذكريات.
وعشت سنينا طوالا، مئات السنين الطوال،
سليبا، خاضعا،
وكلّ يوم يمرّ يعمّق أغلالي
ويمرّر فوق جسدي خيول عربات الملوك.
رغم أن الكل يعرف أنه لو أغار معتد على سهول بلادي
لنادتني البنادق والمدافع مدوّية فوق القلاع
لأن الكلّ يعلم أن الدم المتدفّق في عروقي
دم غير فاسد، دم أحمر، دم الأقوياء.
الجشع، الكِـبْـر، البذخ، التّهتّك،
جاذبيّة السماوات الغريبة والمدائن الغريبة
يا وطني، يا وطني اللاجئ في قلبي
لم تبدّل أبدا فخارَك العنيد.
وحدهم، أيتها الأم العتيقة، أيتها الأم القديسة، وحدهم يقدرون على حبّك
أولئك الذين لبساطتهم وعوزهم،
لا يملكون من عزاء على مرارة أيامهم
سوى أحلامك الخريفية وضحكاتك الصيفية.
رجال، أزواج، عرقهم المهيب يُخصب أحشاءك وحناياك
رجال، أزواج، يصيخون السمع إليك، تقولين حين تخلدين إلى السكينة:
”إني لمشدودة إليكم شدّا بحقّ الخبز الذي بذرتم حبّاته
وأنتم مشدودون إليّ شدّا بحقّ السرير المهيب، القبر هو السرير“.
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
ومثل مركب صريرُ ألواحه يزعزع هيكلُه
تحت ضربات الأمواه الهائجة ورياح الشتاءات
تُسمَع صرخات الطبيعة الصبور
حين قبضتي المعروقة تعيد تشكيل العالم.
كانت تلك بهجة عظيمة تلت صوما طويلا
كنت قد صرت بدوري ملكا، العين صارخة، والكلمة عالية
اخترت الأرجوان الأعظم عرشا
أرجوان الدم ذاته، الدم الذي يكسو المقصلة.
كنت قد صرت النسر النشوان بالفضاءات المشرقة
كانت جناحاي تحملانني أعلى علّيين
كنت أتشرّب الأثير من تحليقي النهم
حين أردتني رصاصة صياد غادر.
وقتها، أفقت من حلمي البهيّ.
كان دمي قد سُفك من أجل مصالح الآخرين.
كان آخرون غيري قد ثمّنوا ذهب قوّتي، قوّتي الخلّب العابرة
حين كبّلوني بأصفاد دبّرت في الليالي الداجية.
بعد شمس أشرقت طويلا يصير الظلّ أكثر عتمة وسوادا.
النهار! النهار ثانية! سيدي ومولاي الجديد
لا يملك، كي يبهرني، سراب أمجاد
ولا يملك، ليُحني جبيني، قفّاز زرد فولاذي.
سيدي هو ذاك الذي يسنده عجل من ذهب.
وسواء كنت كادحا أو تاجرا، حدّادا أو عاملا في منجم،
سأظلّ على الدوام القنّ الحزين، القنّ المشؤوم
ذاك الذي يأكل الخبز الأسود مغموسا في العرق.
وفي حين كنت أرزح تحت وقع فاقتي
كانت ثريّات الكريستال المطعّم بالذهب والمسرّات
تضيء تحت عيني الولائم والرقصات:
الكراهية من يومها صارت لذّتي الوحيدة.
متى يأتي يوم يلتمع فيه نجمي، ومتى يغيب
عن ناظري مشهد أفقي وهو يسود بالكواسر،
مشهد أولادي يموتون جوعا، في الأوحال أو الثلوج
ومشهد بناتي يسقن إلى زوايا الطرقات حيث يتم بيعهن؟
أيها المموّلون الشرهون، وأنت، أيّتها الحوريّات الباردات
اللواتي تضفين نقاء جبينكن الساطع على المنكرات جميعها،
لأكسرنّ أسنانكم بكؤوسكم الملأى،
ولأرمينّ الصواعق إلى قلب سمائكم!
لأنني، أيها الشعب، أحفظ
في ذاتي المتعذّر سبر غورها
الذكرى الملتهبة للكلمات التي قدّت من نار،
أنا الإيمان، أنا القوّة، والعدد، والفكرة،
أنا، بفضل عملي الدؤوب، شبه إله!
داخل هذا العرين السري الذي نما فيه غضبي،
أمزج في قلبي الشعلة والفولاذ،
وأدرك أنني أنا الذي ظللت مقموعا لأحقاب،
سأصبح، أيها الحكّام، المنصف الأخير.
سأحكمكم بالفأس والهراوة،
وسأحكمكم بالرعب والقرف الباعث على الغثيان،
سآتيكم، بكلّ الوسخ الذي حمّلنيه عملي العتيق،
سأجلس إلى مائدتكم
مثقلا بكوارثي ومصائبي.
سأخرج من أحشاء الحقول والمدن
أفواج كلّ المجوّعين الذين أكلوا ملوكا.
حتى أُعلي كلمة الكتاب المقدّس الجديد،
أيّها المجتمع المعتم، ها أننا ننصب لك صليبا، ونعلقك عليه.
ماريو سكاليزي شاعر اختار لنفسه اسم الشاعر الملعون عن روية وفكر واختيار. فلقد كان على يقين من أن القدر قد رشحه للقيام بأمرين لا يقل أحدهما عن الآخر عنفا: مواجهة رعب الوجود وكتابة الشعر. كانت إقامته على الأرض ملحمة صراع ضد الفاقة والمرض والظلم الاجتماعي. وكان شعره مواجهة عنيدة لقدر لم يختره لكنه اختار أن ينازله. كان ماريو سكاليزي على يقين من أن لا معنى للكائن ولا معنى لحياته أصلا إن هو لم يثأر للكرامة البشرية المنتهكة في الأرض قاطبة. كان على يقين أيضا من أن الشعر واللعب بالكلمات هو آخر ما يتبقى بين يدي الانسان حين تعصف به المحن والرزايا.
ولد ماريو سكاليزي يوم 6 شباط (فبراير) سنة 1892 في تونس، ومنذ نعومة أظفاره تلقّفته الرزايا أشكالا وألوانا. فلقد أصيب بداء التواء العمود الفقري قبل أن يتجاوز سن الخامسة. وقضى ما تبقّى من عمره يعاني من تشوّه شكله ووهن جسده. ولطالما احتمى بالشعر وبالكلمات ليتطهّر من إحساسه العاتي بأن الأقدار قد ابتلته ظلما، إذ حكمت عليه بأن يجرجر جسده الأحدب الملتوي كالصليب حتى القبر.
لذلك كثيرا ما تحوّلت الكتابة لديه إلى نشيد أسود يرفع احتجاجا على البلية. فلئن تحدّثت كتب التاريخ والقصص التي دوّنت أخبار القديسين والمصطفين والمصلحين عما تعرّضوا له في حيواتهم من تنكيل وصلب وتقتيل، فإنها لم تحدّث عن شخص شُوّه جسده حتى اتخذ شكل صليب ملتو. لم تحدّث عن شخص أرغمت روحه على أن تقطن جسدا صار من شدّة تشوّهه مثل الصليب تماما. عديدة هي المرّات التي عبّر فيها سكاليزي عن ضجره بقدره ومقته لجسده فجاءت أشعاره طافحة بالنوح والنحيب. يكتب مثلا:
كان ظلّه، كان ظلّ جسده يمتدّ قدّامه مثل صليب مخز
هي ذي، هي ذي الروح تنتفض ضدّ جسدها
روح تواجه اللعنة الأبدية بالنحيب.
عن نية وقصد سيختار ماريو سكاليزي لقب الشاعر الرجيم حينا، ولقب الشاعر الملعون حينا آخر. وسيعدّ أشعاره أناشيد طالعة من غياهب الجحيم ويضع لديوانه عنوانا دالاّ على وعيه الدرامي بأن اللعنة التي حلّت به ليست سوى الفصل الأبشع في مأساة بني البشر أجمعين. ”قصائد شاعر ملعون- أشعار من غياهب الجحيم“. هكذا نعت نفسه ونعت ديوانه. وسيواجه عدمه الخاص باعتباره عتبة مفتوحة على العدم المتربّص بالوجود ذاته منذ الأزل. والراجح أن هذا الوعي المأساوي الفاجع لم يتولّد عما آل إليه أمر جسده من تشوّهات وما آلت إليه حاله من عذابات فحسب، بل كان مردّه شظف العيش وقلّة الرزق ورقّة الحال. أب بالكاد يكسب قوت عياله. أمّ قابعة في البيت ترعى طفلا متوقّد الذكاء لكنه مقعد محدودب الظهر. فتلوذ بالدمع حينا، وحينا ترفع يديها إلى السماء وهي على يقين من أن باب الشفاء قد أقفل في وجه ابنها إلى الأبد.
كان والد ماريو سكاليزي يشتغل بالسكك الحديدية التي كان أغلب عمالها من الإيطاليين. وهو يتحدّث عنه لا باعتباره إيطاليا بل باعتباره تونسيا قدم من جزيرة صقلية. لكنه يومئ إيماء إلى أن ما حلّ به من عذاب ليس سوى جزء من العقاب الذي أنزلته السماء على والده الذي وصل إلى تونس فارّا من العدالة الإيطالية على إثر جريمة ارتكبها بجزيرة صقلية. لذلك كثيرا ما حرص على أن يرسم لوالده صورة الكادح الذي انتدبته الحياة للبؤس. لكنه يظلّ رغم شظف العيش وشحّ المال وانعدام الأمل رمزا لما تنبني عليه المنزلة البشرية ذاتها من عناد وقدرة على منح الحياة فرصة الاستمرار. يكتب في قصيدة بعنوان ”عقاب“:
رأيت من خلال المطر المدرار الهائل، رأيته في العتمة
أبي العجوز محدّبا داخل معطفه الداكن.
ها هنا كان يمارس عمله كمحوّل سير.
لم يكن لديه أمل في غد أفضل.
لم يكن له مأوى. كان الماء المتلألئ الجبان
يسيل فوق رقبته، ويبلل شواربه.
ويرسم سكاليزي لأمه صورة تكشف حياة خاضعة مستكينة طافحة بالمرارات لكنها لا تخلو من الرقة والحنان. يكتب في قصيدة بعنوان ”أمّي“:
هل اهترأ قلبك، يا أمّي
لا أجرؤ أمام عينيك الباردتين،
أن أتضرع إليك راجيا
أن تقبّليني كما كنت تفعلين.
…………………….
ما تبقّى لي من شباب
اختطفه مني أساك.
وكثيرا ما تعود صورة الأمّ في قصائد سكاليزي مقترنة بفكرة البؤس والفاقة والعذاب. يكتب في قصيدة تحمل عنوان ”تمرّد“:
الماء الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه يؤجّج جوعي.
أمي أما عادت لديك
قطعة واحدة من خبز؟
وراء هذا الحزن تتراءى أحيانا نادرة بعض لحظات الفرح المرتبط بالحياة الجماعية للعائلات الإيطالية في شتاءات تونس. يكتب في قصيدة بعنوان ”حادث“ محدّثا عن احتفالات عيد الميلاد:
كان عيد الميلاد. شتاء أفريقيا،
هذا الشتاء ذو النيسانات المتشابهة،
كان يزهر في الهواء البلسمي
تحت توهّجات الشمس.
……………….
كنت أذهب هناك بحثا عن أوراق اللعب.
قانون عرفي قديم
استدعى أن نلعب بالكعكة
والفول المطهو والجوز.
تتحدّر أمّ ماريو سكاليزي من أسرة مالطية من أصل إيطالي. أما أبوه فهو إيطالي خالص. وقد وصلا تونس خلسة هربا من العدالة الإيطالية. وكان العديد من الإيطاليين قد توطّنوا البلاد التونسية حين سدّت في وجوههم أبواب الرزق بإيطاليا. كان أغلبهم من مدن الجنوب ولاسيما جزيرة صقلية المتاخمة للسواحل التونسية. والثابت تاريخيا أن السلطات الإيطالية وقتها كانت تغض الطرف عن هذه الهجرات السرية وتشجّعها أحيانا كثيرة ليقينها أن الفرنسيين قد أقروا العزم على احتلال المغرب العربي بأسره وتكاثر عدد الإيطاليين في تونس سيمنحها فرصة احتلالها بدعوى حماية الجالية الإيطالية.
لم يكن والد سكاليزي ينتمي إلى رجال الأعمال القائمين على عالم التجارة أو الصناعة أو المهن الحرّة وهم فئة قد سيطرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتونس منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ وما كان جزءا من حركة الهجرة السياسية التي سبقت توحيد إيطاليا، وقد تكونت في معظمها من مثقفين وجنود وتقنيين ينتمون إلى البرجوازية الإيطالية ويحاولون الهرب من هيمنة الدولة وتسلّطها. بل كان مقدمه إلى تونس في نطاق هجرة البروليتاريا المدقعة من جنوب إيطاليا باتجاه أفريقيا بحثا عن العمل في موطن بديل. كان هؤلاء الوافدون الطليان قادمين من المناطق الأكثر فقرا ولاسيما جزيرتي صقلية وسردينيا. ومثلما يفعل المهاجرون عادة تجمّع الإيطاليون داخل أحياء مغلقة تقريبا كثيرا ما أطلقوا عليها اسم صقلية الصغرى. وقد تغلغلت هذه الفئة من المهاجرين بين التونسيين تقاسمهم ظروف الحياة البائسة ذاتها، والمعاناة نفسها.
أمضى سكاليزي طفولته في قلب الجالية الإيطالية. وهي جالية متكونة من مجموعة من المعدمين الذين رست بهم سفن إيطالية في موانئ تونس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولشدّة فقرهم وفاقتهم دعاهم المؤرخ الإيطالي نولو بازوتي Nullo Pasotti الجنس العاري le nude braccia (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
ولما كان سكاليزي متحدّرا من هذا الجنس العاري فقد اضطر أن يكسب رزقه منذ سن مبكرة جدّا. فاشتغل محاسبا في العديد من المتاجر بتونس. ولم يكن وضعه ليعرف الاستقرار أبدا، حتى أنه لم يكن دائما يجد ما به يسد رمقه.
لم يلتحق بالمدرسة إلا لماما. فلم يدم بقاؤه في المدرسة الفرنسية إلا قليلا. واضطرّ إلى أن يقوم بمفرده بجهود متواصلة للتحصيل الثقافي وتوسيع آفاق معارفه. كانت القراءات الغزيرة والمتنوعة سبيله إلى ذلك، إلى أن اشتعلت فيه شعلة الشعر. وفيما كان يتمرّس بالشعر والقصائد تنقاد إليه وتنثال عليه انثيالا كان سخطه يزداد كلما ارتطم بالواقع المرير وكلما تلفّت إلى بؤسه الخاص وبؤس الناس من حوله.
لذلك ظل الموضوع القار في كتابات ماريو سكاليزي التعبير عن الأسى والجهد والبؤس وانعدام العدالة والاستنهاض للثورة والتمرّد. عديدة هي القصائد التي تختفي منها نبرة التأسّي والنوح على الذات فتصبح الكتابة عبارة عن تمجيد للحياة وإعلاء للحياة واحتفاء بالشعب باعتباره حامل جذوة القوة المقدسة التي ستهدم عالم الطغاة والمستبدّين وتثأر للكرامة البشرية المنتهكة. هذا التوجّه الثوري هو الذي جعل ماريو سكاليزي يتعامل مع مأساته الذاتية باعتبارها جزءا من مأساة المقهورين والمضطهدين. وهو الذي جعله يتخلى عن الطابع الغنائي ويشرع في كتابة الملحمة حيث يقوم بتجسيد الصراع الذي يخوضه العمال والفقراء والمقهورون بحثا عن فسحة من نور في ليل وجودهم العاثر. اختار لنصّه عنوان ”ملحمة الفقير“ وتناول فيها بؤس بني البشر في العهد الإقطاعي وبؤسهم آن استولت البورجوازية على مقاليد الأمور وتناول بؤس زنوج أمريكا واعتبر تمثال الحرية مجرّد فكاهة. ذلك أن عذاب الزنوج يكشف أن حلم البشرية بعالم أقل ويلا قد تبخّر حتى في العالم الجديد الذي قصده الناس هربا من الفاقة والظلم الاجتماعي. لذلك يصوّر أمريكا على أنها حاملة مشعل الحرية ثم يهزّئ هذا التصوّر ويحتفي بالسود ونضالاتهم فيكتب محتفيا بالصراع الذي يخوضه الزنوج:
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
وتعد ”ملحمة الفقير“ أبرز قصيدة طويلة متكونة من 36 مقطوعة أنشدها سكاليزي للعمّال والمضطهدين الذين كانوا يكوّنون وسطه التونسي-الإيطالي. كانت الملحمة فاتحة. كانت طريقا مؤدّية إلى كتابة أشعار تستنهض الهمم لرفض فكرة الظلم الاجتماعي نفسها. كتب مثلا:
في حين ينتشي الثراء بعماء،
أحييك، يا نهر العرق المهيب،
باسم الأمل والمنتقمين القادمين،
باسم الراضخين الذين يضنيهم العمل العبثيّ.
وحالما شرع سكاليزي في كتابة هذه الملاحم ذاعت شهرته في أوروبا ذاتها إذ قامت جريدة إيطالي من تونس LItaliano di Tunisi وهي إحدى الجرائد الأوروبية القليلة بتقديمه إلى القراء الأوروبيين على أنه ”شاعر بروليتاريا تونس“. ثم تلقفت الجرائد والدوريات الفرنسية أشعاره. (مقدمة الديوان بقلم إيفون فرانكاسيتي بروندينو).
حين نبحث في أرشيف المكتبة الوطنية بتونس عن العلامات التي وسمت الحياة الثقافية والاجتماعية في تونس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يبرز اسم سكاليزي باعتباره شخصيّة متفردة متعددة الأبعاد والانتماءات الثقافية. فهو شاعر تونسي من أصل إيطالي يكتب باللغة الفرنسية ويطرق من الموضوعات ما يجعله شاعرا ناطقا بلسان حال التونسيين والإيطاليين المضطهدين ويحوّل أشعاره إلى مدائح ترفع تمجيدا للحياة وفضحا للمستعمرين والطغاة. يعمد مثلا في نص بعنوان ”سونيتا الاستعمار“ إلى التنديد بفرنسا وجبروتها فيتوجّه بالكلام إلى والد شهيد:
الوطن شبيه بعرائس البحر العتيقة
التي كانت أصواتها تضيع البحّارة.
الوطن يجحد الأغنيات: لكن نحيبه الإلهي
يلهم النفس رغبة النخل السيّد
نواقيس الخطر تقرع في فجرنا الهادئ الصافي
الحرائق تبهر البراري والبحار
فيما فرنسا في ثوب الحداد تلثم العيون المغمضة،
عيون شباب في ربيع العمر هلكوا في حلبات النزال الحمراء
أيها الأب الذي بقي وحيدا في عزّ المساء
نيسان ابنك، حمرة دمه
زهر سيورق على رايات الملحمة
ابنك اختار على شعاع السماء ونورها
الرقة الوحشية لرقدة الأبطال،
الرقدة الرميم في أرض حيث الأجداد ناموا.
إن تنوّع المصادر التي عرّفت بسكاليزي وتناولت أشعاره ومقالاته بالنقد يؤكّد في حدّ ذاته هذا الانتماء الحضاري المتعدّد. لقد كتب سكاليزي بالفرنسية لغة المستعمر. وكان من الطبيعي أن يعدّه النقد الفرنسي أحد الوجوه البارزة في الحركة الفكرية الفرنسية بتونس. وهذا ما ذهب إليه إيف شاتلان Yves Châtelain مثلا في كتابه الحياة الأدبية والفكرية بتونس بين 1900 و1937 (Vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937). ولكنه يذكره أيضا ضمن الصفحات المخصصة للحركة الفكرية الإيطالية، رغم أنه يفعل ذلك بهدف التركيز على هجرة الأقلام الإيطالية نحو التعبير باللغة الفرنسية كنتيجة للهيمنة الحضارية واللغوية للمستعمر الفرنسي.
ولأن سكاليزي من أصل إيطالي عمد غاسبار داغوانو Gaspare DAguanno إلى اعتباره شاعرا إيطاليا خالصا فكتب عنه دراسة مطولة بالفرنسية ونشرها بمدينة تراباني في صقلية مسقط رأس أب سكاليزي، فصارت مدينة تراباني تفاخر بسكاليزي وتحتفي به باعتباره أحد مواطنيها الذين أصبحوا مشهورين. وفي الوقت ذاته سيواصل المغرب العربي في دوريّاته تمسّكه بسكاليزي باعتباره ابن البيئة التونسية والناطق بآمال شعوب المغرب في التحرر والكرامة.
لذلك ستعتبر جمعية أدباء شمال أفريقيا أعمال سكاليزي جزءا من الموروث الثقافي التونسي، وتعدّه أمارة على وجود أدب قائم بذاته بالمغرب العربي، وشاهدا على ثراء الحياة الأدبية بتونس وتفردها في تلك المرحلة من تاريخها، لأن سكاليزي شاعر يجسد هذا التفرّد باعتبار أن أشعاره تكشف بعنف أبعاد هذه الهويّة المتعدّدة.
أما ماريو سكاليزي فإنه صنّف نفسه واختار عائلته حين وضع لديوانه عنوان ”قصائد شاعر ملعون“. وهو عنوان يشير صراحة إلى أنه يعتبر نفسه ملعونا لا بسبب الوشائج الروحية التي تربطه بالمدرسة الفرنسية للشعراء الملاعين، بل أيضا بسبب ارتباطه بالبؤس الذي وسم حياة المهاجرين الإيطاليين بتونس، وخاصة منهم القادمين من صقلية، وبسبب إقامته في بلاد تآمر الطغاة والغزاة على ناسها وغدها. ولهذا أيضا جاء العنوان الفرعي ”أشعار من غياهب الجحيم“ بمثابة إلحاح على أن الشاعر الحق إنما هو ذاك الذي يقاسم المغلوبين والمقهورين جحيمهم ولا يفرّ من المنازلة حتى إذا كان بإمكانه تحقيق خلاصه الفردي. لذلك سيلتصق سكاليزي بالمكان ولن يحدّث عن أمجاد العرب والمسلمين كما يحدّث الرومانسيون الغربيون الذين تعاملوا مع الشرق باعتباره موطن الخرافة والسحر وتدويخ الحواس وبلسم الإنسان الأوروبي الذي ضجر بعقلانية عصر الأنوار، بل سيتغنى بالمكان وبالمعمار الشرقي ويعتبر العرب حمالة حقيقة وبناة حضارة. يكتب في نص بعنوان ”الصومعات“:
أيتها الصومعات، بهاء أنت فوق الدكاكين
صرخة من حجر دافقة من قلب الشرق العظيم
أيتها الأبراج البيضاء
أنت مثل حراس من المتصوّفة ترقبين
رعشة الأمل في قلب السماء الضحوك
منارات أنت نورها قُـدَّ من صلوات
منارات تشعّ التقوى فيها مثل بيت طهور
من بعيد ترسمين في وجه القادمين من السماء
محيط اللازورد
الدرب السالكة للأرض
كم أهوى أن أراك منتصبة قبالة المغيب وهو يحترق
مثل حرّاس مدينة من ذهب
كم أهوى أن أراك في الأفق الرائع وقت المغيب
حين نحلم بحدائق يزهر فيها الموت والعدم.
نداء المؤذنين الذي يبلغ حتى مسامع الراقدين في القبور
يبدو كأنه سؤال تطرحينه على الأثير الأزرق
وحين الحمائم تأتي وتحطّ على أكتافك
توشوشك إجابة الله.
هجرات تتلوها هجرات. هكذا كانت حياة سكاليزي. فمنذ اللحظة التي هاجر فيها والداه من إيطاليا تلقفت الهجرة حياة ماريو سكاليزي وصارت قدرا ومصيرا. هاجر من الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية الإسلامية وعشقها. هاجر من لغته الإيطالية فكتب بالفرنسية وأتقنها. وكانت الهجرة الأخيرة مميتة فبعد عمر مليء بالأحزان مات سكاليزي يوم 31 مارس 1922 وهو في الثلاثين من عمره، في مشفى عقلي بمدينة باليرمو الايطالية، فريسة للسل والجنون.
طبعت مجموعة سكاليزي مرات عديدة. ظهرت المجموعة أولا سنة 1923 ضمن منشورات بال لاترBelles Lettres ، وسنة 1930 نشرتها الكاهنة، وسنة 1935 نشرتها سندباد. ونشرها سنة 1996 عبد الرزاق بنور في تونس وقدّم لها الإيطالي إيفون فرانكاسيتي بروندين. وقد احتوت هذه الطبعة الرابعة على كل قصائد سكاليزي باستثناء قصيدة واحدة، وهي سونيتة على الأرجح، لم يتم العثور عليها كاملة. وقد ذكر بعض معاصري سكاليزي هذه المقاطع منها:
لقد غذيتني من عقل حكمائك،
من لحمك، من دمك، من شمسك المحرقة،
آه، فرنسا! وحين لم يكن قلبي غير صفحات بيض،
ارتسم اسمك فوقها، ملتمعا بنار قرمزية.
………………………………………
أيها الظهور الأشقر، أعلم من أين يأتي هدوؤك،
من أعياد فصح السلام سيخضرّ جرحك
جرحك هو النبع الذي سيرتوي منه المستقبل.
يظل ماريو سكاليزي رمزا للشاعر الذي لم يختر قدره لكنه اختار أن ينازله حتى النهاية. وهو يعتبر الشعر هبة السماء. لكنه يعتبر الشاعر شخصا منذورا للخيانة الأفظع. فما من شاعر إلا وهو يحمل في ذاته ملمحا من ملامح يهوذا. غير أن الشاعر لا يخون الآخرين بل يغدر بنفسه لأنه ينشغل بالشعر على حساب العيش. يكتب في نص بعنوان ”يهوذا“:
هل تغفرين لي أيتها الورود الرقيقة
أيتها الزنابق، أيتها الزرقة البكر للسماء صيفا
هل تغفرين الجريمة البشعة التي أضمر إتيانها أحيانا
حين الكآبة تستبدّ بي وقشعريرة الرعب تهزّني هزّا
أنا شخصان: المغني صانع الأنغام الذي يعبر
هناك، في تلك الطريق العابقة بالأمجاد والمُثُل
ذاك الشاعر الجوال الذي تحوي عيناه الفضاءات جميعها
ذاك الذي يداه مثقلتان بأزهار فردوس البداية
ذاك أنا. لكن هذا الذي يقضي دهره محكوما بالأشغال الشاقة
هذا البائس التائه بين قطعان البشر
هذا الذي يمضي مطأطئ الرأس جبان القلب باحثا
في مستنقع الحياة عن كسرة خبز
هو أيضا أنا. غدا أو ربما هذا المساء
الناس الذين سأحبهم سيهبونني -ويا لشقوتي-
حتى أهجر الفنّ، أجرة الخائن
وبثلاثين فلسا سأبيع المغني.
مختارات من أشعار سكاليزي
أغنية
أيها الطفل الصغير، ابق نائما في قماطك
لا تفتح عينيك المدهوشتين
عينيك التي ألفت رؤية الملائكة
لا تفتحهما عينيك على عالم الملاعين عالمنا.
يا ابن البشر الأنجاس المناكيد
البشر المسطولين بحبّ الذهب حتى الشقاء
لتهدهدك أحلامك المقدودة من نسغ الورود
أيها الطفل الصغير، استمرّ في النوم.
إنا هنا لنألم حين يسرقون منا
بهجة الربيع القرمزي الوهّاج
أيها الطفل الصغير، فلتكن بسمتك
نداء الشمس فينا.
الديوان ص71
ثــورة
أمي منذ فجري الأول وأنا أكدح
الضنى قدري والضجر يكاد يفنيني
اطرحي من أجلي فستانك القديم
على البلاط.
البلاط لا يهب دفئا أبدا
والشتاء غضوب شرس! إنها تمطر الآن
يرتد النظر كسيرا قدّام الدياجير، هلاّ أوقدت لي
نارا؟
الماء البارد الذي أشربه يطفئ
عطشي، لكنه سعار في الحشى يوقظ جوعي
أمّي أما زالت عندك كسرة
خبز؟
لا خبز. لا نار. الحياة دياجير تكرّ
لعناتي عليها أصبّ ولا أملك غير اللعنات
إني لأسمع الأطفال في العتمة
ينوحون.
أختي أصغر أخواتي حين رأت شقوتي،
أختي ذات العينيين العذبتين،
قالت لي: ”هات يدك خذ بسرعة، ما في جيبي غير
فلسين“.
قالت ثانية في نبرة حنون:
”ماذا تريد أن أشتري لك أخي الأكبر
هل أشتري لك خبزا؟“ قلت: ”لا… بل
كأسا مترعة“.
الديوان، ص73-74
حفار القبور
رأيته بفأس حادة يحفر الأرض الصمّاء
رأيته حفار القبور الكئيب، الشيخ الأبدي
حطّمت طلعته الشقية مثل قبضة ثقيلة
شعاع الأمل الكريستالي في قاع روحي.
كيف يمكننا أن نعيش غير مبالين، أن نضحك
بينما يداه توسّعان تحت أقدامنا
الحفرة الباردة حيث الموت يستدرجنا
نحن الألى فقدنا الأمل في رحمة ما، في خلاص ما؟
……
كيف يمكننا أن نؤمن بالربيع، بالفجر،
بالأفق اللازوردي، بالشمس، بالأنهار، بالمستقبل؟
كيف يمكننا أن نظل سذّجا غافلين
حتى ننفق أيامنا في الزرع والتشييد؟
في حين يكفي أن نصيخ السمع قليلا صامتين
إلى الإيقاع الرتيب لدقّات قلوبنا
حتى نسمع ضربات فأس حفار القبور
تدوّي في وجيب الدمّ في قلوبنا.
شعر أبيض، ظهر أحدب، لكن قوّته ظلت خارقة
معطفه الأسود يلف الأمس ويلف الغد،
رأيته حفار القبور منتفخ الصدر يكدّ
مفتول العضلات لا يكلّ.
الحفرة التي كان يوسّعها بدت من عمقها هاوية
لا شيء في الدنيا يمكن أن يملأها إلا الكون كلّه.
كلّ الدروب في الدنيا ستنتهي إلى هذه الحفرة،
والناس الطيبون والأوغاد المارقون فيها سينتهون.
أجل ههنا ستسقط البشرية جمعاء، هذا نهر
من وجوه، نهر من أصوات، من أصابع ملتوية، نهر من قلوب،
والليل يهدهد جباهنا في حضن امرأة ثكلى،
والشمس مذبح تنزف على مدارجه دماؤنا،
رأيت الناس يعبرون، مجانين أوعقلاء،
رأيت الأطفال المأخوذين بالأمجاد والمسرّات،
النساء اللاتي تحلّين صدرياتهن بالورود،
النساء اللاتي تسمعن نداء العطر فتهبن من خيراتهن.
……
أموات المستقبل، الألى نفوسهم تتقي بكل طيش
تحذيرات أشجار السرو
أموات المستقبل يكادون لا يلمسون
على الطريق
آثار العبور الأبدي لمن كانوا أحياء في الماضي.
٭ ٭ ٭
الشكر لك يا إلهي، الشكر لك، أيها الإله الرحيم، الإله العادل جدّا،
يا من تقبض الأنفس جميعها.
شكرا لك فقد عجنت بيدك الطاهرة
زهرة أعوامي العشرين.
بفضلك وحدك سأستطيع أن أنزلق داخل الحفرة المعتمة
دون حسرة على نور النهار.
سأُزَفّ إلى الليل، وسأحيي ظلّ
قُبلتي الأولى.
لكن اسمح أن تجعل قلبي دمعة حمراء
اسمح أن أرفع الصوت عتابا
حين أسمع النشيد المخادع الذي يغذي
أمل المحكومين بالإعدام.
ملحمة الفقير
في سالف الأيام عندما كانت الأشعة الحمراء المنبعثة من المشاعل العملاقة
تنعكس مثل القبل على بلور الشبابيك الكريستالي ذي اللون النهدي،
كان البارونات المترفون يلتهمون في صالوناتهم
لحم الخنازير البرية التي اصطادوها في حقولي المزروعة قمحا.
كان أطفالي يجيبون بأنّات الجياع
على الترانيم المنبعثة من الشفاه المخمورة
على ضحكات المهرّجين … على اعترافات النساء العاشقات العطرة.
كان أطفالي يجيبونهم بأنّات الجياع مثل كلاب ضائعة تعوي عواء مريرا في الغابات.
حين كنت ضجرا من التضرّع للأفق اللازوردي، متهالكا على الأرض،
حين كنت أتوسّل الأرض كي تنشق وتبتلعني
خاطبني امرؤ قدم للتو من المعبد: ”أيْ بنيّ
تعلّم على الأقلّ أن تطلب المغفرة لذنوبك دون ضجّة أو أنين“.
أطلب المغفرة، أطلب المغفرة، أيّ جرم اقترفت يداي
هل تعكّر أنفاسي البائسة صفو السماء؟
أما صلّيت للسماء وسدّدت الدين كاملا؟
أما تعرّيت حملا وديعا كي أزيد سدنة المعبد ثراء على ثراء؟
مرّة أحدّث نفسي هكذا: ”إلهي، سيّد الدنيا والعالمين
سيّد لآلئ السماوات وكنوز البحار
ما الذي يجنيه من كل هذا الذهب الذي رصّعت به المعابد
لماذا يحرم أبناءه البررة، لماذا يحرم قرّة عينه؟“
وأحيانا أحدّث نفسي قائلا: ”أَعدلٌ ما يجري،
أعدل أن يرتدي المرء أسمالا رثّة وينعم غيره في الدمقس وفي الحرير؟
أليس من أجل البشر أجمعين تمنح الطبيعة
حبّا، وسنابل وصباحات مشرقة؟“
ذات مساء كانت ذئاب ضخمة هزيلة تدور من حولي
وريح حاصب صرصر تدوي كأنها تذكّرني
بأن خدم البارونات بضحكاتهم الصفراء
قد فرغوا للتو من اختطاف ابنتي والعبث بشرفها.
ذاك المساء حين كنت أتهاوى ساقطا تحت نير رزيتي وشقائي
ذاك المساء حين عيناي استعادتا واحدا واحدا
أيّامي الخوالي، أيامي التي تشبه حبّات مسبحة سوداء
ذاك المساء بعطرها الوحشي الضغينة تعتعتني.
الثورة المتوقّدة في روحي المتحفّزة
علّمتني أن السعادة وقف على الأقوياء
ومن الغروب الغارق في بحر دماء وصهاريج ذهب
أُلهمتُ الجريمة والحرائق.
في تلك الساعة تحت الأشعة المسائية الحمراء:
جمّعت أولادي، آلافا آلافا،
أفواجا أفوجا يمّمنا، مثل جدار مرصوص، صوب برج الإقطاعي
خَبباً سرنا عبر المروج الكليلة ذات الأخاديد الأليفة.
منّينا النفس بأن نرد النبع الأحلى: الحرية
نبع يشبه خمرة جديدة قرمزية
منينا النفس بإبطال بالعصيان الأبدي، إبطال الضرائب كلها، كسر سلاسل العبيد
منينا النفس بأن نرفع عاليا حقّنا في نور الشمس.
لكن الفرسان ذوي الطلعات البهيّة والمتاريس المنيعة
واجهوا عصيّنا بأسلحة فتّاكة
وأثخنوا بجراح لا تشفى
صدورنا العارية المدماة والمكدودة بالنحيب.
هكذا فزنا بالجمال الذي يكسو الضحيّة،
وهكذا عمّقت النصال الأخاديد فوق جباهنا
في حين كانت جثث الكادحين العظماء المسجّاة
تملأ بالبهجة قلوب رهط البارونات.
ها أن جاك بونوم يصرخ: ”سيدفع ثمن ما اقترفت يداه! “
هكذا صوّت إعصار الفولاذ ذاك.
طويلا رافقني جزعي من تلك الصرخات…
وحين انهزمنا رجعنا إلى الجحيم.
وبظهر محنيّ عدت إلى الزراعة
هناك، حيث سكّة المحراث تنبش قبور الشهداء المعدمين.
دموع المسيح، دموع عامّة الناس،
كانت تتلألأ في عيوني المثقلة بالذكريات.
وعشت سنينا طوالا، مئات السنين الطوال،
سليبا، خاضعا،
وكلّ يوم يمرّ يعمّق أغلالي
ويمرّر فوق جسدي خيول عربات الملوك.
رغم أن الكل يعرف أنه لو أغار معتد على سهول بلادي
لنادتني البنادق والمدافع مدوّية فوق القلاع
لأن الكلّ يعلم أن الدم المتدفّق في عروقي
دم غير فاسد، دم أحمر، دم الأقوياء.
الجشع، الكِـبْـر، البذخ، التّهتّك،
جاذبيّة السماوات الغريبة والمدائن الغريبة
يا وطني، يا وطني اللاجئ في قلبي
لم تبدّل أبدا فخارَك العنيد.
وحدهم، أيتها الأم العتيقة، أيتها الأم القديسة، وحدهم يقدرون على حبّك
أولئك الذين لبساطتهم وعوزهم،
لا يملكون من عزاء على مرارة أيامهم
سوى أحلامك الخريفية وضحكاتك الصيفية.
رجال، أزواج، عرقهم المهيب يُخصب أحشاءك وحناياك
رجال، أزواج، يصيخون السمع إليك، تقولين حين تخلدين إلى السكينة:
”إني لمشدودة إليكم شدّا بحقّ الخبز الذي بذرتم حبّاته
وأنتم مشدودون إليّ شدّا بحقّ السرير المهيب، القبر هو السرير“.
وفي النهاية، حين تخلّيتُ عن أمل كالسراب
عاليا رفعت سلاحي من جديد، حين الحرية
وقد حملت فجأة مشعل أمريكا،
أنارت أحلك دياجير ليلي.
سلالتي وقد تفتّقت في مختلف درجات الأسود
عادلتْ في دفقها هدير المحيطات.
أنا، هذا الذي لم يعرف غير الظل والعبودية
ها أني أنصب للشمس مائدتي، مائدة العملاق.
ومثل مركب صريرُ ألواحه يزعزع هيكلُه
تحت ضربات الأمواه الهائجة ورياح الشتاءات
تُسمَع صرخات الطبيعة الصبور
حين قبضتي المعروقة تعيد تشكيل العالم.
كانت تلك بهجة عظيمة تلت صوما طويلا
كنت قد صرت بدوري ملكا، العين صارخة، والكلمة عالية
اخترت الأرجوان الأعظم عرشا
أرجوان الدم ذاته، الدم الذي يكسو المقصلة.
كنت قد صرت النسر النشوان بالفضاءات المشرقة
كانت جناحاي تحملانني أعلى علّيين
كنت أتشرّب الأثير من تحليقي النهم
حين أردتني رصاصة صياد غادر.
وقتها، أفقت من حلمي البهيّ.
كان دمي قد سُفك من أجل مصالح الآخرين.
كان آخرون غيري قد ثمّنوا ذهب قوّتي، قوّتي الخلّب العابرة
حين كبّلوني بأصفاد دبّرت في الليالي الداجية.
بعد شمس أشرقت طويلا يصير الظلّ أكثر عتمة وسوادا.
النهار! النهار ثانية! سيدي ومولاي الجديد
لا يملك، كي يبهرني، سراب أمجاد
ولا يملك، ليُحني جبيني، قفّاز زرد فولاذي.
سيدي هو ذاك الذي يسنده عجل من ذهب.
وسواء كنت كادحا أو تاجرا، حدّادا أو عاملا في منجم،
سأظلّ على الدوام القنّ الحزين، القنّ المشؤوم
ذاك الذي يأكل الخبز الأسود مغموسا في العرق.
وفي حين كنت أرزح تحت وقع فاقتي
كانت ثريّات الكريستال المطعّم بالذهب والمسرّات
تضيء تحت عيني الولائم والرقصات:
الكراهية من يومها صارت لذّتي الوحيدة.
متى يأتي يوم يلتمع فيه نجمي، ومتى يغيب
عن ناظري مشهد أفقي وهو يسود بالكواسر،
مشهد أولادي يموتون جوعا، في الأوحال أو الثلوج
ومشهد بناتي يسقن إلى زوايا الطرقات حيث يتم بيعهن؟
أيها المموّلون الشرهون، وأنت، أيّتها الحوريّات الباردات
اللواتي تضفين نقاء جبينكن الساطع على المنكرات جميعها،
لأكسرنّ أسنانكم بكؤوسكم الملأى،
ولأرمينّ الصواعق إلى قلب سمائكم!
لأنني، أيها الشعب، أحفظ
في ذاتي المتعذّر سبر غورها
الذكرى الملتهبة للكلمات التي قدّت من نار،
أنا الإيمان، أنا القوّة، والعدد، والفكرة،
أنا، بفضل عملي الدؤوب، شبه إله!
داخل هذا العرين السري الذي نما فيه غضبي،
أمزج في قلبي الشعلة والفولاذ،
وأدرك أنني أنا الذي ظللت مقموعا لأحقاب،
سأصبح، أيها الحكّام، المنصف الأخير.
سأحكمكم بالفأس والهراوة،
وسأحكمكم بالرعب والقرف الباعث على الغثيان،
سآتيكم، بكلّ الوسخ الذي حمّلنيه عملي العتيق،
سأجلس إلى مائدتكم
مثقلا بكوارثي ومصائبي.
سأخرج من أحشاء الحقول والمدن
أفواج كلّ المجوّعين الذين أكلوا ملوكا.
حتى أُعلي كلمة الكتاب المقدّس الجديد،
أيّها المجتمع المعتم، ها أننا ننصب لك صليبا، ونعلقك عليه.