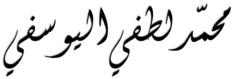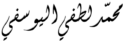في أواسط القرن العشرين اهتمّ علماء الأنثربولوجيا في العالم بالحكايات الشعبية التي ابتدعها القصّاص الجوّالون وعدّوها فنّا يوسّع من دائرة المعنى ويلبّي الحاجة إلى الجميل لدى عامة الناس. وعُدّ القاصّ الجوّال من كبار المبدعين. فهو يقصّ حكايات مبتدعة لا يعتمد فيها إلاّ على معارفه وخياله وقدرته الفائقة على الارتجال. والحكايات الشعبية تشهد بأن فعل الحكي يستمدّ مضاءه ممّا ينبني عليه من تعجيب. فالقاصّ إنما يحرص على توشية حكاياته بالعجيب ليقوم بتوسيع دائرة الحلم ومجاله، ويشرع في تحطيم الحدود الفاصلة بين المرئي المُشاهد في الأعيان، وغير المرئي الذي لا يُدرك إلا بالتوهّم وعلى سبيل التخيّل. وبذلك تنفتح الكتابة على المهيب الذي يثير الفتنة والخوف في آن معا. فالشخصيات كثيرا ما تكون واقعية ومفارقة في الآن نفسه. أما الأحداث فكثيرا ما تكون مهيبة، لأن المهيب هو ما يحرص النصّ على ابتنائه حتى يخرج بالمتلقّي من دوره السلبي ويدرجه في الحكاية ويزجّ به في أحداثها، فيجري على المدركات المتعارفة نوعا من التحويل ويحيطها بهالة من الإغراب تجعل تمثّلها شبه مستحيل ليجتذب خيال السامعين إلى النهايات والأقاصي.

هذا القاصّ الجوّال حاضر في كل الثقافات. وهو يدعى في أفريقيا ”الغريتاس“ ويدعى عند اليابانيين ”الغايشاس“. أما الأرمن فسمّوه ”الغوساني“ وحبوه، كغيرهم، بالتبجيل. وقديما سمّاه العرب ”القاصّ“؛ وسمّي اليوم ”الحكواتي“. حيثما وجد تجمّع بشري انبثقت الحاجة إلى هذا القاصّ الجوّال؛ لاسيما أنه يطرح كنوزه في الأماكن العامة والفضاءات الحميمة. وهو يسهم، بحكاياته، في توطيد النسيج الاجتماعي. إن وظيفته الاجتماعية وظيفة جمالية بامتياز. ذلك أن الحكاية التي يبتدعها مبنيّة وفق نسق يجعل منها طقسا جماعيا. فهو كثيرا ما يستند إلى حكاية مرجعية متعارفة (الظاهر بيبرس، تغريبة بني هلال، عنترة…) ويقوم بإثرائها وفتحها على ممكناتها. وبذلك تصبح الحكاية نصّا مفتوحا بإمكان الأجيال المتعاقبة أن تسهم في إثرائه. ويصبح فعل التذكّر لدى القاصّ ومستمعيه حدثا مفتوحا على المحتمل والممكن. وبالممكن والمحتمل تمعن الحكاية في تجديد نفسها وتنفتح على الأزمنة جميعها. إنها طقس جماعيّ، طقس ما يفتأ يتمّ لمقاومة النسيان. لذلك لم تحتفظ الذاكرة بأسماء هؤلاء القصّاص الجوّالة. احتفظت بالحكايات ووسّعت من دائرة سفرها وانتشارها. وفي حين يحرص القاصّ الذي يكتب كتابا أو يؤلّف رواية على تثبيت اسمه على الغلاف لإثبات الملكية، يعمد القاصّ الجوّال إلى التخفّي والغياب ليمنح الحكاية كلّ أمجادها. ولا أحد من هؤلاء القصّاص تباهى، عبر التاريخ، بأنه هو الذي ألـّف هذه الحكاية أو تلك. وحدها الذاكرة الجماعية المترامية حدودها فوق كلّ حدود، هي التي ضمنت للحكايات أن تحيا على الدوام. وإنه لأمر محيّر مذهل أن لا تتلفّت الجامعات ومراكز الأبحاث العربية إلى هذا الفنّ المطروح على قارعة الطريق يصرخ في ليل وجودنا منتظرا أن نصغي إليه ونستكشف جمالياته.

في أواسط القرن العشرين اهتمّ علماء الأنثربولوجيا في العالم بالحكايات الشعبية التي ابتدعها القصّاص الجوّالون وعدّوها فنّا يوسّع من دائرة المعنى ويلبّي الحاجة إلى الجميل لدى عامة الناس. وعُدّ القاصّ الجوّال من كبار المبدعين. فهو يقصّ حكايات مبتدعة لا يعتمد فيها إلاّ على معارفه وخياله وقدرته الفائقة على الارتجال. والحكايات الشعبية تشهد بأن فعل الحكي يستمدّ مضاءه ممّا ينبني عليه من تعجيب. فالقاصّ إنما يحرص على توشية حكاياته بالعجيب ليقوم بتوسيع دائرة الحلم ومجاله، ويشرع في تحطيم الحدود الفاصلة بين المرئي المُشاهد في الأعيان، وغير المرئي الذي لا يُدرك إلا بالتوهّم وعلى سبيل التخيّل. وبذلك تنفتح الكتابة على المهيب الذي يثير الفتنة والخوف في آن معا. فالشخصيات كثيرا ما تكون واقعية ومفارقة في الآن نفسه. أما الأحداث فكثيرا ما تكون مهيبة، لأن المهيب هو ما يحرص النصّ على ابتنائه حتى يخرج بالمتلقّي من دوره السلبي ويدرجه في الحكاية ويزجّ به في أحداثها، فيجري على المدركات المتعارفة نوعا من التحويل ويحيطها بهالة من الإغراب تجعل تمثّلها شبه مستحيل ليجتذب خيال السامعين إلى النهايات والأقاصي.

هذا القاصّ الجوّال حاضر في كل الثقافات. وهو يدعى في أفريقيا ”الغريتاس“ ويدعى عند اليابانيين ”الغايشاس“. أما الأرمن فسمّوه ”الغوساني“ وحبوه، كغيرهم، بالتبجيل. وقديما سمّاه العرب ”القاصّ“؛ وسمّي اليوم ”الحكواتي“. حيثما وجد تجمّع بشري انبثقت الحاجة إلى هذا القاصّ الجوّال؛ لاسيما أنه يطرح كنوزه في الأماكن العامة والفضاءات الحميمة. وهو يسهم، بحكاياته، في توطيد النسيج الاجتماعي. إن وظيفته الاجتماعية وظيفة جمالية بامتياز. ذلك أن الحكاية التي يبتدعها مبنيّة وفق نسق يجعل منها طقسا جماعيا. فهو كثيرا ما يستند إلى حكاية مرجعية متعارفة (الظاهر بيبرس، تغريبة بني هلال، عنترة…) ويقوم بإثرائها وفتحها على ممكناتها. وبذلك تصبح الحكاية نصّا مفتوحا بإمكان الأجيال المتعاقبة أن تسهم في إثرائه. ويصبح فعل التذكّر لدى القاصّ ومستمعيه حدثا مفتوحا على المحتمل والممكن. وبالممكن والمحتمل تمعن الحكاية في تجديد نفسها وتنفتح على الأزمنة جميعها. إنها طقس جماعيّ، طقس ما يفتأ يتمّ لمقاومة النسيان. لذلك لم تحتفظ الذاكرة بأسماء هؤلاء القصّاص الجوّالة. احتفظت بالحكايات ووسّعت من دائرة سفرها وانتشارها. وفي حين يحرص القاصّ الذي يكتب كتابا أو يؤلّف رواية على تثبيت اسمه على الغلاف لإثبات الملكية، يعمد القاصّ الجوّال إلى التخفّي والغياب ليمنح الحكاية كلّ أمجادها. ولا أحد من هؤلاء القصّاص تباهى، عبر التاريخ، بأنه هو الذي ألـّف هذه الحكاية أو تلك. وحدها الذاكرة الجماعية المترامية حدودها فوق كلّ حدود، هي التي ضمنت للحكايات أن تحيا على الدوام. وإنه لأمر محيّر مذهل أن لا تتلفّت الجامعات ومراكز الأبحاث العربية إلى هذا الفنّ المطروح على قارعة الطريق يصرخ في ليل وجودنا منتظرا أن نصغي إليه ونستكشف جمالياته.
في أواسط القرن العشرين اهتمّ علماء الأنثربولوجيا في العالم بالحكايات الشعبية التي ابتدعها القصّاص الجوّالون وعدّوها فنّا يوسّع من دائرة المعنى ويلبّي الحاجة إلى الجميل لدى عامة الناس. وعُدّ القاصّ الجوّال من كبار المبدعين. فهو يقصّ حكايات مبتدعة لا يعتمد فيها إلاّ على معارفه وخياله وقدرته الفائقة على الارتجال. والحكايات الشعبية تشهد بأن فعل الحكي يستمدّ مضاءه ممّا ينبني عليه من تعجيب. فالقاصّ إنما يحرص على توشية حكاياته بالعجيب ليقوم بتوسيع دائرة الحلم ومجاله، ويشرع في تحطيم الحدود الفاصلة بين المرئي المُشاهد في الأعيان، وغير المرئي الذي لا يُدرك إلا بالتوهّم وعلى سبيل التخيّل. وبذلك تنفتح الكتابة على المهيب الذي يثير الفتنة والخوف في آن معا. فالشخصيات كثيرا ما تكون واقعية ومفارقة في الآن نفسه. أما الأحداث فكثيرا ما تكون مهيبة، لأن المهيب هو ما يحرص النصّ على ابتنائه حتى يخرج بالمتلقّي من دوره السلبي ويدرجه في الحكاية ويزجّ به في أحداثها، فيجري على المدركات المتعارفة نوعا من التحويل ويحيطها بهالة من الإغراب تجعل تمثّلها شبه مستحيل ليجتذب خيال السامعين إلى النهايات والأقاصي.


هذا القاصّ الجوّال حاضر في كل الثقافات. وهو يدعى في أفريقيا ”الغريتاس“ ويدعى عند اليابانيين ”الغايشاس“. أما الأرمن فسمّوه ”الغوساني“ وحبوه، كغيرهم، بالتبجيل. وقديما سمّاه العرب ”القاصّ“؛ وسمّي اليوم ”الحكواتي“. حيثما وجد تجمّع بشري انبثقت الحاجة إلى هذا القاصّ الجوّال؛ لاسيما أنه يطرح كنوزه في الأماكن العامة والفضاءات الحميمة. وهو يسهم، بحكاياته، في توطيد النسيج الاجتماعي. إن وظيفته الاجتماعية وظيفة جمالية بامتياز. ذلك أن الحكاية التي يبتدعها مبنيّة وفق نسق يجعل منها طقسا جماعيا. فهو كثيرا ما يستند إلى حكاية مرجعية متعارفة (الظاهر بيبرس، تغريبة بني هلال، عنترة…) ويقوم بإثرائها وفتحها على ممكناتها. وبذلك تصبح الحكاية نصّا مفتوحا بإمكان الأجيال المتعاقبة أن تسهم في إثرائه. ويصبح فعل التذكّر لدى القاصّ ومستمعيه حدثا مفتوحا على المحتمل والممكن. وبالممكن والمحتمل تمعن الحكاية في تجديد نفسها وتنفتح على الأزمنة جميعها. إنها طقس جماعيّ، طقس ما يفتأ يتمّ لمقاومة النسيان. لذلك لم تحتفظ الذاكرة بأسماء هؤلاء القصّاص الجوّالة. احتفظت بالحكايات ووسّعت من دائرة سفرها وانتشارها. وفي حين يحرص القاصّ الذي يكتب كتابا أو يؤلّف رواية على تثبيت اسمه على الغلاف لإثبات الملكية، يعمد القاصّ الجوّال إلى التخفّي والغياب ليمنح الحكاية كلّ أمجادها. ولا أحد من هؤلاء القصّاص تباهى، عبر التاريخ، بأنه هو الذي ألـّف هذه الحكاية أو تلك. وحدها الذاكرة الجماعية المترامية حدودها فوق كلّ حدود، هي التي ضمنت للحكايات أن تحيا على الدوام. وإنه لأمر محيّر مذهل أن لا تتلفّت الجامعات ومراكز الأبحاث العربية إلى هذا الفنّ المطروح على قارعة الطريق يصرخ في ليل وجودنا منتظرا أن نصغي إليه ونستكشف جمالياته.
محمد لطفي اليوسفي
في أواسط القرن العشرين اهتمّ علماء الأنثربولوجيا في العالم بالحكايات الشعبية التي ابتدعها القصّاص الجوّالون وعدّوها فنّا يوسّع من دائرة المعنى ويلبّي الحاجة إلى الجميل لدى عامة الناس. وعُدّ القاصّ الجوّال من كبار المبدعين. فهو يقصّ حكايات مبتدعة لا يعتمد فيها إلاّ على معارفه وخياله وقدرته الفائقة على الارتجال. والحكايات الشعبية تشهد بأن فعل الحكي يستمدّ مضاءه ممّا ينبني عليه من تعجيب. فالقاصّ إنما يحرص على توشية حكاياته بالعجيب ليقوم بتوسيع دائرة الحلم ومجاله، ويشرع في تحطيم الحدود الفاصلة بين المرئي المُشاهد في الأعيان، وغير المرئي الذي لا يُدرك إلا بالتوهّم وعلى سبيل التخيّل. وبذلك تنفتح الكتابة على المهيب الذي يثير الفتنة والخوف في آن معا. فالشخصيات كثيرا ما تكون واقعية ومفارقة في الآن نفسه. أما الأحداث فكثيرا ما تكون مهيبة، لأن المهيب هو ما يحرص النصّ على ابتنائه حتى يخرج بالمتلقّي من دوره السلبي ويدرجه في الحكاية ويزجّ به في أحداثها، فيجري على المدركات المتعارفة نوعا من التحويل ويحيطها بهالة من الإغراب تجعل تمثّلها شبه مستحيل ليجتذب خيال السامعين إلى النهايات والأقاصي.


هذا القاصّ الجوّال حاضر في كل الثقافات. وهو يدعى في أفريقيا ”الغريتاس“ ويدعى عند اليابانيين ”الغايشاس“. أما الأرمن فسمّوه ”الغوساني“ وحبوه، كغيرهم، بالتبجيل. وقديما سمّاه العرب ”القاصّ“؛ وسمّي اليوم ”الحكواتي“. حيثما وجد تجمّع بشري انبثقت الحاجة إلى هذا القاصّ الجوّال؛ لاسيما أنه يطرح كنوزه في الأماكن العامة والفضاءات الحميمة. وهو يسهم، بحكاياته، في توطيد النسيج الاجتماعي. إن وظيفته الاجتماعية وظيفة جمالية بامتياز. ذلك أن الحكاية التي يبتدعها مبنيّة وفق نسق يجعل منها طقسا جماعيا. فهو كثيرا ما يستند إلى حكاية مرجعية متعارفة (الظاهر بيبرس، تغريبة بني هلال، عنترة…) ويقوم بإثرائها وفتحها على ممكناتها. وبذلك تصبح الحكاية نصّا مفتوحا بإمكان الأجيال المتعاقبة أن تسهم في إثرائه. ويصبح فعل التذكّر لدى القاصّ ومستمعيه حدثا مفتوحا على المحتمل والممكن. وبالممكن والمحتمل تمعن الحكاية في تجديد نفسها وتنفتح على الأزمنة جميعها. إنها طقس جماعيّ، طقس ما يفتأ يتمّ لمقاومة النسيان. لذلك لم تحتفظ الذاكرة بأسماء هؤلاء القصّاص الجوّالة. احتفظت بالحكايات ووسّعت من دائرة سفرها وانتشارها. وفي حين يحرص القاصّ الذي يكتب كتابا أو يؤلّف رواية على تثبيت اسمه على الغلاف لإثبات الملكية، يعمد القاصّ الجوّال إلى التخفّي والغياب ليمنح الحكاية كلّ أمجادها. ولا أحد من هؤلاء القصّاص تباهى، عبر التاريخ، بأنه هو الذي ألـّف هذه الحكاية أو تلك. وحدها الذاكرة الجماعية المترامية حدودها فوق كلّ حدود، هي التي ضمنت للحكايات أن تحيا على الدوام. وإنه لأمر محيّر مذهل أن لا تتلفّت الجامعات ومراكز الأبحاث العربية إلى هذا الفنّ المطروح على قارعة الطريق يصرخ في ليل وجودنا منتظرا أن نصغي إليه ونستكشف جمالياته.