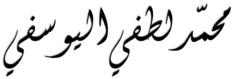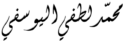حين تحدّث أرسطو في كتابه “فن الشعر” عن الأجناس الأدبية فرّق بين الشعر الدرامي والشعر الغنائي، وأولى عناية فائقة للصنف الدرامي. أما الشعر الغنائي فسكت عنه لأن منتجَه أقل درجة من منتج الأشعار الدرامية، لا سيما أن الشاعر الذي يكتب قصيدة غنائية إنما يبرع في توليد المجازات والاستعارات لا غير. أما الشاعر الذي يكتب شعراً درامياً فإنه يبرع في صناعة الحكايات التي ينجزها “أشخاص فاعلون هم الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر” ويدخلهم في صراع درامي مرير من شأنه أن يولّد لدى المتلقي انفعالي الشفقة والخوف، ويؤدّي إلى التطهير منهما في الآن نفسه.ا
لهذا كله فصل أرسطو بين المأساة والملحمة والشعر الغنائي جازماً بأن المأساة جنس درامي يتولّى القول والفعل فيه الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر. أما الملحمة فيتولى القول فيها الشاعر حيناً، والأشخاص الذين يخلقهم حيناً آخر. في حين أن الشعر الغنائي إنما يرد على لسان منتجه فهو الذي يتولّى القول، ولا وجود فيه لحكاية وأشخاص فاعلين يتولون الفعل والقول.ا
لذلك حين نقوم بتحديد مفهوم الغنائية وضبط الفوارق بين الشعر الغنائي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، قصد رصد التحولات التي طرأت على الشعر الغنائي نتيجة التنافس بين الأجناس الأدبية، ندرك أن مفهوم القصيدة الغنائية في الثقافة العربية مفهوم مُضلّل بالتمام والكلية. بل إنه مفهوم يحجب أكثر مما يكشف. وهذا يعني أن الخطاب النقدي العربي المعاصر ظل يتعامل مع الشعر من خارجه ويتبنّى التصنيفات القديمة دون أن يقع التفطن إلى أن القصيدة التي توصف بكونها غنائية قد أثْرَتْ نفسها بمنجزات العديد من الأجناس الأدبية والفنون والمعارف. لقد استفادت من التقنيات الروائية ومن السرد بصفة عامة. اغتذت ببعض التقنيات السينيمائية، واستلهمت المسرح أيضاً. وهي إنما تستمدّ شعريتها من تخطّيها لمفهوم الغنائية.ا
يكفي هنا مثلاً أن نتلفّت إلى تجربة محمود درويش، وهي تجربة كثيراً ما توصف بأنها تجربة غنائية محض، وسيتبيّن أن نعت هذه التجربة بكونها تندرج ضمن النمط الغنائي إنما يمثّل إفقاراً لمنجزات صاحبها وحجباً لثراء تجربته. يكفي أن نعيد مساءلة قصيدة درويش وسنجد أنفسنا مرغمين على الاعتراف بالفضل لشاعر مضى مع الإيقاع حتى حتفه. إن قصيدة درويش قد عصفت بالحدود والضفاف الفاصلة بين الأجناس الأدبية وتمكّنت من فتح آفاق لا عهد للشعر العربي بمثلها. لقد تمكنت من ابتناء قاعها الأسطوري وأثْرَتْ نفسها بالعناصر الدرامية فتخطّت الغنائية. وعمدت أحياناً أخرى إلى التوغل داخل رحاب معرفية، بموجبها، تماهي الشعري مع الفكري والمعرفي، وانفتح الشعر على الفلسفة وأسئلة الوجود، وكفّت الكتابة عن كونها مجرد إنشاء وتمرّس بالكلام لتصبح فعل وجود. ومعنى كونها فعل وجود أنها تنهض لتنازل قدراً لم يختره الشاعر لكنه اختار أن ينازله ويواجه عدمه الخاص.ا


حين تحدّث أرسطو في كتابه “فن الشعر” عن الأجناس الأدبية فرّق بين الشعر الدرامي والشعر الغنائي، وأولى عناية فائقة للصنف الدرامي. أما الشعر الغنائي فسكت عنه لأن منتجَه أقل درجة من منتج الأشعار الدرامية، لا سيما أن الشاعر الذي يكتب قصيدة غنائية إنما يبرع في توليد المجازات والاستعارات لا غير. أما الشاعر الذي يكتب شعراً درامياً فإنه يبرع في صناعة الحكايات التي ينجزها “أشخاص فاعلون هم الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر” ويدخلهم في صراع درامي مرير من شأنه أن يولّد لدى المتلقي انفعالي الشفقة والخوف، ويؤدّي إلى التطهير منهما في الآن نفسه.ا
لهذا كله فصل أرسطو بين المأساة والملحمة والشعر الغنائي جازماً بأن المأساة جنس درامي يتولّى القول والفعل فيه الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر. أما الملحمة فيتولى القول فيها الشاعر حيناً، والأشخاص الذين يخلقهم حيناً آخر. في حين أن الشعر الغنائي إنما يرد على لسان منتجه فهو الذي يتولّى القول، ولا وجود فيه لحكاية وأشخاص فاعلين يتولون الفعل والقول.ا
لذلك حين نقوم بتحديد مفهوم الغنائية وضبط الفوارق بين الشعر الغنائي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، قصد رصد التحولات التي طرأت على الشعر الغنائي نتيجة التنافس بين الأجناس الأدبية، ندرك أن مفهوم القصيدة الغنائية في الثقافة العربية مفهوم مُضلّل بالتمام والكلية. بل إنه مفهوم يحجب أكثر مما يكشف. وهذا يعني أن الخطاب النقدي العربي المعاصر ظل يتعامل مع الشعر من خارجه ويتبنّى التصنيفات القديمة دون أن يقع التفطن إلى أن القصيدة التي توصف بكونها غنائية قد أثْرَتْ نفسها بمنجزات العديد من الأجناس الأدبية والفنون والمعارف. لقد استفادت من التقنيات الروائية ومن السرد بصفة عامة. اغتذت ببعض التقنيات السينيمائية، واستلهمت المسرح أيضاً. وهي إنما تستمدّ شعريتها من تخطّيها لمفهوم الغنائية.ا

يكفي هنا مثلاً أن نتلفّت إلى تجربة محمود درويش، وهي تجربة كثيراً ما توصف بأنها تجربة غنائية محض، وسيتبيّن أن نعت هذه التجربة بكونها تندرج ضمن النمط الغنائي إنما يمثّل إفقاراً لمنجزات صاحبها وحجباً لثراء تجربته. يكفي أن نعيد مساءلة قصيدة درويش وسنجد أنفسنا مرغمين على الاعتراف بالفضل لشاعر مضى مع الإيقاع حتى حتفه. إن قصيدة درويش قد عصفت بالحدود والضفاف الفاصلة بين الأجناس الأدبية وتمكّنت من فتح آفاق لا عهد للشعر العربي بمثلها. لقد تمكنت من ابتناء قاعها الأسطوري وأثْرَتْ نفسها بالعناصر الدرامية فتخطّت الغنائية. وعمدت أحياناً أخرى إلى التوغل داخل رحاب معرفية، بموجبها، تماهي الشعري مع الفكري والمعرفي، وانفتح الشعر على الفلسفة وأسئلة الوجود، وكفّت الكتابة عن كونها مجرد إنشاء وتمرّس بالكلام لتصبح فعل وجود. ومعنى كونها فعل وجود أنها تنهض لتنازل قدراً لم يختره الشاعر لكنه اختار أن ينازله ويواجه عدمه الخاص.ا

حين تحدّث أرسطو في كتابه “فن الشعر” عن الأجناس الأدبية فرّق بين الشعر الدرامي والشعر الغنائي، وأولى عناية فائقة للصنف الدرامي. أما الشعر الغنائي فسكت عنه لأن منتجَه أقل درجة من منتج الأشعار الدرامية، لا سيما أن الشاعر الذي يكتب قصيدة غنائية إنما يبرع في توليد المجازات والاستعارات لا غير. أما الشاعر الذي يكتب شعراً درامياً فإنه يبرع في صناعة الحكايات التي ينجزها “أشخاص فاعلون هم الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر” ويدخلهم في صراع درامي مرير من شأنه أن يولّد لدى المتلقي انفعالي الشفقة والخوف، ويؤدّي إلى التطهير منهما في الآن نفسه.ا
لهذا كله فصل أرسطو بين المأساة والملحمة والشعر الغنائي جازماً بأن المأساة جنس درامي يتولّى القول والفعل فيه الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر. أما الملحمة فيتولى القول فيها الشاعر حيناً، والأشخاص الذين يخلقهم حيناً آخر. في حين أن الشعر الغنائي إنما يرد على لسان منتجه فهو الذي يتولّى القول، ولا وجود فيه لحكاية وأشخاص فاعلين يتولون الفعل والقول.ا
لذلك حين نقوم بتحديد مفهوم الغنائية وضبط الفوارق بين الشعر الغنائي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، قصد رصد التحولات التي طرأت على الشعر الغنائي نتيجة التنافس بين الأجناس الأدبية، ندرك أن مفهوم القصيدة الغنائية في الثقافة العربية مفهوم مُضلّل بالتمام والكلية. بل إنه مفهوم يحجب أكثر مما يكشف. وهذا يعني أن الخطاب النقدي العربي المعاصر ظل يتعامل مع الشعر من خارجه ويتبنّى التصنيفات القديمة دون أن يقع التفطن إلى أن القصيدة التي توصف بكونها غنائية قد أثْرَتْ نفسها بمنجزات العديد من الأجناس الأدبية والفنون والمعارف. لقد استفادت من التقنيات الروائية ومن السرد بصفة عامة. اغتذت ببعض التقنيات السينيمائية، واستلهمت المسرح أيضاً. وهي إنما تستمدّ شعريتها من تخطّيها لمفهوم الغنائية.ا
يكفي هنا مثلاً أن نتلفّت إلى تجربة محمود درويش، وهي تجربة كثيراً ما توصف بأنها تجربة غنائية محض، وسيتبيّن أن نعت هذه التجربة بكونها تندرج ضمن النمط الغنائي إنما يمثّل إفقاراً لمنجزات صاحبها وحجباً لثراء تجربته. يكفي أن نعيد مساءلة قصيدة درويش وسنجد أنفسنا مرغمين على الاعتراف بالفضل لشاعر مضى مع الإيقاع حتى حتفه. إن قصيدة درويش قد عصفت بالحدود والضفاف الفاصلة بين الأجناس الأدبية وتمكّنت من فتح آفاق لا عهد للشعر العربي بمثلها. لقد تمكنت من ابتناء قاعها الأسطوري وأثْرَتْ نفسها بالعناصر الدرامية فتخطّت الغنائية. وعمدت أحياناً أخرى إلى التوغل داخل رحاب معرفية، بموجبها، تماهي الشعري مع الفكري والمعرفي، وانفتح الشعر على الفلسفة وأسئلة الوجود، وكفّت الكتابة عن كونها مجرد إنشاء وتمرّس بالكلام لتصبح فعل وجود. ومعنى كونها فعل وجود أنها تنهض لتنازل قدراً لم يختره الشاعر لكنه اختار أن ينازله ويواجه عدمه الخاص.ا


حين تحدّث أرسطو في كتابه “فن الشعر” عن الأجناس الأدبية فرّق بين الشعر الدرامي والشعر الغنائي، وأولى عناية فائقة للصنف الدرامي. أما الشعر الغنائي فسكت عنه لأن منتجَه أقل درجة من منتج الأشعار الدرامية، لا سيما أن الشاعر الذي يكتب قصيدة غنائية إنما يبرع في توليد المجازات والاستعارات لا غير. أما الشاعر الذي يكتب شعراً درامياً فإنه يبرع في صناعة الحكايات التي ينجزها “أشخاص فاعلون هم الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر” ويدخلهم في صراع درامي مرير من شأنه أن يولّد لدى المتلقي انفعالي الشفقة والخوف، ويؤدّي إلى التطهير منهما في الآن نفسه.ا
لهذا كله فصل أرسطو بين المأساة والملحمة والشعر الغنائي جازماً بأن المأساة جنس درامي يتولّى القول والفعل فيه الأشخاص الذين يخلقهم الشاعر. أما الملحمة فيتولى القول فيها الشاعر حيناً، والأشخاص الذين يخلقهم حيناً آخر. في حين أن الشعر الغنائي إنما يرد على لسان منتجه فهو الذي يتولّى القول، ولا وجود فيه لحكاية وأشخاص فاعلين يتولون الفعل والقول.ا
لذلك حين نقوم بتحديد مفهوم الغنائية وضبط الفوارق بين الشعر الغنائي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، قصد رصد التحولات التي طرأت على الشعر الغنائي نتيجة التنافس بين الأجناس الأدبية، ندرك أن مفهوم القصيدة الغنائية في الثقافة العربية مفهوم مُضلّل بالتمام والكلية. بل إنه مفهوم يحجب أكثر مما يكشف. وهذا يعني أن الخطاب النقدي العربي المعاصر ظل يتعامل مع الشعر من خارجه ويتبنّى التصنيفات القديمة دون أن يقع التفطن إلى أن القصيدة التي توصف بكونها غنائية قد أثْرَتْ نفسها بمنجزات العديد من الأجناس الأدبية والفنون والمعارف. لقد استفادت من التقنيات الروائية ومن السرد بصفة عامة. اغتذت ببعض التقنيات السينيمائية، واستلهمت المسرح أيضاً. وهي إنما تستمدّ شعريتها من تخطّيها لمفهوم الغنائية.ا
يكفي هنا مثلاً أن نتلفّت إلى تجربة محمود درويش، وهي تجربة كثيراً ما توصف بأنها تجربة غنائية محض، وسيتبيّن أن نعت هذه التجربة بكونها تندرج ضمن النمط الغنائي إنما يمثّل إفقاراً لمنجزات صاحبها وحجباً لثراء تجربته. يكفي أن نعيد مساءلة قصيدة درويش وسنجد أنفسنا مرغمين على الاعتراف بالفضل لشاعر مضى مع الإيقاع حتى حتفه. إن قصيدة درويش قد عصفت بالحدود والضفاف الفاصلة بين الأجناس الأدبية وتمكّنت من فتح آفاق لا عهد للشعر العربي بمثلها. لقد تمكنت من ابتناء قاعها الأسطوري وأثْرَتْ نفسها بالعناصر الدرامية فتخطّت الغنائية. وعمدت أحياناً أخرى إلى التوغل داخل رحاب معرفية، بموجبها، تماهي الشعري مع الفكري والمعرفي، وانفتح الشعر على الفلسفة وأسئلة الوجود، وكفّت الكتابة عن كونها مجرد إنشاء وتمرّس بالكلام لتصبح فعل وجود. ومعنى كونها فعل وجود أنها تنهض لتنازل قدراً لم يختره الشاعر لكنه اختار أن ينازله ويواجه عدمه الخاص.ا