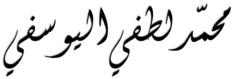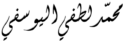ثمة في المتون العربية القديمة خوف من الكلام ومكائده وصل إلى حدّ تمجيد الصمت واعتباره فُلْك النجاة. والراجح أن الجاحظ حين افتتح كتاب ”البيان والتبيين“ قائلا: ”اللهمّ نعوذ بك من فتنة الكلام“ إنما صدر عن الوعي بأن الكلام بوّابة مشرعة على التهلكة والتيه والفتنة. على هذا الدرب سيسير التوحيدي أيضا ويجزم قائلا: ”إن الكلام صلف تيّاه.“ وسيصل الأمر بالخطابي البستي في ”كتاب العزلة“ إلى حدّ تمجيد العزلة باعتبارها إبطالا للكلام. يرجع هذا الخوف من الكلام إلى وعي حادّ بأن للكلمات مكرها. ولها مكائدها. وهو يرجع أيضا إلى الخوف من الفاتن والجميل. فالفاتن يفتن الإنسان عن نفسه ويستدرجه إلى مناطق غير المعقول والمجهول. بل إنه قد يستدرج الذات إلى مناطق اللاوعي حيث ترقد النزوات والأهواء في مدن الأعماق. لذلك كان لا بدّ من حراسة الخطاب ورسم حدوده وضفافه التي إن هو تعدّاها خرج إلى الفتنة. ولذلك أيضا أجمع المفكرون القدامى على أن الكلام يجب أن يجمع إلى الجميل النافع. فإذا عطّلت وظيفته النفعية خرج إلى الفتنة ولم يعد ينهض بوظيفته الاجتماعية في ”استدفاع المضار واستجلاب المنافع“ كما يحدثنا حازم القرطاجني.





محمد لطفي اليوسفي
ثمة في المتون العربية القديمة خوف من الكلام ومكائده وصل إلى حدّ تمجيد الصمت واعتباره فُلْك النجاة. والراجح أن الجاحظ حين افتتح كتاب ”البيان والتبيين“ قائلا: ”اللهمّ نعوذ بك من فتنة الكلام“ إنما صدر عن الوعي بأن الكلام بوّابة مشرعة على التهلكة والتيه والفتنة. على هذا الدرب سيسير التوحيدي أيضا ويجزم قائلا: ”إن الكلام صلف تيّاه.“ وسيصل الأمر بالخطابي البستي في ”كتاب العزلة“ إلى حدّ تمجيد العزلة باعتبارها إبطالا للكلام. يرجع هذا الخوف من الكلام إلى وعي حادّ بأن للكلمات مكرها. ولها مكائدها. وهو يرجع أيضا إلى الخوف من الفاتن والجميل. فالفاتن يفتن الإنسان عن نفسه ويستدرجه إلى مناطق غير المعقول والمجهول. بل إنه قد يستدرج الذات إلى مناطق اللاوعي حيث ترقد النزوات والأهواء في مدن الأعماق. لذلك كان لا بدّ من حراسة الخطاب ورسم حدوده وضفافه التي إن هو تعدّاها خرج إلى الفتنة. ولذلك أيضا أجمع المفكرون القدامى على أن الكلام يجب أن يجمع إلى الجميل النافع. فإذا عطّلت وظيفته النفعية خرج إلى الفتنة ولم يعد ينهض بوظيفته الاجتماعية في ”استدفاع المضار واستجلاب المنافع“ كما يحدثنا حازم القرطاجني.


سيحتفي العرب بالنصوص الأدبية التي تلبّي هذه الحاجة وتلتزم بمقرّرات العقل لاجم الأهواء والنزوات، ويسكتون عن النصوص التي تفلت من قبضة العقل. وهي نصوص تحتوي على مادّة أدبية تكرّس الفاتن والعجيب. يكفي أن نعيد قراءة الكتب التي صنّفت في مناقب الأولياء أو تلك التي حدّثت عن أشراط الساعة والملائكة أو عجائب الجان والكائنات اللامرئية، وسندرك أنها تتحرّك في مناطق تفلت من قبضة العقل. إن المادّة الأدبية المبثوثة في هذه النصوص تضعنا في حضرة السارد وهو يستسلم لفتنة السرد وفتنة الحلم ويتخطّى العقل ويمضي بالخيال إلى النهايات والأقاصي. وسواء تكلم السارد عن لحظة الأفول الكوني أو عن الجحيم والجنة والملائكة والجان فإنه يبتني الجميل الذي يثير الفتنة والخوف في الآن نفسه ويضعنا في حضرة المتخيّل وهو يتفنّن في ابتداع تشخيصاته التي تجعل الجمال يظهر في هيئة غير المتوقّع وفي هيئة المفارق والخارق. فيكفّ الجميل عن كونه مقترنا بالنافع، ويعطّل القانون الذي أرجع إليه المنظّرون القدامى جريان أدبيّة الكلام. وإذا الجميل، في هذا الأدب المنسي، فاتن ومروّع، ساحر ومخيف.
إن هذا الأدب المنسي يعصف بالعقد المفترض وجوده بين الكاتب والمتلقي المفترض. فكثيرا ما عدّت الكتابة محاورة بين شخصين مفترضين: واضع النص ومتلقّيه. وكثيرا ما اعتبر المبدع باثّا وواضع رسالة. وعُدَّ المتلقّي بمثابة طرف فاعل في فعل المحاورة ذاك لأنه هو الذي يتأوّل النص ويفكّ مغالقه ورموزه وإشاراته وفق نسق، بموجبه، يصبح طرفا في عمليّة الإبداع ذاتها. لكن هذا الأدب المنسي ليس أدب محاورة إنه أدب حلم، أدب يضعنا في حضرة ثقافة تحلم نفسها.