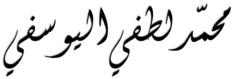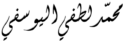كثيراً ما اعتبرت الكتابة محاورة بين شخصين مفترضين: واضع النص ومتلّقيه. وكثيراً ما اعتبر المبدع باثّاً وواضع رسالة. وعُدَّ المتلّقي بمثابة طرف فاعل في إنجاح فعل المحاورة ذاك لأنه هو الذي يتأوّل النص ويفكّ مغالقه ورموزه وإشاراته وفق نسق، بموجبه، يصبح طرفاً في عمليّة الإبداع ذاتها. والثابت أن تفريع أطراف الخطاب على هذا النحو إنما يمثّل أهمّ المقترحات التي عليها مدار أغلب الدراسات الحديثة التي يتوهّم أصحابها أن تحويل النقد إلى “علم” مسألة في المتناول يمكن أن تتحقّق وتنجز باستقدام المفاهيم والمصطلحات والتسميات التي عليها مدار المناهج المستحدثة في الثقافات الغربية.ب
إنَّ التركيز على المبدِع باعتباره باثّاً، وعلى المتلقّي باعتباره متقبّلاً كثيراً ما يؤدّي، لاسيّما عند الأكاديميين المولعين بتطبيق المناهج والنظريات تطبيقاً مدرسيّاً، إلى إفقار اللغة والكلمات. فتعامل اللغة على أنها نظام علامات. وتصبح، تحت مفعولات هذه النظرة المتعالمة، مجرّد قناة واصلة بين طرفين. أما الكلمات فإنها تُعامَل على أنها مجرّد دوال حوامل لمداليل يمكن تفكيكها وتركيبها وتوليفها مثل لعبة المربكات بالضبط.ب
عديدة هي الدراسات الأسلوبيّة والألسنيّة التي توغلت في هذا المتاه. فصارت تتشكل مشغولة بإثبات مقدّماتها ومقرّراتها ومصطلحاتها. وبذلك تحوّلت القراءة إلى تشظيّة وتشريح ومعادلات حسابيّة تُعْنَى بعدد الأحرف والكلمات والأصوات. فتقتطع من النصوص ما يمكّنها من ضبط جداولها ورسومها البيانية، وما يضمن لها أن تطبّق على النصوص العربيّة ما تيسّر لها انتزاعه من المناهج المستحدثة في الثقافات الغربيّة وما أمكنها خلعه من منابته والنزول به في غير أوطانه. وبذلك يصبح النص المدروس موضوع سؤال لكن الذي صاغ السؤال إنما هو هذا الآخر الغربي. فتوهم الذات بأنها تستمدّ حركيتها من الداخل في ما هي إنما تحاكي حركية غيرها لتتوهم في ما بعد بأنها تشاركه منجزاته. وأنّى لمن لا يؤسس سؤاله أن يجدد مصيره!.. إن تلك المفاهيم والمصطلحات تحلّ بيننا مضناة، ذليلة، يتيمة، مجوّفة، ندرك حين نتملاّها أنها تعاني من عنت الفقد وهول الفرقة. وكثيراً ما تتلفّت في السرّ مشرئبّة بأعناقها إلى أوطانها. حتى لكأنها تهفو إلى كسر أطواقها وتنشد الهبوط من صلبانها. وعلى هذه الحال تكون النصوص المدروسة لأن الناقد الذي يطبّق المصطلحات المستقدمة قهراً وإرغاماً لا يؤسس خطاباً ولا يصوغ سؤالاً بل يلبس قناعاً من أقنعة بروكروست وتستدرج النصوص إلى سرير الويلات.ب
كان بروكروست، الملقّب أيضاً داماستيس وبوليبمون، قاطع طريق منقطع النظير. كان يعيش على الطريق الرابطة بين ميغارا وأثينا، مدّوخاً العالم. فلقد ابتدع طريقة شيطانية في قتل المسافرين الغرباء الذين يمرّون ببيته. كان له سريران، أحدهما قصير والثاني طويل. وكان يرغم كلّ من يمرّ به من المسافرين على أن يستلقي فوق أحدهما. فإذا كان قصير القامة أجبره على أن يستلقي فوق السرير الطويل حتى إذا بدا أقصر من السرير مطّه بوحشيّة لا مثيل لها وخلعه خلعاً كي تلامس قدماه حافتي السرير. وإذا كان طويل القامة أرغمه على أن يستلقي على السرير القصير. وبالمنشار ينشر رجليه بمقدار الزيادة. وحين التقى البطل الصنديد ثيسيوس بالشقي بروكروست نازله وهزمه وأهلكه بالطريقة التي كان يقتل بها المسافرين الغرباء منكودي الحظّ.ت
للتطبيقات المدرسيّة الرائجة بيننا مخاطرها وويلاتها. إنها تعامل اللغة على أنها نظام معنى، نظام محدّد معلوم، نظام مضبوط القواعد والقوانين والوظائف، وتقرأ النص الإبداعي في ضوء ما تستقدمه من مفاهيم منتزعة انتزاعاً من الثقافات الغربيّة. وههنا بالضبط ينكشف ما يظلّ خافياً في تلاوين هذه المقاربات التي تطرح نفسها باعتبارها “علماً”: ثمّة وراء الإصرار على انتحال اسم “العلم” وإسناده إلى النقد عمليّة تستّر على رؤية ميتافيزيقية في منتهى الخطورة، رؤية تحسب اللغة نظاماً مكتملاً موجوداً. فلا ترى المحتمل والمفاجئ والممكن. لذلك تُعْنَى بالكلمات من جهة كونها تكشف وتبين وتفصح. والحال أن الكلمات كثيراً ما تخفي وتحجب وتمحو. وهذا الذي تمحوه الكلمات وتحجبه يظلّ يتردّد في تلاوين النصّ كأثر أو كوشم أو كرجع صدى بعيد. لذلك يكفي أن نصغي إلى النصوص وسنكتشف أن للكلمات ذاكرة مترامية حدودها فوق كلّ حدود. وهذا ما يمنح الكتابة بعدها الوجودي وقاعها التاريخي: إنها جسد متحوّل لأنّ كلّ نص ينجز إنما يحوّر جسد الكتابة ويفتح اللّغة على مالم تقله أو على مالم تتعوّد قوله. ومن هنا تستمدّ الكتابة الإبداعيّة خطرها باعتبارها حدثاً متحوّلاً يستبطن تحوّلات الكائن وتحوّلات الوجود.ت
توهم هذه الخطابات بأنها تهتدي بمنجزات الآخر وتغتذي بها فيما هي تروّج لمقولة كونية التماثل وتمحو إمكانية التفكير في مقولة كونية الاختلاف. دون أن يقع التفطّن إلى أن مقولة كونية التماثل تخفي وراءها وجهاً توسّعياً وعدوانياً على العالم وشعوبه وثقافاته. لأن التماثل إنما هو أخطر ما يتهدد الشعوب وثقافاتها.ت
تتعايش هذه الخطابات المتعالمة في المشهد النقدي مع خطابات أخرى تتشكّل مأخوذة إلى حد الهوس بمقولة الهوية حريصة على تأصيل ما تبتدعه وتنجزه. هذا ما جعلها تبحث في القديم العربي عما يخدم متعلّقها ويلبّي رغبتها في الإقناع بأنها تواصل ذلك القديم في ماهي تصدر عنه. وترفض أن تمنح الماضي فرصة المضيّ فعلاً.ت
ولا يقع التفطّن هنا أيضاً إلى أن في الالتفات الدّائم إلى الماضي بغية التأصيل وإثبات “الشرعية التاريخيّة”، تكريساً للتوجّه القدامى الميتافيزيقي الذي يبحث في الماضي عن أجوبة لأسئلة الراهن وهو توجه من شأنه أن يجعل الفعل الإبداعي في حضرة مكائد يعجز عن مواجهتها والإفلات من حبائلها وشراكها.ت
لذلك يدرك الناظر في الخطاب النقدي الذي رافق مسار تحوّلات الممارسات الشعريّة أن النقد ظلّ في أشد لحظات انتصاره للتغييرات التي ما فتئت تطال هذه الممارسات، يمارس عليها من الكيد ما يحجب منجزاتها، ويعطّل تناميها ويحدّ من اندفاعاتها. ولم تأتِ هذه المكائد من قبيل الاتفاق والبخت. إنها ترجمة فعليّة لما يربض في أقاصي الفكر النقدي من رعب من المحتملات والممكنات وهي تعبير عن إصراره على التمسّك بوهمين في منتهى الخطورة: مطلق الهوية ومطلق الكونيّة.ت
من هنا تتسلّل القدامة إلى أشدّ الخطابات النقديّة تبشيراً بالتغاير مع القديم العربي تتلقّفها وتشرع في العمل. ومن هنا أيضاً تضيع الحدود الفاصلة بين القدامة والتأصيل. والحال أن القدامة توجّه ينشدُّ على الماضي يهفو إلى عادة إنتاجه. أما التأصيل فإنه إنما يعلن عن نفسه في شكل حركة منشدّة إلى الآتي. وهو، في الآن نفسه، بحث عمّا حدث في الماضي، وما كان ممكن الحدوث ولم يحدث قصد جعله ممكناً هنا والآن، وذلك بفتح الماضي على احتمالاته. إن التأصيل حدث ينشد فتح الزمن على ممكناته واحتمالاته ويهفو إلى جعل الممارسات الفكرية والفنية تشرع في ارتياد ما اعتبر، قديماً، أفق مستحيلها.ت
هذا في رأيي ما ظلّ غائباً أو يكاد في خطاب الحداثة. إن تبسيط مفهوم التأصيل وإفقاره ما فتئ يحوّل الخطابات النقديّة إلى حبائل وشراك تحدّ من اندفاعات النص الإبداعي وتحجب منجزاته. فيكون نكوص. ويكون ارتداد. وإذ الأسئلة نفسها تستعاد جيلاً بعد جيل.ل
هذا الارتداد سيتلقّف الرؤى، ويلوّن المواقف، ويتحكّم بالسلوكات لاسيّما في اللحظات التي توضع فيها الممارسة الشعريّة في حضرة ممكناتها. سيعلن عن نفسه صريحاً لحظة انفجار نظام الشطرين وتفتتح قصيدة التفعيلة تاريخها محاصرة بالإدانة بالتشهير بالفضح. وسيحدّثنا طه حسين أحد رموز الفكر الحداثيّ العربي قائلاً: “إن الشعراء الجدد لم يحفظوا الأمانة ولم ينشئوا مكان الأدب الذي أهملوه أدباً جيّداً وإنما أنشؤوا لهواً ولعباً.”. لن يكتفي طه حسين بإدانة هذا الشعر بل يصل إلى حدّ استعداء الدولة على الشعراء زعماً أنها لا تحمي الشعر العربي “من عبث العابثين ولا تصون حقوقه من عدوان المعتدين، ولا تردّ عنه بغي الباغين.”. ههنا يندرج أيضاً كتاب نازك الملائكة “قضايا الشعر المعاصر”، فهو يبشر بالنكوص والارتداد إذ جزمت نازك بأن “الخروج على نظام الشطرين ليس سوى حركة ستبلغ نهاياتها المبتذلة… ولسوف يرتدّ عنها أغلب الذين استجابوا لها.”ل
لذلك حين نقرأ التسميّة التي أطلقت على الممارسات الشعريّة التي كرّست هذا الخروج سرعان ما ندرك أن مصطلح “الشعر الحر”، الذي استقدمته نازك الملائكة، ليس سوى تسمية ماكرة تضعنا في حضرة النقد وهو يمعن في نسج مكائده وفتل أحابيله ونسج شراكه ليحدّ من اندفاعات الممارسة الشعريّة ويلغي محتملاتها وممكناتها.ل
فلقد جزمت نازك الملائكة التي استقدمت المصطلح من الثقافة الغربية بأن الشعر إنما هو أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل وجزمت بأن الشعر الحر ظاهرة عروضيّة قبل كل شيء. غير أن الكيفية التي تمّ بها نقل هذا المصطلح وتحويله عن مقاديره والنزول به في غير أوطانه بعد إفراغه من محتواه، تكشف هي الأخرى ما لمطلق الهويّة ولمطلق الأصالة من سطوة في الوعي الحداثي العربي.ل
ثمّة مفارقة شرعت تنخر التسمية من الداخل لحظة استقدامها. ثمّة تناقض شرع في العمل والاعتمال. ثمّة فجوة ستظلّ تتسع بين الدال ومدلوله. إن الدال (الشعر الحر)، يضعنا في حضرة ممكنات الكتابة أي التحرر من القيود والإكراهات. والمدلول (أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل) يسدّ الآفاق جميعها في وجه تلك الممكنات والمحتملات.ل
هكذا صارت الحرية حرية مشروطة. وهكذا أمعن الخطاب النقدي في حبك مكائده. إن عمليّة تحويل المصطلح عن دلالته تحمل في تلاوينها حرصاً على تكريس الممنوع ورسم مناطق المحرّم. بل إنه جاء ليجعل مجرّد التفكير في الخروج على القيود والإكراهات المسبّقة أمراً لا مفكّراً فيه أصلاً.ل
هكذا افتتحت التسميّة تاريخها.
هكذا أيضاً نسجت البعض من مكائدها.ل
وتلكم بعض تجلّيات الوعي التحديثي المسكون بالخوف من المحتمل والحرص على حجبه وتغييبه.ل
غير أن قصيدة التفعيلة، هذه القصيدة المطلوب حتفها ستظلّ تمارس اللعب بالبحور المتعارفة فتزاوج بينها، وتمارس اللعب بالتفعيلات أيضاً، وتقلّبها كما الحطب على نار. وبذلك تضع الشعر العربي قدّام محتملاته من جديد. وإذا الرغبة العارمة في تخطّي الوزن تلك الرغبة التي ظلّت تشغل من المشهد الشعري العربي هوامشه تعاود الظهور على نحو عاصف هذه المرّة. أجيال وتجارب شعريّة جاءت تكرّس هذا المحتملات والممكنات.ا
كان الخروج على الوزن إذن. وكان لابدّ من تسميته. ولم تكن التسميّة هذه المرّة أيضاً من ابتداع الخطاب النقدي العربي بل كانت مستقدمة. ههنا يتنزّل الاحتفاء بكتاب سوزان برنار. فلقد عمد أدونيس سنة 1959 إلى تلخيص ما تيسّر منه ليضطلع الكتاب بدور معياري مرجعي. وسيظلّ هذا الكتاب يضطلع بهذا الدور حتى الآن.ا
لقد استقدم مفهوم “قصيدة النثر” وابتدأ تغريبته بيننا وأرغم على النزول في غير أوطانه وسرعان ما ألقى بظلاله على الممارسات الشعريّة. فلقد صارت النصوص التي تخلّت عن الأوزان المتعارفة تحيا بيننا يتيمة غريبة مقصاة. وكثيراً ما تنعت بكونها مجرد محاكاة للوافد الغربي. لذلك تحاط بالريبة، بالشكّ، بالخوف من كونها إنما تمثّل تصدّعاً خطيراً في مسار الشعريّة العربيّة. ولنا أن نسمع في صوت كلّ شاعر عربي معاصر اختار الخروج على الأوزان المتعارفة رغبة عاتية في تأكيد الانتماء إلى الشعرية العربية. لذلك سيحرص الوعي التحديثي على تأصيل هذه الممارسة الشعرية. ومحنة البحث عن جذور محتملة أو مفترضة في التراث العربي. فيشرع مطلق الأصالة في العمل من جديد.ا
لكن الخطابات النقدّية التحديثية ظلت تستقدم التراث، لا للشروع في استكشافه، وتملّكه ومفارقته بافتتاح ممكناته ومحتملاته، بل تستدعيه لينوب عنها في الإجابة على أسئلة الراهن. وههنا بالضبط تنكشف القدامة المتوارية هناك عميقاً في صميم هذا الوعي تعمل لا تكلّ. هذه القدامة المتكتّمة على نفسها هي التي جعلته يحتمي بالمصطلحات المنتزعة من منابتها قهراً واغتصاباً أو يلوذ بالتراث عند مواجهته للمتغيّرات، حتى لكأن التراث وعاء يحتوي على إجابات لكلّ الأسئلة المطروح منها وما سيأتي. هذه القدامة المواربة المتوارية على نفسها في صميم الوعي التحديثي هي التي جعلته يرفض أن يهب ما من التراث لا يمكن أن يستمرّ فرصة المضيّ فعلاً.ا
لذلك يكفي أن نعيد مساءلة الخطاب النقدي العربي، ومساءلة أطروحاته وكيفيات صياغته لأسئلته وسندرك أن بروكروست، الملّقب أيضاً داماستيس وبوليبمون، لم يكن شخصاً بل كان شبحاً. وواهماً كان البطل الصنديد ثيسيوس حين ظنّ أنه قد صرعه وأباده وخلّص العالم من شروره في سالف الزمان: إن الشبح لا يموت.ا
كثيراً ما اعتبرت الكتابة محاورة بين شخصين مفترضين: واضع النص ومتلّقيه. وكثيراً ما اعتبر المبدع باثّاً وواضع رسالة. وعُدَّ المتلّقي بمثابة طرف فاعل في إنجاح فعل المحاورة ذاك لأنه هو الذي يتأوّل النص ويفكّ مغالقه ورموزه وإشاراته وفق نسق، بموجبه، يصبح طرفاً في عمليّة الإبداع ذاتها. والثابت أن تفريع أطراف الخطاب على هذا النحو إنما يمثّل أهمّ المقترحات التي عليها مدار أغلب الدراسات الحديثة التي يتوهّم أصحابها أن تحويل النقد إلى “علم” مسألة في المتناول يمكن أن تتحقّق وتنجز باستقدام المفاهيم والمصطلحات والتسميات التي عليها مدار المناهج المستحدثة في الثقافات الغربية.ب
إنَّ التركيز على المبدِع باعتباره باثّاً، وعلى المتلقّي باعتباره متقبّلاً كثيراً ما يؤدّي، لاسيّما عند الأكاديميين المولعين بتطبيق المناهج والنظريات تطبيقاً مدرسيّاً، إلى إفقار اللغة والكلمات. فتعامل اللغة على أنها نظام علامات. وتصبح، تحت مفعولات هذه النظرة المتعالمة، مجرّد قناة واصلة بين طرفين. أما الكلمات فإنها تُعامَل على أنها مجرّد دوال حوامل لمداليل يمكن تفكيكها وتركيبها وتوليفها مثل لعبة المربكات بالضبط.ب
عديدة هي الدراسات الأسلوبيّة والألسنيّة التي توغلت في هذا المتاه. فصارت تتشكل مشغولة بإثبات مقدّماتها ومقرّراتها ومصطلحاتها. وبذلك تحوّلت القراءة إلى تشظيّة وتشريح ومعادلات حسابيّة تُعْنَى بعدد الأحرف والكلمات والأصوات. فتقتطع من النصوص ما يمكّنها من ضبط جداولها ورسومها البيانية، وما يضمن لها أن تطبّق على النصوص العربيّة ما تيسّر لها انتزاعه من المناهج المستحدثة في الثقافات الغربيّة وما أمكنها خلعه من منابته والنزول به في غير أوطانه. وبذلك يصبح النص المدروس موضوع سؤال لكن الذي صاغ السؤال إنما هو هذا الآخر الغربي. فتوهم الذات بأنها تستمدّ حركيتها من الداخل في ما هي إنما تحاكي حركية غيرها لتتوهم في ما بعد بأنها تشاركه منجزاته. وأنّى لمن لا يؤسس سؤاله أن يجدد مصيره!.. إن تلك المفاهيم والمصطلحات تحلّ بيننا مضناة، ذليلة، يتيمة، مجوّفة، ندرك حين نتملاّها أنها تعاني من عنت الفقد وهول الفرقة. وكثيراً ما تتلفّت في السرّ مشرئبّة بأعناقها إلى أوطانها. حتى لكأنها تهفو إلى كسر أطواقها وتنشد الهبوط من صلبانها. وعلى هذه الحال تكون النصوص المدروسة لأن الناقد الذي يطبّق المصطلحات المستقدمة قهراً وإرغاماً لا يؤسس خطاباً ولا يصوغ سؤالاً بل يلبس قناعاً من أقنعة بروكروست وتستدرج النصوص إلى سرير الويلات.ب
كان بروكروست، الملقّب أيضاً داماستيس وبوليبمون، قاطع طريق منقطع النظير. كان يعيش على الطريق الرابطة بين ميغارا وأثينا، مدّوخاً العالم. فلقد ابتدع طريقة شيطانية في قتل المسافرين الغرباء الذين يمرّون ببيته. كان له سريران، أحدهما قصير والثاني طويل. وكان يرغم كلّ من يمرّ به من المسافرين على أن يستلقي فوق أحدهما. فإذا كان قصير القامة أجبره على أن يستلقي فوق السرير الطويل حتى إذا بدا أقصر من السرير مطّه بوحشيّة لا مثيل لها وخلعه خلعاً كي تلامس قدماه حافتي السرير. وإذا كان طويل القامة أرغمه على أن يستلقي على السرير القصير. وبالمنشار ينشر رجليه بمقدار الزيادة. وحين التقى البطل الصنديد ثيسيوس بالشقي بروكروست نازله وهزمه وأهلكه بالطريقة التي كان يقتل بها المسافرين الغرباء منكودي الحظّ.ت
للتطبيقات المدرسيّة الرائجة بيننا مخاطرها وويلاتها. إنها تعامل اللغة على أنها نظام معنى، نظام محدّد معلوم، نظام مضبوط القواعد والقوانين والوظائف، وتقرأ النص الإبداعي في ضوء ما تستقدمه من مفاهيم منتزعة انتزاعاً من الثقافات الغربيّة. وههنا بالضبط ينكشف ما يظلّ خافياً في تلاوين هذه المقاربات التي تطرح نفسها باعتبارها “علماً”: ثمّة وراء الإصرار على انتحال اسم “العلم” وإسناده إلى النقد عمليّة تستّر على رؤية ميتافيزيقية في منتهى الخطورة، رؤية تحسب اللغة نظاماً مكتملاً موجوداً. فلا ترى المحتمل والمفاجئ والممكن. لذلك تُعْنَى بالكلمات من جهة كونها تكشف وتبين وتفصح. والحال أن الكلمات كثيراً ما تخفي وتحجب وتمحو. وهذا الذي تمحوه الكلمات وتحجبه يظلّ يتردّد في تلاوين النصّ كأثر أو كوشم أو كرجع صدى بعيد. لذلك يكفي أن نصغي إلى النصوص وسنكتشف أن للكلمات ذاكرة مترامية حدودها فوق كلّ حدود. وهذا ما يمنح الكتابة بعدها الوجودي وقاعها التاريخي: إنها جسد متحوّل لأنّ كلّ نص ينجز إنما يحوّر جسد الكتابة ويفتح اللّغة على مالم تقله أو على مالم تتعوّد قوله. ومن هنا تستمدّ الكتابة الإبداعيّة خطرها باعتبارها حدثاً متحوّلاً يستبطن تحوّلات الكائن وتحوّلات الوجود.ت
توهم هذه الخطابات بأنها تهتدي بمنجزات الآخر وتغتذي بها فيما هي تروّج لمقولة كونية التماثل وتمحو إمكانية التفكير في مقولة كونية الاختلاف. دون أن يقع التفطّن إلى أن مقولة كونية التماثل تخفي وراءها وجهاً توسّعياً وعدوانياً على العالم وشعوبه وثقافاته. لأن التماثل إنما هو أخطر ما يتهدد الشعوب وثقافاتها.ت
تتعايش هذه الخطابات المتعالمة في المشهد النقدي مع خطابات أخرى تتشكّل مأخوذة إلى حد الهوس بمقولة الهوية حريصة على تأصيل ما تبتدعه وتنجزه. هذا ما جعلها تبحث في القديم العربي عما يخدم متعلّقها ويلبّي رغبتها في الإقناع بأنها تواصل ذلك القديم في ماهي تصدر عنه. وترفض أن تمنح الماضي فرصة المضيّ فعلاً.ت
ولا يقع التفطّن هنا أيضاً إلى أن في الالتفات الدّائم إلى الماضي بغية التأصيل وإثبات “الشرعية التاريخيّة”، تكريساً للتوجّه القدامى الميتافيزيقي الذي يبحث في الماضي عن أجوبة لأسئلة الراهن وهو توجه من شأنه أن يجعل الفعل الإبداعي في حضرة مكائد يعجز عن مواجهتها والإفلات من حبائلها وشراكها.ت
لذلك يدرك الناظر في الخطاب النقدي الذي رافق مسار تحوّلات الممارسات الشعريّة أن النقد ظلّ في أشد لحظات انتصاره للتغييرات التي ما فتئت تطال هذه الممارسات، يمارس عليها من الكيد ما يحجب منجزاتها، ويعطّل تناميها ويحدّ من اندفاعاتها. ولم تأتِ هذه المكائد من قبيل الاتفاق والبخت. إنها ترجمة فعليّة لما يربض في أقاصي الفكر النقدي من رعب من المحتملات والممكنات وهي تعبير عن إصراره على التمسّك بوهمين في منتهى الخطورة: مطلق الهوية ومطلق الكونيّة.ت
من هنا تتسلّل القدامة إلى أشدّ الخطابات النقديّة تبشيراً بالتغاير مع القديم العربي تتلقّفها وتشرع في العمل. ومن هنا أيضاً تضيع الحدود الفاصلة بين القدامة والتأصيل. والحال أن القدامة توجّه ينشدُّ على الماضي يهفو إلى عادة إنتاجه. أما التأصيل فإنه إنما يعلن عن نفسه في شكل حركة منشدّة إلى الآتي. وهو، في الآن نفسه، بحث عمّا حدث في الماضي، وما كان ممكن الحدوث ولم يحدث قصد جعله ممكناً هنا والآن، وذلك بفتح الماضي على احتمالاته. إن التأصيل حدث ينشد فتح الزمن على ممكناته واحتمالاته ويهفو إلى جعل الممارسات الفكرية والفنية تشرع في ارتياد ما اعتبر، قديماً، أفق مستحيلها.ت
هذا في رأيي ما ظلّ غائباً أو يكاد في خطاب الحداثة. إن تبسيط مفهوم التأصيل وإفقاره ما فتئ يحوّل الخطابات النقديّة إلى حبائل وشراك تحدّ من اندفاعات النص الإبداعي وتحجب منجزاته. فيكون نكوص. ويكون ارتداد. وإذ الأسئلة نفسها تستعاد جيلاً بعد جيل.ل
هذا الارتداد سيتلقّف الرؤى، ويلوّن المواقف، ويتحكّم بالسلوكات لاسيّما في اللحظات التي توضع فيها الممارسة الشعريّة في حضرة ممكناتها. سيعلن عن نفسه صريحاً لحظة انفجار نظام الشطرين وتفتتح قصيدة التفعيلة تاريخها محاصرة بالإدانة بالتشهير بالفضح. وسيحدّثنا طه حسين أحد رموز الفكر الحداثيّ العربي قائلاً: “إن الشعراء الجدد لم يحفظوا الأمانة ولم ينشئوا مكان الأدب الذي أهملوه أدباً جيّداً وإنما أنشؤوا لهواً ولعباً.”. لن يكتفي طه حسين بإدانة هذا الشعر بل يصل إلى حدّ استعداء الدولة على الشعراء زعماً أنها لا تحمي الشعر العربي “من عبث العابثين ولا تصون حقوقه من عدوان المعتدين، ولا تردّ عنه بغي الباغين.”. ههنا يندرج أيضاً كتاب نازك الملائكة “قضايا الشعر المعاصر”، فهو يبشر بالنكوص والارتداد إذ جزمت نازك بأن “الخروج على نظام الشطرين ليس سوى حركة ستبلغ نهاياتها المبتذلة… ولسوف يرتدّ عنها أغلب الذين استجابوا لها.”ل
لذلك حين نقرأ التسميّة التي أطلقت على الممارسات الشعريّة التي كرّست هذا الخروج سرعان ما ندرك أن مصطلح “الشعر الحر”، الذي استقدمته نازك الملائكة، ليس سوى تسمية ماكرة تضعنا في حضرة النقد وهو يمعن في نسج مكائده وفتل أحابيله ونسج شراكه ليحدّ من اندفاعات الممارسة الشعريّة ويلغي محتملاتها وممكناتها.ل
فلقد جزمت نازك الملائكة التي استقدمت المصطلح من الثقافة الغربية بأن الشعر إنما هو أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل وجزمت بأن الشعر الحر ظاهرة عروضيّة قبل كل شيء. غير أن الكيفية التي تمّ بها نقل هذا المصطلح وتحويله عن مقاديره والنزول به في غير أوطانه بعد إفراغه من محتواه، تكشف هي الأخرى ما لمطلق الهويّة ولمطلق الأصالة من سطوة في الوعي الحداثي العربي.ل
ثمّة مفارقة شرعت تنخر التسمية من الداخل لحظة استقدامها. ثمّة تناقض شرع في العمل والاعتمال. ثمّة فجوة ستظلّ تتسع بين الدال ومدلوله. إن الدال (الشعر الحر)، يضعنا في حضرة ممكنات الكتابة أي التحرر من القيود والإكراهات. والمدلول (أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل) يسدّ الآفاق جميعها في وجه تلك الممكنات والمحتملات.ل
هكذا صارت الحرية حرية مشروطة. وهكذا أمعن الخطاب النقدي في حبك مكائده. إن عمليّة تحويل المصطلح عن دلالته تحمل في تلاوينها حرصاً على تكريس الممنوع ورسم مناطق المحرّم. بل إنه جاء ليجعل مجرّد التفكير في الخروج على القيود والإكراهات المسبّقة أمراً لا مفكّراً فيه أصلاً.ل
هكذا افتتحت التسميّة تاريخها.
هكذا أيضاً نسجت البعض من مكائدها.ل
وتلكم بعض تجلّيات الوعي التحديثي المسكون بالخوف من المحتمل والحرص على حجبه وتغييبه.ل
غير أن قصيدة التفعيلة، هذه القصيدة المطلوب حتفها ستظلّ تمارس اللعب بالبحور المتعارفة فتزاوج بينها، وتمارس اللعب بالتفعيلات أيضاً، وتقلّبها كما الحطب على نار. وبذلك تضع الشعر العربي قدّام محتملاته من جديد. وإذا الرغبة العارمة في تخطّي الوزن تلك الرغبة التي ظلّت تشغل من المشهد الشعري العربي هوامشه تعاود الظهور على نحو عاصف هذه المرّة. أجيال وتجارب شعريّة جاءت تكرّس هذا المحتملات والممكنات.ا
كان الخروج على الوزن إذن. وكان لابدّ من تسميته. ولم تكن التسميّة هذه المرّة أيضاً من ابتداع الخطاب النقدي العربي بل كانت مستقدمة. ههنا يتنزّل الاحتفاء بكتاب سوزان برنار. فلقد عمد أدونيس سنة 1959 إلى تلخيص ما تيسّر منه ليضطلع الكتاب بدور معياري مرجعي. وسيظلّ هذا الكتاب يضطلع بهذا الدور حتى الآن.ا
لقد استقدم مفهوم “قصيدة النثر” وابتدأ تغريبته بيننا وأرغم على النزول في غير أوطانه وسرعان ما ألقى بظلاله على الممارسات الشعريّة. فلقد صارت النصوص التي تخلّت عن الأوزان المتعارفة تحيا بيننا يتيمة غريبة مقصاة. وكثيراً ما تنعت بكونها مجرد محاكاة للوافد الغربي. لذلك تحاط بالريبة، بالشكّ، بالخوف من كونها إنما تمثّل تصدّعاً خطيراً في مسار الشعريّة العربيّة. ولنا أن نسمع في صوت كلّ شاعر عربي معاصر اختار الخروج على الأوزان المتعارفة رغبة عاتية في تأكيد الانتماء إلى الشعرية العربية. لذلك سيحرص الوعي التحديثي على تأصيل هذه الممارسة الشعرية. ومحنة البحث عن جذور محتملة أو مفترضة في التراث العربي. فيشرع مطلق الأصالة في العمل من جديد.ا
لكن الخطابات النقدّية التحديثية ظلت تستقدم التراث، لا للشروع في استكشافه، وتملّكه ومفارقته بافتتاح ممكناته ومحتملاته، بل تستدعيه لينوب عنها في الإجابة على أسئلة الراهن. وههنا بالضبط تنكشف القدامة المتوارية هناك عميقاً في صميم هذا الوعي تعمل لا تكلّ. هذه القدامة المتكتّمة على نفسها هي التي جعلته يحتمي بالمصطلحات المنتزعة من منابتها قهراً واغتصاباً أو يلوذ بالتراث عند مواجهته للمتغيّرات، حتى لكأن التراث وعاء يحتوي على إجابات لكلّ الأسئلة المطروح منها وما سيأتي. هذه القدامة المواربة المتوارية على نفسها في صميم الوعي التحديثي هي التي جعلته يرفض أن يهب ما من التراث لا يمكن أن يستمرّ فرصة المضيّ فعلاً.ا
لذلك يكفي أن نعيد مساءلة الخطاب النقدي العربي، ومساءلة أطروحاته وكيفيات صياغته لأسئلته وسندرك أن بروكروست، الملّقب أيضاً داماستيس وبوليبمون، لم يكن شخصاً بل كان شبحاً. وواهماً كان البطل الصنديد ثيسيوس حين ظنّ أنه قد صرعه وأباده وخلّص العالم من شروره في سالف الزمان: إن الشبح لا يموت.ا
كثيراً ما اعتبرت الكتابة محاورة بين شخصين مفترضين: واضع النص ومتلّقيه. وكثيراً ما اعتبر المبدع باثّاً وواضع رسالة. وعُدَّ المتلّقي بمثابة طرف فاعل في إنجاح فعل المحاورة ذاك لأنه هو الذي يتأوّل النص ويفكّ مغالقه ورموزه وإشاراته وفق نسق، بموجبه، يصبح طرفاً في عمليّة الإبداع ذاتها. والثابت أن تفريع أطراف الخطاب على هذا النحو إنما يمثّل أهمّ المقترحات التي عليها مدار أغلب الدراسات الحديثة التي يتوهّم أصحابها أن تحويل النقد إلى “علم” مسألة في المتناول يمكن أن تتحقّق وتنجز باستقدام المفاهيم والمصطلحات والتسميات التي عليها مدار المناهج المستحدثة في الثقافات الغربية.ب
إنَّ التركيز على المبدِع باعتباره باثّاً، وعلى المتلقّي باعتباره متقبّلاً كثيراً ما يؤدّي، لاسيّما عند الأكاديميين المولعين بتطبيق المناهج والنظريات تطبيقاً مدرسيّاً، إلى إفقار اللغة والكلمات. فتعامل اللغة على أنها نظام علامات. وتصبح، تحت مفعولات هذه النظرة المتعالمة، مجرّد قناة واصلة بين طرفين. أما الكلمات فإنها تُعامَل على أنها مجرّد دوال حوامل لمداليل يمكن تفكيكها وتركيبها وتوليفها مثل لعبة المربكات بالضبط.ب
عديدة هي الدراسات الأسلوبيّة والألسنيّة التي توغلت في هذا المتاه. فصارت تتشكل مشغولة بإثبات مقدّماتها ومقرّراتها ومصطلحاتها. وبذلك تحوّلت القراءة إلى تشظيّة وتشريح ومعادلات حسابيّة تُعْنَى بعدد الأحرف والكلمات والأصوات. فتقتطع من النصوص ما يمكّنها من ضبط جداولها ورسومها البيانية، وما يضمن لها أن تطبّق على النصوص العربيّة ما تيسّر لها انتزاعه من المناهج المستحدثة في الثقافات الغربيّة وما أمكنها خلعه من منابته والنزول به في غير أوطانه. وبذلك يصبح النص المدروس موضوع سؤال لكن الذي صاغ السؤال إنما هو هذا الآخر الغربي. فتوهم الذات بأنها تستمدّ حركيتها من الداخل في ما هي إنما تحاكي حركية غيرها لتتوهم في ما بعد بأنها تشاركه منجزاته. وأنّى لمن لا يؤسس سؤاله أن يجدد مصيره!.. إن تلك المفاهيم والمصطلحات تحلّ بيننا مضناة، ذليلة، يتيمة، مجوّفة، ندرك حين نتملاّها أنها تعاني من عنت الفقد وهول الفرقة. وكثيراً ما تتلفّت في السرّ مشرئبّة بأعناقها إلى أوطانها. حتى لكأنها تهفو إلى كسر أطواقها وتنشد الهبوط من صلبانها. وعلى هذه الحال تكون النصوص المدروسة لأن الناقد الذي يطبّق المصطلحات المستقدمة قهراً وإرغاماً لا يؤسس خطاباً ولا يصوغ سؤالاً بل يلبس قناعاً من أقنعة بروكروست وتستدرج النصوص إلى سرير الويلات.ب
كان بروكروست، الملقّب أيضاً داماستيس وبوليبمون، قاطع طريق منقطع النظير. كان يعيش على الطريق الرابطة بين ميغارا وأثينا، مدّوخاً العالم. فلقد ابتدع طريقة شيطانية في قتل المسافرين الغرباء الذين يمرّون ببيته. كان له سريران، أحدهما قصير والثاني طويل. وكان يرغم كلّ من يمرّ به من المسافرين على أن يستلقي فوق أحدهما. فإذا كان قصير القامة أجبره على أن يستلقي فوق السرير الطويل حتى إذا بدا أقصر من السرير مطّه بوحشيّة لا مثيل لها وخلعه خلعاً كي تلامس قدماه حافتي السرير. وإذا كان طويل القامة أرغمه على أن يستلقي على السرير القصير. وبالمنشار ينشر رجليه بمقدار الزيادة. وحين التقى البطل الصنديد ثيسيوس بالشقي بروكروست نازله وهزمه وأهلكه بالطريقة التي كان يقتل بها المسافرين الغرباء منكودي الحظّ.ت
للتطبيقات المدرسيّة الرائجة بيننا مخاطرها وويلاتها. إنها تعامل اللغة على أنها نظام معنى، نظام محدّد معلوم، نظام مضبوط القواعد والقوانين والوظائف، وتقرأ النص الإبداعي في ضوء ما تستقدمه من مفاهيم منتزعة انتزاعاً من الثقافات الغربيّة. وههنا بالضبط ينكشف ما يظلّ خافياً في تلاوين هذه المقاربات التي تطرح نفسها باعتبارها “علماً”: ثمّة وراء الإصرار على انتحال اسم “العلم” وإسناده إلى النقد عمليّة تستّر على رؤية ميتافيزيقية في منتهى الخطورة، رؤية تحسب اللغة نظاماً مكتملاً موجوداً. فلا ترى المحتمل والمفاجئ والممكن. لذلك تُعْنَى بالكلمات من جهة كونها تكشف وتبين وتفصح. والحال أن الكلمات كثيراً ما تخفي وتحجب وتمحو. وهذا الذي تمحوه الكلمات وتحجبه يظلّ يتردّد في تلاوين النصّ كأثر أو كوشم أو كرجع صدى بعيد. لذلك يكفي أن نصغي إلى النصوص وسنكتشف أن للكلمات ذاكرة مترامية حدودها فوق كلّ حدود. وهذا ما يمنح الكتابة بعدها الوجودي وقاعها التاريخي: إنها جسد متحوّل لأنّ كلّ نص ينجز إنما يحوّر جسد الكتابة ويفتح اللّغة على مالم تقله أو على مالم تتعوّد قوله. ومن هنا تستمدّ الكتابة الإبداعيّة خطرها باعتبارها حدثاً متحوّلاً يستبطن تحوّلات الكائن وتحوّلات الوجود.ت
توهم هذه الخطابات بأنها تهتدي بمنجزات الآخر وتغتذي بها فيما هي تروّج لمقولة كونية التماثل وتمحو إمكانية التفكير في مقولة كونية الاختلاف. دون أن يقع التفطّن إلى أن مقولة كونية التماثل تخفي وراءها وجهاً توسّعياً وعدوانياً على العالم وشعوبه وثقافاته. لأن التماثل إنما هو أخطر ما يتهدد الشعوب وثقافاتها.ت
تتعايش هذه الخطابات المتعالمة في المشهد النقدي مع خطابات أخرى تتشكّل مأخوذة إلى حد الهوس بمقولة الهوية حريصة على تأصيل ما تبتدعه وتنجزه. هذا ما جعلها تبحث في القديم العربي عما يخدم متعلّقها ويلبّي رغبتها في الإقناع بأنها تواصل ذلك القديم في ماهي تصدر عنه. وترفض أن تمنح الماضي فرصة المضيّ فعلاً.ت
ولا يقع التفطّن هنا أيضاً إلى أن في الالتفات الدّائم إلى الماضي بغية التأصيل وإثبات “الشرعية التاريخيّة”، تكريساً للتوجّه القدامى الميتافيزيقي الذي يبحث في الماضي عن أجوبة لأسئلة الراهن وهو توجه من شأنه أن يجعل الفعل الإبداعي في حضرة مكائد يعجز عن مواجهتها والإفلات من حبائلها وشراكها.ت
لذلك يدرك الناظر في الخطاب النقدي الذي رافق مسار تحوّلات الممارسات الشعريّة أن النقد ظلّ في أشد لحظات انتصاره للتغييرات التي ما فتئت تطال هذه الممارسات، يمارس عليها من الكيد ما يحجب منجزاتها، ويعطّل تناميها ويحدّ من اندفاعاتها. ولم تأتِ هذه المكائد من قبيل الاتفاق والبخت. إنها ترجمة فعليّة لما يربض في أقاصي الفكر النقدي من رعب من المحتملات والممكنات وهي تعبير عن إصراره على التمسّك بوهمين في منتهى الخطورة: مطلق الهوية ومطلق الكونيّة.ت
من هنا تتسلّل القدامة إلى أشدّ الخطابات النقديّة تبشيراً بالتغاير مع القديم العربي تتلقّفها وتشرع في العمل. ومن هنا أيضاً تضيع الحدود الفاصلة بين القدامة والتأصيل. والحال أن القدامة توجّه ينشدُّ على الماضي يهفو إلى عادة إنتاجه. أما التأصيل فإنه إنما يعلن عن نفسه في شكل حركة منشدّة إلى الآتي. وهو، في الآن نفسه، بحث عمّا حدث في الماضي، وما كان ممكن الحدوث ولم يحدث قصد جعله ممكناً هنا والآن، وذلك بفتح الماضي على احتمالاته. إن التأصيل حدث ينشد فتح الزمن على ممكناته واحتمالاته ويهفو إلى جعل الممارسات الفكرية والفنية تشرع في ارتياد ما اعتبر، قديماً، أفق مستحيلها.ت
هذا في رأيي ما ظلّ غائباً أو يكاد في خطاب الحداثة. إن تبسيط مفهوم التأصيل وإفقاره ما فتئ يحوّل الخطابات النقديّة إلى حبائل وشراك تحدّ من اندفاعات النص الإبداعي وتحجب منجزاته. فيكون نكوص. ويكون ارتداد. وإذ الأسئلة نفسها تستعاد جيلاً بعد جيل.ل
هذا الارتداد سيتلقّف الرؤى، ويلوّن المواقف، ويتحكّم بالسلوكات لاسيّما في اللحظات التي توضع فيها الممارسة الشعريّة في حضرة ممكناتها. سيعلن عن نفسه صريحاً لحظة انفجار نظام الشطرين وتفتتح قصيدة التفعيلة تاريخها محاصرة بالإدانة بالتشهير بالفضح. وسيحدّثنا طه حسين أحد رموز الفكر الحداثيّ العربي قائلاً: “إن الشعراء الجدد لم يحفظوا الأمانة ولم ينشئوا مكان الأدب الذي أهملوه أدباً جيّداً وإنما أنشؤوا لهواً ولعباً.”. لن يكتفي طه حسين بإدانة هذا الشعر بل يصل إلى حدّ استعداء الدولة على الشعراء زعماً أنها لا تحمي الشعر العربي “من عبث العابثين ولا تصون حقوقه من عدوان المعتدين، ولا تردّ عنه بغي الباغين.”. ههنا يندرج أيضاً كتاب نازك الملائكة “قضايا الشعر المعاصر”، فهو يبشر بالنكوص والارتداد إذ جزمت نازك بأن “الخروج على نظام الشطرين ليس سوى حركة ستبلغ نهاياتها المبتذلة… ولسوف يرتدّ عنها أغلب الذين استجابوا لها.”ل
لذلك حين نقرأ التسميّة التي أطلقت على الممارسات الشعريّة التي كرّست هذا الخروج سرعان ما ندرك أن مصطلح “الشعر الحر”، الذي استقدمته نازك الملائكة، ليس سوى تسمية ماكرة تضعنا في حضرة النقد وهو يمعن في نسج مكائده وفتل أحابيله ونسج شراكه ليحدّ من اندفاعات الممارسة الشعريّة ويلغي محتملاتها وممكناتها.ل
فلقد جزمت نازك الملائكة التي استقدمت المصطلح من الثقافة الغربية بأن الشعر إنما هو أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل وجزمت بأن الشعر الحر ظاهرة عروضيّة قبل كل شيء. غير أن الكيفية التي تمّ بها نقل هذا المصطلح وتحويله عن مقاديره والنزول به في غير أوطانه بعد إفراغه من محتواه، تكشف هي الأخرى ما لمطلق الهويّة ولمطلق الأصالة من سطوة في الوعي الحداثي العربي.ل
ثمّة مفارقة شرعت تنخر التسمية من الداخل لحظة استقدامها. ثمّة تناقض شرع في العمل والاعتمال. ثمّة فجوة ستظلّ تتسع بين الدال ومدلوله. إن الدال (الشعر الحر)، يضعنا في حضرة ممكنات الكتابة أي التحرر من القيود والإكراهات. والمدلول (أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل) يسدّ الآفاق جميعها في وجه تلك الممكنات والمحتملات.ل
هكذا صارت الحرية حرية مشروطة. وهكذا أمعن الخطاب النقدي في حبك مكائده. إن عمليّة تحويل المصطلح عن دلالته تحمل في تلاوينها حرصاً على تكريس الممنوع ورسم مناطق المحرّم. بل إنه جاء ليجعل مجرّد التفكير في الخروج على القيود والإكراهات المسبّقة أمراً لا مفكّراً فيه أصلاً.ل
هكذا افتتحت التسميّة تاريخها.
هكذا أيضاً نسجت البعض من مكائدها.ل
وتلكم بعض تجلّيات الوعي التحديثي المسكون بالخوف من المحتمل والحرص على حجبه وتغييبه.ل
غير أن قصيدة التفعيلة، هذه القصيدة المطلوب حتفها ستظلّ تمارس اللعب بالبحور المتعارفة فتزاوج بينها، وتمارس اللعب بالتفعيلات أيضاً، وتقلّبها كما الحطب على نار. وبذلك تضع الشعر العربي قدّام محتملاته من جديد. وإذا الرغبة العارمة في تخطّي الوزن تلك الرغبة التي ظلّت تشغل من المشهد الشعري العربي هوامشه تعاود الظهور على نحو عاصف هذه المرّة. أجيال وتجارب شعريّة جاءت تكرّس هذا المحتملات والممكنات.ا
كان الخروج على الوزن إذن. وكان لابدّ من تسميته. ولم تكن التسميّة هذه المرّة أيضاً من ابتداع الخطاب النقدي العربي بل كانت مستقدمة. ههنا يتنزّل الاحتفاء بكتاب سوزان برنار. فلقد عمد أدونيس سنة 1959 إلى تلخيص ما تيسّر منه ليضطلع الكتاب بدور معياري مرجعي. وسيظلّ هذا الكتاب يضطلع بهذا الدور حتى الآن.ا
لقد استقدم مفهوم “قصيدة النثر” وابتدأ تغريبته بيننا وأرغم على النزول في غير أوطانه وسرعان ما ألقى بظلاله على الممارسات الشعريّة. فلقد صارت النصوص التي تخلّت عن الأوزان المتعارفة تحيا بيننا يتيمة غريبة مقصاة. وكثيراً ما تنعت بكونها مجرد محاكاة للوافد الغربي. لذلك تحاط بالريبة، بالشكّ، بالخوف من كونها إنما تمثّل تصدّعاً خطيراً في مسار الشعريّة العربيّة. ولنا أن نسمع في صوت كلّ شاعر عربي معاصر اختار الخروج على الأوزان المتعارفة رغبة عاتية في تأكيد الانتماء إلى الشعرية العربية. لذلك سيحرص الوعي التحديثي على تأصيل هذه الممارسة الشعرية. ومحنة البحث عن جذور محتملة أو مفترضة في التراث العربي. فيشرع مطلق الأصالة في العمل من جديد.ا
لكن الخطابات النقدّية التحديثية ظلت تستقدم التراث، لا للشروع في استكشافه، وتملّكه ومفارقته بافتتاح ممكناته ومحتملاته، بل تستدعيه لينوب عنها في الإجابة على أسئلة الراهن. وههنا بالضبط تنكشف القدامة المتوارية هناك عميقاً في صميم هذا الوعي تعمل لا تكلّ. هذه القدامة المتكتّمة على نفسها هي التي جعلته يحتمي بالمصطلحات المنتزعة من منابتها قهراً واغتصاباً أو يلوذ بالتراث عند مواجهته للمتغيّرات، حتى لكأن التراث وعاء يحتوي على إجابات لكلّ الأسئلة المطروح منها وما سيأتي. هذه القدامة المواربة المتوارية على نفسها في صميم الوعي التحديثي هي التي جعلته يرفض أن يهب ما من التراث لا يمكن أن يستمرّ فرصة المضيّ فعلاً.ا
لذلك يكفي أن نعيد مساءلة الخطاب النقدي العربي، ومساءلة أطروحاته وكيفيات صياغته لأسئلته وسندرك أن بروكروست، الملّقب أيضاً داماستيس وبوليبمون، لم يكن شخصاً بل كان شبحاً. وواهماً كان البطل الصنديد ثيسيوس حين ظنّ أنه قد صرعه وأباده وخلّص العالم من شروره في سالف الزمان: إن الشبح لا يموت.ا
كثيراً ما اعتبرت الكتابة محاورة بين شخصين مفترضين: واضع النص ومتلّقيه. وكثيراً ما اعتبر المبدع باثّاً وواضع رسالة. وعُدَّ المتلّقي بمثابة طرف فاعل في إنجاح فعل المحاورة ذاك لأنه هو الذي يتأوّل النص ويفكّ مغالقه ورموزه وإشاراته وفق نسق، بموجبه، يصبح طرفاً في عمليّة الإبداع ذاتها. والثابت أن تفريع أطراف الخطاب على هذا النحو إنما يمثّل أهمّ المقترحات التي عليها مدار أغلب الدراسات الحديثة التي يتوهّم أصحابها أن تحويل النقد إلى “علم” مسألة في المتناول يمكن أن تتحقّق وتنجز باستقدام المفاهيم والمصطلحات والتسميات التي عليها مدار المناهج المستحدثة في الثقافات الغربية.ب
إنَّ التركيز على المبدِع باعتباره باثّاً، وعلى المتلقّي باعتباره متقبّلاً كثيراً ما يؤدّي، لاسيّما عند الأكاديميين المولعين بتطبيق المناهج والنظريات تطبيقاً مدرسيّاً، إلى إفقار اللغة والكلمات. فتعامل اللغة على أنها نظام علامات. وتصبح، تحت مفعولات هذه النظرة المتعالمة، مجرّد قناة واصلة بين طرفين. أما الكلمات فإنها تُعامَل على أنها مجرّد دوال حوامل لمداليل يمكن تفكيكها وتركيبها وتوليفها مثل لعبة المربكات بالضبط.ب
عديدة هي الدراسات الأسلوبيّة والألسنيّة التي توغلت في هذا المتاه. فصارت تتشكل مشغولة بإثبات مقدّماتها ومقرّراتها ومصطلحاتها. وبذلك تحوّلت القراءة إلى تشظيّة وتشريح ومعادلات حسابيّة تُعْنَى بعدد الأحرف والكلمات والأصوات. فتقتطع من النصوص ما يمكّنها من ضبط جداولها ورسومها البيانية، وما يضمن لها أن تطبّق على النصوص العربيّة ما تيسّر لها انتزاعه من المناهج المستحدثة في الثقافات الغربيّة وما أمكنها خلعه من منابته والنزول به في غير أوطانه. وبذلك يصبح النص المدروس موضوع سؤال لكن الذي صاغ السؤال إنما هو هذا الآخر الغربي. فتوهم الذات بأنها تستمدّ حركيتها من الداخل في ما هي إنما تحاكي حركية غيرها لتتوهم في ما بعد بأنها تشاركه منجزاته. وأنّى لمن لا يؤسس سؤاله أن يجدد مصيره!.. إن تلك المفاهيم والمصطلحات تحلّ بيننا مضناة، ذليلة، يتيمة، مجوّفة، ندرك حين نتملاّها أنها تعاني من عنت الفقد وهول الفرقة. وكثيراً ما تتلفّت في السرّ مشرئبّة بأعناقها إلى أوطانها. حتى لكأنها تهفو إلى كسر أطواقها وتنشد الهبوط من صلبانها. وعلى هذه الحال تكون النصوص المدروسة لأن الناقد الذي يطبّق المصطلحات المستقدمة قهراً وإرغاماً لا يؤسس خطاباً ولا يصوغ سؤالاً بل يلبس قناعاً من أقنعة بروكروست وتستدرج النصوص إلى سرير الويلات.ب
كان بروكروست، الملقّب أيضاً داماستيس وبوليبمون، قاطع طريق منقطع النظير. كان يعيش على الطريق الرابطة بين ميغارا وأثينا، مدّوخاً العالم. فلقد ابتدع طريقة شيطانية في قتل المسافرين الغرباء الذين يمرّون ببيته. كان له سريران، أحدهما قصير والثاني طويل. وكان يرغم كلّ من يمرّ به من المسافرين على أن يستلقي فوق أحدهما. فإذا كان قصير القامة أجبره على أن يستلقي فوق السرير الطويل حتى إذا بدا أقصر من السرير مطّه بوحشيّة لا مثيل لها وخلعه خلعاً كي تلامس قدماه حافتي السرير. وإذا كان طويل القامة أرغمه على أن يستلقي على السرير القصير. وبالمنشار ينشر رجليه بمقدار الزيادة. وحين التقى البطل الصنديد ثيسيوس بالشقي بروكروست نازله وهزمه وأهلكه بالطريقة التي كان يقتل بها المسافرين الغرباء منكودي الحظّ.ت
للتطبيقات المدرسيّة الرائجة بيننا مخاطرها وويلاتها. إنها تعامل اللغة على أنها نظام معنى، نظام محدّد معلوم، نظام مضبوط القواعد والقوانين والوظائف، وتقرأ النص الإبداعي في ضوء ما تستقدمه من مفاهيم منتزعة انتزاعاً من الثقافات الغربيّة. وههنا بالضبط ينكشف ما يظلّ خافياً في تلاوين هذه المقاربات التي تطرح نفسها باعتبارها “علماً”: ثمّة وراء الإصرار على انتحال اسم “العلم” وإسناده إلى النقد عمليّة تستّر على رؤية ميتافيزيقية في منتهى الخطورة، رؤية تحسب اللغة نظاماً مكتملاً موجوداً. فلا ترى المحتمل والمفاجئ والممكن. لذلك تُعْنَى بالكلمات من جهة كونها تكشف وتبين وتفصح. والحال أن الكلمات كثيراً ما تخفي وتحجب وتمحو. وهذا الذي تمحوه الكلمات وتحجبه يظلّ يتردّد في تلاوين النصّ كأثر أو كوشم أو كرجع صدى بعيد. لذلك يكفي أن نصغي إلى النصوص وسنكتشف أن للكلمات ذاكرة مترامية حدودها فوق كلّ حدود. وهذا ما يمنح الكتابة بعدها الوجودي وقاعها التاريخي: إنها جسد متحوّل لأنّ كلّ نص ينجز إنما يحوّر جسد الكتابة ويفتح اللّغة على مالم تقله أو على مالم تتعوّد قوله. ومن هنا تستمدّ الكتابة الإبداعيّة خطرها باعتبارها حدثاً متحوّلاً يستبطن تحوّلات الكائن وتحوّلات الوجود.ت
توهم هذه الخطابات بأنها تهتدي بمنجزات الآخر وتغتذي بها فيما هي تروّج لمقولة كونية التماثل وتمحو إمكانية التفكير في مقولة كونية الاختلاف. دون أن يقع التفطّن إلى أن مقولة كونية التماثل تخفي وراءها وجهاً توسّعياً وعدوانياً على العالم وشعوبه وثقافاته. لأن التماثل إنما هو أخطر ما يتهدد الشعوب وثقافاتها.ت
تتعايش هذه الخطابات المتعالمة في المشهد النقدي مع خطابات أخرى تتشكّل مأخوذة إلى حد الهوس بمقولة الهوية حريصة على تأصيل ما تبتدعه وتنجزه. هذا ما جعلها تبحث في القديم العربي عما يخدم متعلّقها ويلبّي رغبتها في الإقناع بأنها تواصل ذلك القديم في ماهي تصدر عنه. وترفض أن تمنح الماضي فرصة المضيّ فعلاً.ت
ولا يقع التفطّن هنا أيضاً إلى أن في الالتفات الدّائم إلى الماضي بغية التأصيل وإثبات “الشرعية التاريخيّة”، تكريساً للتوجّه القدامى الميتافيزيقي الذي يبحث في الماضي عن أجوبة لأسئلة الراهن وهو توجه من شأنه أن يجعل الفعل الإبداعي في حضرة مكائد يعجز عن مواجهتها والإفلات من حبائلها وشراكها.ت
لذلك يدرك الناظر في الخطاب النقدي الذي رافق مسار تحوّلات الممارسات الشعريّة أن النقد ظلّ في أشد لحظات انتصاره للتغييرات التي ما فتئت تطال هذه الممارسات، يمارس عليها من الكيد ما يحجب منجزاتها، ويعطّل تناميها ويحدّ من اندفاعاتها. ولم تأتِ هذه المكائد من قبيل الاتفاق والبخت. إنها ترجمة فعليّة لما يربض في أقاصي الفكر النقدي من رعب من المحتملات والممكنات وهي تعبير عن إصراره على التمسّك بوهمين في منتهى الخطورة: مطلق الهوية ومطلق الكونيّة.ت
من هنا تتسلّل القدامة إلى أشدّ الخطابات النقديّة تبشيراً بالتغاير مع القديم العربي تتلقّفها وتشرع في العمل. ومن هنا أيضاً تضيع الحدود الفاصلة بين القدامة والتأصيل. والحال أن القدامة توجّه ينشدُّ على الماضي يهفو إلى عادة إنتاجه. أما التأصيل فإنه إنما يعلن عن نفسه في شكل حركة منشدّة إلى الآتي. وهو، في الآن نفسه، بحث عمّا حدث في الماضي، وما كان ممكن الحدوث ولم يحدث قصد جعله ممكناً هنا والآن، وذلك بفتح الماضي على احتمالاته. إن التأصيل حدث ينشد فتح الزمن على ممكناته واحتمالاته ويهفو إلى جعل الممارسات الفكرية والفنية تشرع في ارتياد ما اعتبر، قديماً، أفق مستحيلها.ت
هذا في رأيي ما ظلّ غائباً أو يكاد في خطاب الحداثة. إن تبسيط مفهوم التأصيل وإفقاره ما فتئ يحوّل الخطابات النقديّة إلى حبائل وشراك تحدّ من اندفاعات النص الإبداعي وتحجب منجزاته. فيكون نكوص. ويكون ارتداد. وإذ الأسئلة نفسها تستعاد جيلاً بعد جيل.ل
هذا الارتداد سيتلقّف الرؤى، ويلوّن المواقف، ويتحكّم بالسلوكات لاسيّما في اللحظات التي توضع فيها الممارسة الشعريّة في حضرة ممكناتها. سيعلن عن نفسه صريحاً لحظة انفجار نظام الشطرين وتفتتح قصيدة التفعيلة تاريخها محاصرة بالإدانة بالتشهير بالفضح. وسيحدّثنا طه حسين أحد رموز الفكر الحداثيّ العربي قائلاً: “إن الشعراء الجدد لم يحفظوا الأمانة ولم ينشئوا مكان الأدب الذي أهملوه أدباً جيّداً وإنما أنشؤوا لهواً ولعباً.”. لن يكتفي طه حسين بإدانة هذا الشعر بل يصل إلى حدّ استعداء الدولة على الشعراء زعماً أنها لا تحمي الشعر العربي “من عبث العابثين ولا تصون حقوقه من عدوان المعتدين، ولا تردّ عنه بغي الباغين.”. ههنا يندرج أيضاً كتاب نازك الملائكة “قضايا الشعر المعاصر”، فهو يبشر بالنكوص والارتداد إذ جزمت نازك بأن “الخروج على نظام الشطرين ليس سوى حركة ستبلغ نهاياتها المبتذلة… ولسوف يرتدّ عنها أغلب الذين استجابوا لها.”ل
لذلك حين نقرأ التسميّة التي أطلقت على الممارسات الشعريّة التي كرّست هذا الخروج سرعان ما ندرك أن مصطلح “الشعر الحر”، الذي استقدمته نازك الملائكة، ليس سوى تسمية ماكرة تضعنا في حضرة النقد وهو يمعن في نسج مكائده وفتل أحابيله ونسج شراكه ليحدّ من اندفاعات الممارسة الشعريّة ويلغي محتملاتها وممكناتها.ل
فلقد جزمت نازك الملائكة التي استقدمت المصطلح من الثقافة الغربية بأن الشعر إنما هو أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل وجزمت بأن الشعر الحر ظاهرة عروضيّة قبل كل شيء. غير أن الكيفية التي تمّ بها نقل هذا المصطلح وتحويله عن مقاديره والنزول به في غير أوطانه بعد إفراغه من محتواه، تكشف هي الأخرى ما لمطلق الهويّة ولمطلق الأصالة من سطوة في الوعي الحداثي العربي.ل
ثمّة مفارقة شرعت تنخر التسمية من الداخل لحظة استقدامها. ثمّة تناقض شرع في العمل والاعتمال. ثمّة فجوة ستظلّ تتسع بين الدال ومدلوله. إن الدال (الشعر الحر)، يضعنا في حضرة ممكنات الكتابة أي التحرر من القيود والإكراهات. والمدلول (أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل) يسدّ الآفاق جميعها في وجه تلك الممكنات والمحتملات.ل
هكذا صارت الحرية حرية مشروطة. وهكذا أمعن الخطاب النقدي في حبك مكائده. إن عمليّة تحويل المصطلح عن دلالته تحمل في تلاوينها حرصاً على تكريس الممنوع ورسم مناطق المحرّم. بل إنه جاء ليجعل مجرّد التفكير في الخروج على القيود والإكراهات المسبّقة أمراً لا مفكّراً فيه أصلاً.ل
هكذا افتتحت التسميّة تاريخها.
هكذا أيضاً نسجت البعض من مكائدها.ل
وتلكم بعض تجلّيات الوعي التحديثي المسكون بالخوف من المحتمل والحرص على حجبه وتغييبه.ل
غير أن قصيدة التفعيلة، هذه القصيدة المطلوب حتفها ستظلّ تمارس اللعب بالبحور المتعارفة فتزاوج بينها، وتمارس اللعب بالتفعيلات أيضاً، وتقلّبها كما الحطب على نار. وبذلك تضع الشعر العربي قدّام محتملاته من جديد. وإذا الرغبة العارمة في تخطّي الوزن تلك الرغبة التي ظلّت تشغل من المشهد الشعري العربي هوامشه تعاود الظهور على نحو عاصف هذه المرّة. أجيال وتجارب شعريّة جاءت تكرّس هذا المحتملات والممكنات.ا
كان الخروج على الوزن إذن. وكان لابدّ من تسميته. ولم تكن التسميّة هذه المرّة أيضاً من ابتداع الخطاب النقدي العربي بل كانت مستقدمة. ههنا يتنزّل الاحتفاء بكتاب سوزان برنار. فلقد عمد أدونيس سنة 1959 إلى تلخيص ما تيسّر منه ليضطلع الكتاب بدور معياري مرجعي. وسيظلّ هذا الكتاب يضطلع بهذا الدور حتى الآن.ا
لقد استقدم مفهوم “قصيدة النثر” وابتدأ تغريبته بيننا وأرغم على النزول في غير أوطانه وسرعان ما ألقى بظلاله على الممارسات الشعريّة. فلقد صارت النصوص التي تخلّت عن الأوزان المتعارفة تحيا بيننا يتيمة غريبة مقصاة. وكثيراً ما تنعت بكونها مجرد محاكاة للوافد الغربي. لذلك تحاط بالريبة، بالشكّ، بالخوف من كونها إنما تمثّل تصدّعاً خطيراً في مسار الشعريّة العربيّة. ولنا أن نسمع في صوت كلّ شاعر عربي معاصر اختار الخروج على الأوزان المتعارفة رغبة عاتية في تأكيد الانتماء إلى الشعرية العربية. لذلك سيحرص الوعي التحديثي على تأصيل هذه الممارسة الشعرية. ومحنة البحث عن جذور محتملة أو مفترضة في التراث العربي. فيشرع مطلق الأصالة في العمل من جديد.ا
لكن الخطابات النقدّية التحديثية ظلت تستقدم التراث، لا للشروع في استكشافه، وتملّكه ومفارقته بافتتاح ممكناته ومحتملاته، بل تستدعيه لينوب عنها في الإجابة على أسئلة الراهن. وههنا بالضبط تنكشف القدامة المتوارية هناك عميقاً في صميم هذا الوعي تعمل لا تكلّ. هذه القدامة المتكتّمة على نفسها هي التي جعلته يحتمي بالمصطلحات المنتزعة من منابتها قهراً واغتصاباً أو يلوذ بالتراث عند مواجهته للمتغيّرات، حتى لكأن التراث وعاء يحتوي على إجابات لكلّ الأسئلة المطروح منها وما سيأتي. هذه القدامة المواربة المتوارية على نفسها في صميم الوعي التحديثي هي التي جعلته يرفض أن يهب ما من التراث لا يمكن أن يستمرّ فرصة المضيّ فعلاً.ا
لذلك يكفي أن نعيد مساءلة الخطاب النقدي العربي، ومساءلة أطروحاته وكيفيات صياغته لأسئلته وسندرك أن بروكروست، الملّقب أيضاً داماستيس وبوليبمون، لم يكن شخصاً بل كان شبحاً. وواهماً كان البطل الصنديد ثيسيوس حين ظنّ أنه قد صرعه وأباده وخلّص العالم من شروره في سالف الزمان: إن الشبح لا يموت.ا