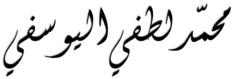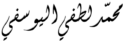في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1970 وضع الكاتب الياباني يوكيو ميشيما حدّا لحياته. لقد اختار الانتحار على طريقة اليابانيين القدامى، طريقة المحاربين النشامى، الطريقة المسمّاة “هراكيري”، تلك الطريقة التي يطلق عليها اليابانيون اسم “سبّكو” (بقر البطن بواسطة حسام مسنون). لم يكن الانتحار لحظة ضعف وهروب من الحياة، بل كان موقف كبرياء واحتجاج. كان انشقاقا وتمرّدا. كان درسا. إنه آخر درس أراد ميشيما أن يتوجّه به إلى اليابانيين وإلى العالم ليفضح فظاعة الغزو الحضاري الغربي ووحشيته.ب
لقد كان ميشيما ، في كل ما كتب، على وعي تام بأن التقدّم العلمي المدوّخ الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إنما يحمل في تلاوينه أخطر ما يمكن أن يتهدد شعوب الأرض قاطبة: نسيان ما يزخر به الماضي من قيم أصيلة واستبدالها بقيم غربية هجينة جاءت توهم بكونيتها وإنسانيتها فيما هي تخفي وجها توسّعيا عدوانيا على العالم وشعوبه وثقافاته.ب
الموت، في الظاهر، حدث نهاية، ولا رجعة. وهو أفول يؤكد أن الكلّ باطل وقبض الريح. لكن طريقة ملاقاته هي التي تفتحه من الداخل على فكرة البطولة. لذلك كثيرا ما يصبح الموت اختيارا تأكيدا للحياة وإعلاء للذات. ههنا تتنزّل طريقة الهراكيري التي اعتمدها ميشيما في ملاقاة الموت. ومن هنا أيضا تستمدّ رمزيتها وبهاءها ومضاءها. لأن الموت، في مثل هذه الحال، إنما يتخذ طابع المنازلة. وفي فعل المنازلة نفسه يصبح الموت إقرارا للحياة.ا
لقد جاء إتلاف ميشيما لنفسه على هذا النحو الفاجع بمثابة نشيد أسود يذكّر اليابانيين جميعا بالفجوة الهائلة التي خلّفها غياب القيم الأصيلة التي ابتنتها الأجيال المتعاقبة في رحلة مواجهتها لنكد الحياة ورعب الوجود. والناظر في كتابات ميشيما كلها يلاحظ، في يسر، أن الكتابة لديه كانت حدث مواجهة وفعل مجابهة. ثمّة في كتاباته جميعها حرص واضح على تخييل الأصول والدعوة إلى تمثّلها وتملّكها من جديد. لقد كان ميشيما يصدر عن نوع من الوعي المأهول بالرعب من الكيفية التي ما فتئت القيم الغربية حمّالة خراب البشر أجمعين تتوسّع بها وتنتشر في العالم مجبرة القيم الأصيلة على التراجع والأفول. إنه الوعي ذاته، الوعي المعذّب المضني الذي صدر عنه ميشال فوكو حين كتب: ” ثمّة موقع معيّن للحصة الغربية التي جرى تأسيسها عبر التاريخ لتؤمّن الأساس الضروري لعلاقة الغرب بالمجتمعات الأخرى بأسرها.”ل
* * *
صار الأصيل غريبا إذن.صار الأصيل غريبا قدّام الهجانة الزاحفة. ولا خيار قدّام الكاتب. لا توسّط أيضا. إن الدروب جميعها مقفلة ولا خلاص إلا بتقديم جسده أو فنّه قربانا لتمجيد الحياة وإعلائها.م
* * *
بهذا حدّثنا ميشيما قبل رحيله الفاجع. كتب في كتابه الأخير “ما الرواية”: “إن حريتي أوسع من أن تتحقق في الكتابة. إنها لتكمن في هذا الخيار: هجر الكتابة أو هجر الحياة.” ولم يكن هذا التصور مجرد موقف من الكتابة بل كان فعل إشهاد على أن العالم المعاصر قد ضاق بالقيم الأصيلة وكنسها من الدنيا كنسا. وهو إشهاد أيضا على محدودية كل فعل إبداعي وعجزه عن النهوض بدور حاسم في التمسّك بالأصول وتخييلها لمقاومة النسيان.ن
إن اختيار الموت راجع إذن إلى الرغبة العاتية في تأكيد الحياة. هل كان ميشيما يدري فيما هو يصوغ هذا الاعتراف أن أيامه قد صارت معدودة؟ هل كان يدري أن اليد التي برعت في استخدام القلم ستنقاد طيعة إلى غواية السيف؟ بالقلم قام ميشيما في كل ما كتبه بتخييل الأصول ومقاومة النسيان. وبالسيف وضع حدّا لحياته، مستعيدا الأصول، مجسّدا طريقة اليابانيين القدامى في ملاقاة الموت ومنازلته. فجأة حدثت التقدمة: تقدمة الجسد والروح قربانا. وعلى عجل انتقل ميشيما من الحاضر زمن التفسّخ والانحلال، زمن الموت قطرة قطرة، إلى زمن أمعن في المضيّ، الزمن الذي كان يزخر بقيم البطولة والشهامة والنبل.ن
هذا هو الدرس إذن، درس ميشيما: لا معنى للكتابة إن هي لم ترتق بالكاتب إلى مستوى التماهي مع قناعاته ومثله وطموحاته. بل إن المبدع لا ينال شرف الاسم إلا إذا تمكّن من محو المسافة الفاصلة بين نصّه وحياته. نيتشه هو الآخر كان قد نبّه إلى أن ما يتهدّد الحياة والإبداع في هذه الأزمنة الحديثة إنما هو الفجوة التي بدأت تنخر الفعل الإبداعي من الداخل على نحو بموجبه صارت العلاقة بين المبدع ونتاجه علاقة اغتراب وانفصام، وكفّ الإبداع عن كونه فعل وجود وتحوّل إلى صناعة تمعن في تغريب الكائن.ت
والناظر في نص “ما الرواية؟” وهو آخر كتاب ظلّ ميشيما يكتبه منذ ربيع 1968 حتى انتحاره في تشرين الثاني من سنة 1970، يلاحظ أن فكرة الموت قد استبدّت بالكاتب وألقت بظلالها على مجمل آرائه. كتب متحدثا عن روايته الأخيرة “بحر الخصوبة”: “حين أفرغ من كتابة هذه الرواية- إن هذه الجملة، في حد ذاتها، إنما تدخل في عداد المحرمات بالنسبة إلي. لأن العالم الذي سيتلقّفني بعد أن أفرغ من كتابة هذه الرواية عالم لا أستطيع أن أتمثّله ولا أريد أن أتخيّله وإني لأجزع منه الجزع كلّه.”م
طويلا ظلت الكتابة من جهة كونها تخييلا للأصول بمثابة منقذ في حياة ميشيما. وعديدة هي المرات التي قاومت فيها اليد التي برعت في استخدام القلم غواية السيف. لكن منازلة الموت باعتبارها تجسيدا للأصول ظلت تضطلع في كتابات ميشيما كلها بدور الخلفية التي ينحدر منها حدث الكتابة ذاته. والثابت أن إطلاع ميشيما على كتاب جورج باطاي “الأيروسية” سنة 1960 سيكون بمثابة لقية نفيسة، لقية فريدة. ومثلما هو الحال في كل حكاية لها عنفها ووهجها، ومثلما اكتملت فرحة جلجامش قديما برفيق دربه انكيدو وافتتحت الملحمة مجراها، سيتخذ ميشيما من جورج باطاي وأطروحاته معينا في رحلة بحثه عن تجسيد الأصول.م
حين قرأ ميشيما سنة 1966 كتاب “الأيروسية” احتفى بجورج باطاي احتفاء عظيما واعتبره رفيق درب استثنائيا. كان ميشيما مفتونا بنيتشه. كان مأخوذا بالكيفيّة التي دفع بها العقل إلى نهاياته واللغة إلى أقاصيها ومضى بحدث الكتابة إلى تخوم حالما بلغتها ضاع الفارق بين الشعر والفلسفة وصار التأسيس الفلسفي تأسيسا شعريا بالأساس. لذلك كتب مهلّلا: “إنه لحريّ بنا أن نسمي هذا الفيلسوف (جورج باطاي) نيتشه الأيروسية.”م
كان نيتشه مأخوذا بالفريد الذي ما يفتأ يعود. كان على وعي تام بأن ربط فكرة الحداثة بمقولة التقدّم سيقود العقل التنويري إلى ظلاميّة مهلكة. لذلك نذر كل مشروعه الفلسفي لهدم الأصنام وفضح الميتافيزيقا. وعن العودة الأبدية للفريد حدّثنا في “هكذا تكلّم زرادشت” قائلا: “سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا الأفعوان، سأعود لحياة جديدة، لا لحياة أفضل ولا لحياة مشابهة، بل إنني سأعود دائما وأبدا إلى هذه الحياة نفسها إجمالا وتفصيلا. لذلك أقول أيضا بعودة جميع الأشياء تكرارا وأبدا.” ولهذا اعتبره ميشيما رفيق درب لا غنى عنه في رحلة البحث عن الأصول.ن
لقد كان ميشيما مأخوذا بفكرة تخييل الأصول لأن العقلانية الغربية، عقلانية النهضة وما تنبني عليه من لا إنسانية وظلامية، لا يمكن أن تواجه، في نظره، إلا بالقيم الجمالية والروحية التي حرصت عقلانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على كنسها ومحوها من جميع الثقافات في الأرض قاطبة. لذلك احتفى بجورج باطاي أيضا وعدّه معلّما لا غنى للمرء عنه وعن تعاليمه في رحلة البحث عن الأصول لانتشالها من النسيان. ذلك أن كتاب “الأيروسية” إنما يتخذ طابعه الانشقاقي من كونه إنما يمثل قراءة جريئة لمحنة الكائن وحيدا منفصلا أعزل مشدودا إلى فرديته الفانية في الوقت الذي يملك فيه “هوسا باتصال أصلي يصله بالكائن عامة. ” إن كتاب “الأيروسية” هو، من هذا المنظور على الأقل، نوع من الهبوط المدوّخ نحو مناطق سحيقة، مناطق معتمة من تغريبة الإنسان ومحنته قدّام رعب الوجود. فالأيروسية ليست مجرد ألهية أو تسلية، بل هي “تعويض للكائن عن شعوره العاتي بالعزلة والانفصال بشعور من الاتصال العميق.” كما يعبّر باطاي نفسه. وهذا يعني أن الحب ليس مجرّد انجذاب إلى الآخر، إلى الصنو والشبيه والحبيب، بل هو قتل للانفصال. وهو من جهة كونه حدث اتّصال يتمّ بين كائنين منفصلين، إنما يعمّق غربة الكائن ويفتح الوجود نفسه على فكرة العدم، لأنه اتصال آني يعقبه انفصال.ت
ا“نحن كائنات منفصلة، أفراد يموتون كلّ على حدة في مغامرة مبهمة. لكننا نملك ذلك الحنين إلى الاتصال المفقود. إننا نعاني من تحمّل الوضع الذي يشدّنا إلى فرديّة المصادفة، إلى الفردية الفانية التي نمثّلها وفي نفس الوقت الذي نملك فيه الرغبة المتوتّرة في استمرار هذا الفاني، نملك أيضا هوسا باتصال أصلي يصلنا بالكائن عامّة.” هكذا يحدّثنا باطاي. إن الحب من هذا المنظور هو ميدان المواجهة: مواجهة الكائن لهشاشته، لعزلته، لانفصاله. إنه فعل وجود. لكنه عتبة مفتوحة على فكرة الموت والعدم. إنه يضعنا دائما بإزاء الموت وفي محاذاة العدم، لأن الاتصال الآني الذي ينتج عن تلاقي المحبين إنما يعمّق إحساس الكائن بعزلته وبفرديته الفانية.ا
هذا هو قدر الكائن إذن. وتلكم هي محنته العاتية الفاجعة. “فالكائنات التي تتناسل هي كائنات متميّزة ومختلفة عن بعضها بعضا. والكائنات المتولّدة عنها متميّزة فيما بينها عن الكائنات التي أنجبتها. وكل كائن متميّز ومختلف عن الآخرين كلهم. ذلك أن ولادته وموته وأحداث حياته قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى الآخرين، لكنه الوحيد المعني بذلك مباشرة. هو وحده الذي يولد. هو وحده الذي يموت. وبين كل كائن وكائن توجد هوّة، يوجد انفصال… هذه الهوة عميقة… ويمكننا جميعا أن نحسّ بدوار هذه الهوّة. ويمكنها أن تفتننا وتجذبنا. هذه الهوّة هي الموت. والموت مدوّخ. إنه فتّان.” الحب والموت صنوان إذن. الحبّ سعادة مؤقّتة. اتصال يعقبه الانفصال. امتلاء يعقبه خلاء مهلك مبيد. لذلك تكون السعادة المتولّدة عن الحب سعادة مضنية دائما. والضنى وجع، ألم، ارتباك يطال الجسد والروح معا. إنه قناع من أقنعة الموت هادم اللذات جميعها. والغبطة التي تنتج عن الحب نتيجة الاتصال بين كائنين منفصلين ليست سوى الحياة في بهائها مفتوحة على الموت ضاريا مكثفا متوحّشا.ا
ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى المعلّمين الكبار، أولئك الذين يؤمنون أن حياة المرء ليست سوى طريقه إلى نفسه كما يعبّر هرمان هيسه، فإن ميشيما لم يكتف بقراءة الكتاب للإطلاع أو للتسلّي، بل اتخذ منه معينا وسندا لاستكشاف نفسه. وفي ضوء أطروحات باطاي عاد ليقرأ ذاته ونتاجه الإبداعي. فكتب محلّلا شخصيات رواياته، معتبرا ما تحفل به تلك الروايات من قسوة وعنف، من قتل وخرق وانتهاك، أمارة على أن نتاجه الإبداعيّ يكرّس أغلب أطروحات باطاي، لأنه نتاج صادر عن روح معذّبة بالفقد، فقد الأصول والقيم التي كانت في ما مضى من الزمان تقي الإنسان من التفسّخ والاهتراء والانحلال، تلك القيم المقدّسة التي كانت تشدّ الإنسان إلى أعلى وتدفع به نحو تجاوز ذاته، وتخطّي هشاشته وضعفه، وترتقي به إلى مصاف الخارق والمتسامي والمقدّس.ا
يكتب مثلا معلّلا انتحار البطل وزوجته في كتابه “اليوكوكي”: “في لحظة تراجيدية قصوى، ودون وعي منهما، احتضن ضابط اليوكوكي وزوجته البرهة الأخيرة من حياتهما وتوغّلا، متلفين حياتيهما، في غياهب الموت ونشوة الغبطة: لقد منحا هذه الغبطة لأنهما إنما اعتنقا المبدأ نفسه، مبدأ اقتران اللذة القصوى بالوجع الجسدي الأقصى… ليلة واحدة، ليلة فريدة يصبح فيها اختيار المكان الذي نموت فيه اختيارا لأشدّ اللحظات فرحا بالحياة. هذه هي غبطتهما. وليس في هذا الاختيار أيّ طعم للهزيمة: فالحبّ الزوجي يبلغ الذروة في هذه اللحظة، ذروة التطهير والنشوة وقد امتزجا.”ل
كان اللقاء بجورج باطاي عاصفا إذن. كان زلزلة. كان نداء أسود من خلاله أمعن الموت في ممارسة سطوته وجاذبيته وفتنته على ميشيما. لقد بدأ التفكير في منازلة الموت يستبدّ بكاتب مبدع نذر مشروعه الإبداعي لتخييل الأصول وفضح عقلانية الغرب وما يتخفىّ وراء القيم الغربية المزدهية بانتشارها من نزوعات استعمارية وتوسعية وعدوانية على ثقافات الشعوب كلّها.ا
إن منازلة الموت وجها لوجه، دون مواربة وبلا مخاتلة أو إرجاء، هي ما يمكن أن يمنح المبدع شرف الاسم، ويرتقي بالكاتب إلى مستوى فنّه وأطروحاته. غير أن المنازلة نفسها لا يمكن أن تصبح تأكيدا للحياة وتمجيدا للحياة إلاّ متى كانت عاتية قاسية كالموت في توحّشه وقسوته وفظاعته.سيكتب ميشيما في الكتاب نفسه: “إن الانتحار بواسطة الحسام، وما يترتب عنه من وجع فظيع ليعادل، نتيجة ما يرافقه من شرف المنازلة مع الموت، ذاك الشرف الذي يكلّل موت المقاتلين لحظة سقوطهم في ساحات الوغى. فإذا لم نعثر على هذه الليلة، الليلة الفريدة التي نختار فيها مكان موتنا، فإن الغبطة لن تتجلّى في الحياة مطلقا. من أين جئت بهذه القناعة وكيف توصّلت إليها؟ ما أستطيع أن أقوله هو التالي: إن هذه الفكرة ذاتها هي التي تعبّر عمّا تعلّمته من تجاربي في الحرب ومن تجربتي مع نيتشه (الذي قرأته طوال سنوات الحرب). وفي هذه الفكرة أيضا، يجب أن أبحث عن سرّ تعاطفي مع جورج باطاي الذي يمكن أن ننعته بنيتشه الأيروسية.”ا
آن لليد التي برعت في استخدام القلم أن تستسلم لغواية السيف إذن. لكن الانتحار على طريقة “الهراكيري” لم يكن اتّفاقا ولم يأت صدفة كما أوضحت. لقد كان ميشيما على يقين من أن إنسان هذه الأزمنة كائن مجوّف، كائن محشوّ قشّا، تتبعه اللعنة حيثما حلّ، لأنه أشاح بوجهه عن المقدّس. ولا سبيل إلى انتشال الحياة من التّفسّخ والانحلال إلا بتقديم الجسد والروح قربانا لإدراج المقدّس في الذات.”إن حياة الإنسان هي طريقه إلى نفسه. ولم يحصل إنسان ما على الوعي الكلّيّ بذاته حتى الآن. إلاّ أن ذلك هو ما يريده كل إنسان. ثمة من الناس من يحاول تحقيق ذلك بإصرار وعمل متواصلين، ومنهم من يبذل مجهودا أقل، إلا أن الجميع يحملون معهم بقايا مولدهم: اللزوجة وقشور البيض، حتى النهاية.” هكذا حدّثنا هرمان هيس. والناظر في حياة ميشيما وفي مسيرته الفكرية والإبداعية يلاحظ أنه كان منذ شبابه المبكر مأخوذا إلى حدّ الهوس بالبحث عن السبيل التي تخلّص الكائن من اللزوجة وتقيه من التّفسّخ والانحلال. كيف يلاقي المرء قدره ويجد الطريق إلى نفسه ويحقق نجاته؟ا
منذ فترة مبكّرة وجد ميشيما الإجابة على هذا السؤال المضني: لاشيء كالرعب يمكّن من تجديد الوجود وإنقاذ الكائن من اللزوجة. كتب وهو لم يبلغ بعد السنة الخامسة عشرة من عمره:ا
ليلة، فليلة تمرّ الليالي تباعا، وواقفا أظل قرب النافذة
أمنّي النفس بحدوث كارثة،ا
كنت أنتظر أن تتدفّق من الجانب الآخر من المدينة
مثل قوس قزح ليليّ
سحابة من غبار الرزيّة بلا رحمة.ا
إن الرعب وحده كفيل بتجديد الوجود. ولا شيء أشدّ فظاعة وأكثر توحّشا من الموت. ومواجهة الموت اختيارا، مواجهة الموت وجها لوجه دون مواربة أو زيغ، هي الحدث الوحيد الذي يمكن أن يضع المرء في حضرة الرعب مكثّفا.من هذه القناعة انطلق ميشيما حين جعل أبطاله في نص “دروب أرواح الأبطال” يختارون الموت مواجهة، فينقضّون بطائراتهم على جسر حاملة طائرات العدوّ، وكتب “دون وجع، مكفّنا كان بإشراقات نورانية ناصعة البياض، إشراقات تجعل المرء يفقد وعيه، مركّزا حدقتيه على ذلك الخطّ الفضّي المتموج الذي يقترب. لا بدّ أن يجمّع كل قوّاه حتى يبلغ ذروة الوضوح والصفاء: لا بدّ أن يرى، أن يرى ويكشف.” وهذا الذي يكشفه المقاتل الذي اختار الموت (الكاميكاز) في لحظة الموت نفسها إنما هو هذه الحقيقة المدوّخة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مقدرة على الارتقاء إلى ذروة التسامي.ا
هذا التصور ذاته كان قد أرّق جورج باطاي فكتب جازما: “لا بدّ أن يكون المرء قد انخطف بالمقدّس حتى يواجه الموت.” لكن ميشيما يعمد إلى توضيح هذه الرؤية قصد الإمعان في تبيانها والتشديد عليها، فيجعل أبطاله يختارون الموت مواجهة وانتحارا وهم على يقين من أنهم إنما يقدمون أنفسهم قرابين لانتشال الكائن وإقامة المقدسات بعد أن نسيت في هذه الأزمنة الحديثة فصارت الحياة أفرغ من الفراغ، وصار وجود الإنسان على الأرض خلاء.ا
في رواية “طريق أرواح الأبطال” نقرأ قول الأبطال وهم يضحّون بأنفسهم معلنين: “إننا لم نعد نؤمن بوجود شيء غامض على الأرض. سنصبح نحن أنفسنا الغامض والغموض حتى نتمكّن من جعل الناس يشرعون في عبادة شيء ما، ويعتقدون في وجود شيء ما. وموتنا لن يكون سوى التجسيد لذلك الشيء.”هذه السلوكات والأفعال التي تحكمت بأبطال روايات ميشيما، هذا الانشداد إلى القسوة والعنف والقتل، هذا التبشير بالانتحار تمجيدا للذات وإعلاء للكائن، جميعها لم تكن مجرد مواقف وأحداث أملتها مقتضيات النسق الروائي أو قادت إليها كيفيات حبك الحكايات، بل إنها راجعة إلى رؤية ميشيما نفسه للعالم. فلقد كان ميشيما مثل باطاي بالضبط. كان يؤمن إيمانا كليا بالإشراق والانخطاف. وعن الإشراق والانخطاف يحدّث جورج باطاي جازما: “ما معنى الإشراق وما طبيعته؟ فإذا كان توهّج نور الشمس يعميني من الداخل ويشعلني حرائق ونيرانا، فإن زيادة قليل من النور أو نقصانه لا يغيّر من الأمر شيئا. ومهما يكن من أمر، هل نور الإشراقة مثل نور الشمس أم لا؟ ليس هذا مهمّا مادام الإنسان هو الإنسان. أن لا نكون سوى بشر، أن لا نقدر على الانعتاق من هذا النفق، فمعناه أننا نختنق.”ا
رحالة كان ميشيما إذن. عابر سبيل لا يكلّ. غريب مقيم في الترحال والسفر. ومفتونا كان بالغرباء جميعهم، أولئك الذين نذروا كتباتهم لفضح الأصنام وتهزئة الأكاذيب، أولئك الذين رأوا ما تنبني عليه مقولة التقدم الغربي من ليل وظلمات وويلات ستطال البشر أجمعين وتمضي بالكائن قُدُما إلى خرابه. كان احتفاؤه بنيتشه عظيما. “وكان احتفاؤه بجورج باطاي وبودلير وأندريه مالرو وجون جينيه عظيما هو الآخر.” يكتب مثلا في كتابه “بحر الخصوبة”: “أن يكون المرء إنسانا حركيا وصاحب قلم في الآن نفسه، أن يكون هو القائل وهو موضوع القول، هو الحاكم والمحكوم، أن يكون في النهاية محكوما بالإعدام وهو الذي ينفّذ حكم الإعدام، هذا هو الإشكال الصعب الذي يستحقّ فعلا أن ننعته بكون مأزقا حديثا. وهو الإشكال الذي طرحه بودلير في ما مضى من الزمان. وهو عينه الإشكال الذي تمكّنت روايات أندريه مالرو في القرن العشرين من ابتناء النموذج المجسّد له.”ا
لقد كان ميشيما على يقين من أن “الشقاء لن ينتهي من العالم”. وقبله لهج فان كوخ بهذه الجملة وهو يحتضر بعد أن أطلق النار على نفسه. هل الشقاء هو نصيب الإنسان تحت الشمس؟ اليتم والمنزلة البشرية صنوان إذن. وميشيما قد كان مأخوذا بهذا البرق. كان مأسورا في هذه الدائرة، دائرة الوعي التراجيدي بأن العدم هو الذي يمدّ الوجود بالمعنى. والمعنى إنما يتأتّى من حدث منازلة العدم اختيارا. لا انتظار إذن. لا إرجاء أيضا. على المرء أن يختار. عليه أن يتشوّف تباشير تلكم اللحظة الفريدة، لحظة التقدمة. وعليه أيضا أن يختار مكان موته. يكتب متحدّثا عن هذا القدر العاتي: “مرغم هو المرء على أن يكدح، يحثّ الخطى ويبذل الجهد. ومرغم هو أيضا، على أن يتلقّى من الضربات ما يودي به إلى السقوط. هذا هو نصيب الإنسان.”ا
طويلا كان استخدام القلم ينوب عن الاحتماء بالسيف. وعديدة هي المرات التي كانت فيها غواية السيف تستبدّ باليد التي برعت في استخدام القلم. فلقد كان ميشيما يتخذ من الكتابة كشّافا أو دليلا ليجد “الطريق إلى نفسه”. لم تكن الكتابة تسلية أو صناعة وحرفة. كانت فعل وجود. وكان ميشيما على يقين من أن تخييل الأصول بواسطة الكتابة لا يمكن أن ينوب عن تجسيد الأصول على طريقة المقاتل الياباني القديم، ذاك الذي كان يحيا في منطقة الخطر منتظرا اللحظة الفريدة، لحظة ملاقاة الموت ومنازلته. لذلك ألحّ على أن لا خيار قدّام الكتابة وقدّام كل فعل إبداعيّ إلا المواجهة، مواجهة السقطة القاسية التي يحياها الكائن. يكتب مثلا: “لا يمكن لأية رواية مهما كانت أن تجسّد، وصفا أو تخييلا، ذلك الرعب الذي يطبق على الكون حين يأتي المساء… إن قدر روايتي ليكمن في تناولي ارتباكات بني البشر من جهة كونهم مجرّد بشر. وما تقدر الرواية أن تقوله من هذا الموضوع ليس سوى حطام ومزق من اليأس المتولّد عن امتزاج الحب بالاندهاش من لامعقولية بني البشر.”ا
ولأن تخييل الأصول لا يمكن أن يغني عن تجسيد الأصول، لأن ميشيما كان على يقين من أن الكتابة ليست سوى بحث مضن عن السبيل المؤدّية إلى الذات، لأن حياة الإنسان ليست سوى طرقه إلى نفسه، ولأن خلاص المرء مشروط بوقوعه على اللحظة الفريدة التي يتمكّن خلالها من منازلة عدمه الخاص – لهذا كلّه- كان من الطبيعي أن تستسلم اليد التي برعت في استخدام القلم لغواية السيف ذات مساء.ا
في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1970 وضع الكاتب الياباني يوكيو ميشيما حدّا لحياته. لقد اختار الانتحار على طريقة اليابانيين القدامى، طريقة المحاربين النشامى، الطريقة المسمّاة “هراكيري”، تلك الطريقة التي يطلق عليها اليابانيون اسم “سبّكو” (بقر البطن بواسطة حسام مسنون). لم يكن الانتحار لحظة ضعف وهروب من الحياة، بل كان موقف كبرياء واحتجاج. كان انشقاقا وتمرّدا. كان درسا. إنه آخر درس أراد ميشيما أن يتوجّه به إلى اليابانيين وإلى العالم ليفضح فظاعة الغزو الحضاري الغربي ووحشيته.ب
لقد كان ميشيما ، في كل ما كتب، على وعي تام بأن التقدّم العلمي المدوّخ الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إنما يحمل في تلاوينه أخطر ما يمكن أن يتهدد شعوب الأرض قاطبة: نسيان ما يزخر به الماضي من قيم أصيلة واستبدالها بقيم غربية هجينة جاءت توهم بكونيتها وإنسانيتها فيما هي تخفي وجها توسّعيا عدوانيا على العالم وشعوبه وثقافاته.ب
الموت، في الظاهر، حدث نهاية، ولا رجعة. وهو أفول يؤكد أن الكلّ باطل وقبض الريح. لكن طريقة ملاقاته هي التي تفتحه من الداخل على فكرة البطولة. لذلك كثيرا ما يصبح الموت اختيارا تأكيدا للحياة وإعلاء للذات. ههنا تتنزّل طريقة الهراكيري التي اعتمدها ميشيما في ملاقاة الموت. ومن هنا أيضا تستمدّ رمزيتها وبهاءها ومضاءها. لأن الموت، في مثل هذه الحال، إنما يتخذ طابع المنازلة. وفي فعل المنازلة نفسه يصبح الموت إقرارا للحياة.ا
لقد جاء إتلاف ميشيما لنفسه على هذا النحو الفاجع بمثابة نشيد أسود يذكّر اليابانيين جميعا بالفجوة الهائلة التي خلّفها غياب القيم الأصيلة التي ابتنتها الأجيال المتعاقبة في رحلة مواجهتها لنكد الحياة ورعب الوجود. والناظر في كتابات ميشيما كلها يلاحظ، في يسر، أن الكتابة لديه كانت حدث مواجهة وفعل مجابهة. ثمّة في كتاباته جميعها حرص واضح على تخييل الأصول والدعوة إلى تمثّلها وتملّكها من جديد. لقد كان ميشيما يصدر عن نوع من الوعي المأهول بالرعب من الكيفية التي ما فتئت القيم الغربية حمّالة خراب البشر أجمعين تتوسّع بها وتنتشر في العالم مجبرة القيم الأصيلة على التراجع والأفول. إنه الوعي ذاته، الوعي المعذّب المضني الذي صدر عنه ميشال فوكو حين كتب: ” ثمّة موقع معيّن للحصة الغربية التي جرى تأسيسها عبر التاريخ لتؤمّن الأساس الضروري لعلاقة الغرب بالمجتمعات الأخرى بأسرها.”ل
* * *
صار الأصيل غريبا إذن.صار الأصيل غريبا قدّام الهجانة الزاحفة. ولا خيار قدّام الكاتب. لا توسّط أيضا. إن الدروب جميعها مقفلة ولا خلاص إلا بتقديم جسده أو فنّه قربانا لتمجيد الحياة وإعلائها.م
* * *
بهذا حدّثنا ميشيما قبل رحيله الفاجع. كتب في كتابه الأخير “ما الرواية”: “إن حريتي أوسع من أن تتحقق في الكتابة. إنها لتكمن في هذا الخيار: هجر الكتابة أو هجر الحياة.” ولم يكن هذا التصور مجرد موقف من الكتابة بل كان فعل إشهاد على أن العالم المعاصر قد ضاق بالقيم الأصيلة وكنسها من الدنيا كنسا. وهو إشهاد أيضا على محدودية كل فعل إبداعي وعجزه عن النهوض بدور حاسم في التمسّك بالأصول وتخييلها لمقاومة النسيان.ن
إن اختيار الموت راجع إذن إلى الرغبة العاتية في تأكيد الحياة. هل كان ميشيما يدري فيما هو يصوغ هذا الاعتراف أن أيامه قد صارت معدودة؟ هل كان يدري أن اليد التي برعت في استخدام القلم ستنقاد طيعة إلى غواية السيف؟ بالقلم قام ميشيما في كل ما كتبه بتخييل الأصول ومقاومة النسيان. وبالسيف وضع حدّا لحياته، مستعيدا الأصول، مجسّدا طريقة اليابانيين القدامى في ملاقاة الموت ومنازلته. فجأة حدثت التقدمة: تقدمة الجسد والروح قربانا. وعلى عجل انتقل ميشيما من الحاضر زمن التفسّخ والانحلال، زمن الموت قطرة قطرة، إلى زمن أمعن في المضيّ، الزمن الذي كان يزخر بقيم البطولة والشهامة والنبل.ن
هذا هو الدرس إذن، درس ميشيما: لا معنى للكتابة إن هي لم ترتق بالكاتب إلى مستوى التماهي مع قناعاته ومثله وطموحاته. بل إن المبدع لا ينال شرف الاسم إلا إذا تمكّن من محو المسافة الفاصلة بين نصّه وحياته. نيتشه هو الآخر كان قد نبّه إلى أن ما يتهدّد الحياة والإبداع في هذه الأزمنة الحديثة إنما هو الفجوة التي بدأت تنخر الفعل الإبداعي من الداخل على نحو بموجبه صارت العلاقة بين المبدع ونتاجه علاقة اغتراب وانفصام، وكفّ الإبداع عن كونه فعل وجود وتحوّل إلى صناعة تمعن في تغريب الكائن.ت
والناظر في نص “ما الرواية؟” وهو آخر كتاب ظلّ ميشيما يكتبه منذ ربيع 1968 حتى انتحاره في تشرين الثاني من سنة 1970، يلاحظ أن فكرة الموت قد استبدّت بالكاتب وألقت بظلالها على مجمل آرائه. كتب متحدثا عن روايته الأخيرة “بحر الخصوبة”: “حين أفرغ من كتابة هذه الرواية- إن هذه الجملة، في حد ذاتها، إنما تدخل في عداد المحرمات بالنسبة إلي. لأن العالم الذي سيتلقّفني بعد أن أفرغ من كتابة هذه الرواية عالم لا أستطيع أن أتمثّله ولا أريد أن أتخيّله وإني لأجزع منه الجزع كلّه.”م
طويلا ظلت الكتابة من جهة كونها تخييلا للأصول بمثابة منقذ في حياة ميشيما. وعديدة هي المرات التي قاومت فيها اليد التي برعت في استخدام القلم غواية السيف. لكن منازلة الموت باعتبارها تجسيدا للأصول ظلت تضطلع في كتابات ميشيما كلها بدور الخلفية التي ينحدر منها حدث الكتابة ذاته. والثابت أن إطلاع ميشيما على كتاب جورج باطاي “الأيروسية” سنة 1960 سيكون بمثابة لقية نفيسة، لقية فريدة. ومثلما هو الحال في كل حكاية لها عنفها ووهجها، ومثلما اكتملت فرحة جلجامش قديما برفيق دربه انكيدو وافتتحت الملحمة مجراها، سيتخذ ميشيما من جورج باطاي وأطروحاته معينا في رحلة بحثه عن تجسيد الأصول.م
حين قرأ ميشيما سنة 1966 كتاب “الأيروسية” احتفى بجورج باطاي احتفاء عظيما واعتبره رفيق درب استثنائيا. كان ميشيما مفتونا بنيتشه. كان مأخوذا بالكيفيّة التي دفع بها العقل إلى نهاياته واللغة إلى أقاصيها ومضى بحدث الكتابة إلى تخوم حالما بلغتها ضاع الفارق بين الشعر والفلسفة وصار التأسيس الفلسفي تأسيسا شعريا بالأساس. لذلك كتب مهلّلا: “إنه لحريّ بنا أن نسمي هذا الفيلسوف (جورج باطاي) نيتشه الأيروسية.”م
كان نيتشه مأخوذا بالفريد الذي ما يفتأ يعود. كان على وعي تام بأن ربط فكرة الحداثة بمقولة التقدّم سيقود العقل التنويري إلى ظلاميّة مهلكة. لذلك نذر كل مشروعه الفلسفي لهدم الأصنام وفضح الميتافيزيقا. وعن العودة الأبدية للفريد حدّثنا في “هكذا تكلّم زرادشت” قائلا: “سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا الأفعوان، سأعود لحياة جديدة، لا لحياة أفضل ولا لحياة مشابهة، بل إنني سأعود دائما وأبدا إلى هذه الحياة نفسها إجمالا وتفصيلا. لذلك أقول أيضا بعودة جميع الأشياء تكرارا وأبدا.” ولهذا اعتبره ميشيما رفيق درب لا غنى عنه في رحلة البحث عن الأصول.ن
لقد كان ميشيما مأخوذا بفكرة تخييل الأصول لأن العقلانية الغربية، عقلانية النهضة وما تنبني عليه من لا إنسانية وظلامية، لا يمكن أن تواجه، في نظره، إلا بالقيم الجمالية والروحية التي حرصت عقلانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على كنسها ومحوها من جميع الثقافات في الأرض قاطبة. لذلك احتفى بجورج باطاي أيضا وعدّه معلّما لا غنى للمرء عنه وعن تعاليمه في رحلة البحث عن الأصول لانتشالها من النسيان. ذلك أن كتاب “الأيروسية” إنما يتخذ طابعه الانشقاقي من كونه إنما يمثل قراءة جريئة لمحنة الكائن وحيدا منفصلا أعزل مشدودا إلى فرديته الفانية في الوقت الذي يملك فيه “هوسا باتصال أصلي يصله بالكائن عامة. ” إن كتاب “الأيروسية” هو، من هذا المنظور على الأقل، نوع من الهبوط المدوّخ نحو مناطق سحيقة، مناطق معتمة من تغريبة الإنسان ومحنته قدّام رعب الوجود. فالأيروسية ليست مجرد ألهية أو تسلية، بل هي “تعويض للكائن عن شعوره العاتي بالعزلة والانفصال بشعور من الاتصال العميق.” كما يعبّر باطاي نفسه. وهذا يعني أن الحب ليس مجرّد انجذاب إلى الآخر، إلى الصنو والشبيه والحبيب، بل هو قتل للانفصال. وهو من جهة كونه حدث اتّصال يتمّ بين كائنين منفصلين، إنما يعمّق غربة الكائن ويفتح الوجود نفسه على فكرة العدم، لأنه اتصال آني يعقبه انفصال.ت
ا“نحن كائنات منفصلة، أفراد يموتون كلّ على حدة في مغامرة مبهمة. لكننا نملك ذلك الحنين إلى الاتصال المفقود. إننا نعاني من تحمّل الوضع الذي يشدّنا إلى فرديّة المصادفة، إلى الفردية الفانية التي نمثّلها وفي نفس الوقت الذي نملك فيه الرغبة المتوتّرة في استمرار هذا الفاني، نملك أيضا هوسا باتصال أصلي يصلنا بالكائن عامّة.” هكذا يحدّثنا باطاي. إن الحب من هذا المنظور هو ميدان المواجهة: مواجهة الكائن لهشاشته، لعزلته، لانفصاله. إنه فعل وجود. لكنه عتبة مفتوحة على فكرة الموت والعدم. إنه يضعنا دائما بإزاء الموت وفي محاذاة العدم، لأن الاتصال الآني الذي ينتج عن تلاقي المحبين إنما يعمّق إحساس الكائن بعزلته وبفرديته الفانية.ا
هذا هو قدر الكائن إذن. وتلكم هي محنته العاتية الفاجعة. “فالكائنات التي تتناسل هي كائنات متميّزة ومختلفة عن بعضها بعضا. والكائنات المتولّدة عنها متميّزة فيما بينها عن الكائنات التي أنجبتها. وكل كائن متميّز ومختلف عن الآخرين كلهم. ذلك أن ولادته وموته وأحداث حياته قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى الآخرين، لكنه الوحيد المعني بذلك مباشرة. هو وحده الذي يولد. هو وحده الذي يموت. وبين كل كائن وكائن توجد هوّة، يوجد انفصال… هذه الهوة عميقة… ويمكننا جميعا أن نحسّ بدوار هذه الهوّة. ويمكنها أن تفتننا وتجذبنا. هذه الهوّة هي الموت. والموت مدوّخ. إنه فتّان.” الحب والموت صنوان إذن. الحبّ سعادة مؤقّتة. اتصال يعقبه الانفصال. امتلاء يعقبه خلاء مهلك مبيد. لذلك تكون السعادة المتولّدة عن الحب سعادة مضنية دائما. والضنى وجع، ألم، ارتباك يطال الجسد والروح معا. إنه قناع من أقنعة الموت هادم اللذات جميعها. والغبطة التي تنتج عن الحب نتيجة الاتصال بين كائنين منفصلين ليست سوى الحياة في بهائها مفتوحة على الموت ضاريا مكثفا متوحّشا.ا
ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى المعلّمين الكبار، أولئك الذين يؤمنون أن حياة المرء ليست سوى طريقه إلى نفسه كما يعبّر هرمان هيسه، فإن ميشيما لم يكتف بقراءة الكتاب للإطلاع أو للتسلّي، بل اتخذ منه معينا وسندا لاستكشاف نفسه. وفي ضوء أطروحات باطاي عاد ليقرأ ذاته ونتاجه الإبداعي. فكتب محلّلا شخصيات رواياته، معتبرا ما تحفل به تلك الروايات من قسوة وعنف، من قتل وخرق وانتهاك، أمارة على أن نتاجه الإبداعيّ يكرّس أغلب أطروحات باطاي، لأنه نتاج صادر عن روح معذّبة بالفقد، فقد الأصول والقيم التي كانت في ما مضى من الزمان تقي الإنسان من التفسّخ والاهتراء والانحلال، تلك القيم المقدّسة التي كانت تشدّ الإنسان إلى أعلى وتدفع به نحو تجاوز ذاته، وتخطّي هشاشته وضعفه، وترتقي به إلى مصاف الخارق والمتسامي والمقدّس.ا
يكتب مثلا معلّلا انتحار البطل وزوجته في كتابه “اليوكوكي”: “في لحظة تراجيدية قصوى، ودون وعي منهما، احتضن ضابط اليوكوكي وزوجته البرهة الأخيرة من حياتهما وتوغّلا، متلفين حياتيهما، في غياهب الموت ونشوة الغبطة: لقد منحا هذه الغبطة لأنهما إنما اعتنقا المبدأ نفسه، مبدأ اقتران اللذة القصوى بالوجع الجسدي الأقصى… ليلة واحدة، ليلة فريدة يصبح فيها اختيار المكان الذي نموت فيه اختيارا لأشدّ اللحظات فرحا بالحياة. هذه هي غبطتهما. وليس في هذا الاختيار أيّ طعم للهزيمة: فالحبّ الزوجي يبلغ الذروة في هذه اللحظة، ذروة التطهير والنشوة وقد امتزجا.”ل
كان اللقاء بجورج باطاي عاصفا إذن. كان زلزلة. كان نداء أسود من خلاله أمعن الموت في ممارسة سطوته وجاذبيته وفتنته على ميشيما. لقد بدأ التفكير في منازلة الموت يستبدّ بكاتب مبدع نذر مشروعه الإبداعي لتخييل الأصول وفضح عقلانية الغرب وما يتخفىّ وراء القيم الغربية المزدهية بانتشارها من نزوعات استعمارية وتوسعية وعدوانية على ثقافات الشعوب كلّها.ا
إن منازلة الموت وجها لوجه، دون مواربة وبلا مخاتلة أو إرجاء، هي ما يمكن أن يمنح المبدع شرف الاسم، ويرتقي بالكاتب إلى مستوى فنّه وأطروحاته. غير أن المنازلة نفسها لا يمكن أن تصبح تأكيدا للحياة وتمجيدا للحياة إلاّ متى كانت عاتية قاسية كالموت في توحّشه وقسوته وفظاعته.سيكتب ميشيما في الكتاب نفسه: “إن الانتحار بواسطة الحسام، وما يترتب عنه من وجع فظيع ليعادل، نتيجة ما يرافقه من شرف المنازلة مع الموت، ذاك الشرف الذي يكلّل موت المقاتلين لحظة سقوطهم في ساحات الوغى. فإذا لم نعثر على هذه الليلة، الليلة الفريدة التي نختار فيها مكان موتنا، فإن الغبطة لن تتجلّى في الحياة مطلقا. من أين جئت بهذه القناعة وكيف توصّلت إليها؟ ما أستطيع أن أقوله هو التالي: إن هذه الفكرة ذاتها هي التي تعبّر عمّا تعلّمته من تجاربي في الحرب ومن تجربتي مع نيتشه (الذي قرأته طوال سنوات الحرب). وفي هذه الفكرة أيضا، يجب أن أبحث عن سرّ تعاطفي مع جورج باطاي الذي يمكن أن ننعته بنيتشه الأيروسية.”ا
آن لليد التي برعت في استخدام القلم أن تستسلم لغواية السيف إذن. لكن الانتحار على طريقة “الهراكيري” لم يكن اتّفاقا ولم يأت صدفة كما أوضحت. لقد كان ميشيما على يقين من أن إنسان هذه الأزمنة كائن مجوّف، كائن محشوّ قشّا، تتبعه اللعنة حيثما حلّ، لأنه أشاح بوجهه عن المقدّس. ولا سبيل إلى انتشال الحياة من التّفسّخ والانحلال إلا بتقديم الجسد والروح قربانا لإدراج المقدّس في الذات.”إن حياة الإنسان هي طريقه إلى نفسه. ولم يحصل إنسان ما على الوعي الكلّيّ بذاته حتى الآن. إلاّ أن ذلك هو ما يريده كل إنسان. ثمة من الناس من يحاول تحقيق ذلك بإصرار وعمل متواصلين، ومنهم من يبذل مجهودا أقل، إلا أن الجميع يحملون معهم بقايا مولدهم: اللزوجة وقشور البيض، حتى النهاية.” هكذا حدّثنا هرمان هيس. والناظر في حياة ميشيما وفي مسيرته الفكرية والإبداعية يلاحظ أنه كان منذ شبابه المبكر مأخوذا إلى حدّ الهوس بالبحث عن السبيل التي تخلّص الكائن من اللزوجة وتقيه من التّفسّخ والانحلال. كيف يلاقي المرء قدره ويجد الطريق إلى نفسه ويحقق نجاته؟ا
منذ فترة مبكّرة وجد ميشيما الإجابة على هذا السؤال المضني: لاشيء كالرعب يمكّن من تجديد الوجود وإنقاذ الكائن من اللزوجة. كتب وهو لم يبلغ بعد السنة الخامسة عشرة من عمره:ا
ليلة، فليلة تمرّ الليالي تباعا، وواقفا أظل قرب النافذة
أمنّي النفس بحدوث كارثة،ا
كنت أنتظر أن تتدفّق من الجانب الآخر من المدينة
مثل قوس قزح ليليّ
سحابة من غبار الرزيّة بلا رحمة.ا
إن الرعب وحده كفيل بتجديد الوجود. ولا شيء أشدّ فظاعة وأكثر توحّشا من الموت. ومواجهة الموت اختيارا، مواجهة الموت وجها لوجه دون مواربة أو زيغ، هي الحدث الوحيد الذي يمكن أن يضع المرء في حضرة الرعب مكثّفا.من هذه القناعة انطلق ميشيما حين جعل أبطاله في نص “دروب أرواح الأبطال” يختارون الموت مواجهة، فينقضّون بطائراتهم على جسر حاملة طائرات العدوّ، وكتب “دون وجع، مكفّنا كان بإشراقات نورانية ناصعة البياض، إشراقات تجعل المرء يفقد وعيه، مركّزا حدقتيه على ذلك الخطّ الفضّي المتموج الذي يقترب. لا بدّ أن يجمّع كل قوّاه حتى يبلغ ذروة الوضوح والصفاء: لا بدّ أن يرى، أن يرى ويكشف.” وهذا الذي يكشفه المقاتل الذي اختار الموت (الكاميكاز) في لحظة الموت نفسها إنما هو هذه الحقيقة المدوّخة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مقدرة على الارتقاء إلى ذروة التسامي.ا
هذا التصور ذاته كان قد أرّق جورج باطاي فكتب جازما: “لا بدّ أن يكون المرء قد انخطف بالمقدّس حتى يواجه الموت.” لكن ميشيما يعمد إلى توضيح هذه الرؤية قصد الإمعان في تبيانها والتشديد عليها، فيجعل أبطاله يختارون الموت مواجهة وانتحارا وهم على يقين من أنهم إنما يقدمون أنفسهم قرابين لانتشال الكائن وإقامة المقدسات بعد أن نسيت في هذه الأزمنة الحديثة فصارت الحياة أفرغ من الفراغ، وصار وجود الإنسان على الأرض خلاء.ا
في رواية “طريق أرواح الأبطال” نقرأ قول الأبطال وهم يضحّون بأنفسهم معلنين: “إننا لم نعد نؤمن بوجود شيء غامض على الأرض. سنصبح نحن أنفسنا الغامض والغموض حتى نتمكّن من جعل الناس يشرعون في عبادة شيء ما، ويعتقدون في وجود شيء ما. وموتنا لن يكون سوى التجسيد لذلك الشيء.”هذه السلوكات والأفعال التي تحكمت بأبطال روايات ميشيما، هذا الانشداد إلى القسوة والعنف والقتل، هذا التبشير بالانتحار تمجيدا للذات وإعلاء للكائن، جميعها لم تكن مجرد مواقف وأحداث أملتها مقتضيات النسق الروائي أو قادت إليها كيفيات حبك الحكايات، بل إنها راجعة إلى رؤية ميشيما نفسه للعالم. فلقد كان ميشيما مثل باطاي بالضبط. كان يؤمن إيمانا كليا بالإشراق والانخطاف. وعن الإشراق والانخطاف يحدّث جورج باطاي جازما: “ما معنى الإشراق وما طبيعته؟ فإذا كان توهّج نور الشمس يعميني من الداخل ويشعلني حرائق ونيرانا، فإن زيادة قليل من النور أو نقصانه لا يغيّر من الأمر شيئا. ومهما يكن من أمر، هل نور الإشراقة مثل نور الشمس أم لا؟ ليس هذا مهمّا مادام الإنسان هو الإنسان. أن لا نكون سوى بشر، أن لا نقدر على الانعتاق من هذا النفق، فمعناه أننا نختنق.”ا
رحالة كان ميشيما إذن. عابر سبيل لا يكلّ. غريب مقيم في الترحال والسفر. ومفتونا كان بالغرباء جميعهم، أولئك الذين نذروا كتباتهم لفضح الأصنام وتهزئة الأكاذيب، أولئك الذين رأوا ما تنبني عليه مقولة التقدم الغربي من ليل وظلمات وويلات ستطال البشر أجمعين وتمضي بالكائن قُدُما إلى خرابه. كان احتفاؤه بنيتشه عظيما. “وكان احتفاؤه بجورج باطاي وبودلير وأندريه مالرو وجون جينيه عظيما هو الآخر.” يكتب مثلا في كتابه “بحر الخصوبة”: “أن يكون المرء إنسانا حركيا وصاحب قلم في الآن نفسه، أن يكون هو القائل وهو موضوع القول، هو الحاكم والمحكوم، أن يكون في النهاية محكوما بالإعدام وهو الذي ينفّذ حكم الإعدام، هذا هو الإشكال الصعب الذي يستحقّ فعلا أن ننعته بكون مأزقا حديثا. وهو الإشكال الذي طرحه بودلير في ما مضى من الزمان. وهو عينه الإشكال الذي تمكّنت روايات أندريه مالرو في القرن العشرين من ابتناء النموذج المجسّد له.”ا
لقد كان ميشيما على يقين من أن “الشقاء لن ينتهي من العالم”. وقبله لهج فان كوخ بهذه الجملة وهو يحتضر بعد أن أطلق النار على نفسه. هل الشقاء هو نصيب الإنسان تحت الشمس؟ اليتم والمنزلة البشرية صنوان إذن. وميشيما قد كان مأخوذا بهذا البرق. كان مأسورا في هذه الدائرة، دائرة الوعي التراجيدي بأن العدم هو الذي يمدّ الوجود بالمعنى. والمعنى إنما يتأتّى من حدث منازلة العدم اختيارا. لا انتظار إذن. لا إرجاء أيضا. على المرء أن يختار. عليه أن يتشوّف تباشير تلكم اللحظة الفريدة، لحظة التقدمة. وعليه أيضا أن يختار مكان موته. يكتب متحدّثا عن هذا القدر العاتي: “مرغم هو المرء على أن يكدح، يحثّ الخطى ويبذل الجهد. ومرغم هو أيضا، على أن يتلقّى من الضربات ما يودي به إلى السقوط. هذا هو نصيب الإنسان.”ا
طويلا كان استخدام القلم ينوب عن الاحتماء بالسيف. وعديدة هي المرات التي كانت فيها غواية السيف تستبدّ باليد التي برعت في استخدام القلم. فلقد كان ميشيما يتخذ من الكتابة كشّافا أو دليلا ليجد “الطريق إلى نفسه”. لم تكن الكتابة تسلية أو صناعة وحرفة. كانت فعل وجود. وكان ميشيما على يقين من أن تخييل الأصول بواسطة الكتابة لا يمكن أن ينوب عن تجسيد الأصول على طريقة المقاتل الياباني القديم، ذاك الذي كان يحيا في منطقة الخطر منتظرا اللحظة الفريدة، لحظة ملاقاة الموت ومنازلته. لذلك ألحّ على أن لا خيار قدّام الكتابة وقدّام كل فعل إبداعيّ إلا المواجهة، مواجهة السقطة القاسية التي يحياها الكائن. يكتب مثلا: “لا يمكن لأية رواية مهما كانت أن تجسّد، وصفا أو تخييلا، ذلك الرعب الذي يطبق على الكون حين يأتي المساء… إن قدر روايتي ليكمن في تناولي ارتباكات بني البشر من جهة كونهم مجرّد بشر. وما تقدر الرواية أن تقوله من هذا الموضوع ليس سوى حطام ومزق من اليأس المتولّد عن امتزاج الحب بالاندهاش من لامعقولية بني البشر.”ا
ولأن تخييل الأصول لا يمكن أن يغني عن تجسيد الأصول، لأن ميشيما كان على يقين من أن الكتابة ليست سوى بحث مضن عن السبيل المؤدّية إلى الذات، لأن حياة الإنسان ليست سوى طرقه إلى نفسه، ولأن خلاص المرء مشروط بوقوعه على اللحظة الفريدة التي يتمكّن خلالها من منازلة عدمه الخاص – لهذا كلّه- كان من الطبيعي أن تستسلم اليد التي برعت في استخدام القلم لغواية السيف ذات مساء.ا
في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1970 وضع الكاتب الياباني يوكيو ميشيما حدّا لحياته. لقد اختار الانتحار على طريقة اليابانيين القدامى، طريقة المحاربين النشامى، الطريقة المسمّاة “هراكيري”، تلك الطريقة التي يطلق عليها اليابانيون اسم “سبّكو” (بقر البطن بواسطة حسام مسنون). لم يكن الانتحار لحظة ضعف وهروب من الحياة، بل كان موقف كبرياء واحتجاج. كان انشقاقا وتمرّدا. كان درسا. إنه آخر درس أراد ميشيما أن يتوجّه به إلى اليابانيين وإلى العالم ليفضح فظاعة الغزو الحضاري الغربي ووحشيته.ب
لقد كان ميشيما ، في كل ما كتب، على وعي تام بأن التقدّم العلمي المدوّخ الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إنما يحمل في تلاوينه أخطر ما يمكن أن يتهدد شعوب الأرض قاطبة: نسيان ما يزخر به الماضي من قيم أصيلة واستبدالها بقيم غربية هجينة جاءت توهم بكونيتها وإنسانيتها فيما هي تخفي وجها توسّعيا عدوانيا على العالم وشعوبه وثقافاته.ب
الموت، في الظاهر، حدث نهاية، ولا رجعة. وهو أفول يؤكد أن الكلّ باطل وقبض الريح. لكن طريقة ملاقاته هي التي تفتحه من الداخل على فكرة البطولة. لذلك كثيرا ما يصبح الموت اختيارا تأكيدا للحياة وإعلاء للذات. ههنا تتنزّل طريقة الهراكيري التي اعتمدها ميشيما في ملاقاة الموت. ومن هنا أيضا تستمدّ رمزيتها وبهاءها ومضاءها. لأن الموت، في مثل هذه الحال، إنما يتخذ طابع المنازلة. وفي فعل المنازلة نفسه يصبح الموت إقرارا للحياة.ا
لقد جاء إتلاف ميشيما لنفسه على هذا النحو الفاجع بمثابة نشيد أسود يذكّر اليابانيين جميعا بالفجوة الهائلة التي خلّفها غياب القيم الأصيلة التي ابتنتها الأجيال المتعاقبة في رحلة مواجهتها لنكد الحياة ورعب الوجود. والناظر في كتابات ميشيما كلها يلاحظ، في يسر، أن الكتابة لديه كانت حدث مواجهة وفعل مجابهة. ثمّة في كتاباته جميعها حرص واضح على تخييل الأصول والدعوة إلى تمثّلها وتملّكها من جديد. لقد كان ميشيما يصدر عن نوع من الوعي المأهول بالرعب من الكيفية التي ما فتئت القيم الغربية حمّالة خراب البشر أجمعين تتوسّع بها وتنتشر في العالم مجبرة القيم الأصيلة على التراجع والأفول. إنه الوعي ذاته، الوعي المعذّب المضني الذي صدر عنه ميشال فوكو حين كتب: ” ثمّة موقع معيّن للحصة الغربية التي جرى تأسيسها عبر التاريخ لتؤمّن الأساس الضروري لعلاقة الغرب بالمجتمعات الأخرى بأسرها.”ل
* * *
صار الأصيل غريبا إذن.صار الأصيل غريبا قدّام الهجانة الزاحفة. ولا خيار قدّام الكاتب. لا توسّط أيضا. إن الدروب جميعها مقفلة ولا خلاص إلا بتقديم جسده أو فنّه قربانا لتمجيد الحياة وإعلائها.م
* * *
بهذا حدّثنا ميشيما قبل رحيله الفاجع. كتب في كتابه الأخير “ما الرواية”: “إن حريتي أوسع من أن تتحقق في الكتابة. إنها لتكمن في هذا الخيار: هجر الكتابة أو هجر الحياة.” ولم يكن هذا التصور مجرد موقف من الكتابة بل كان فعل إشهاد على أن العالم المعاصر قد ضاق بالقيم الأصيلة وكنسها من الدنيا كنسا. وهو إشهاد أيضا على محدودية كل فعل إبداعي وعجزه عن النهوض بدور حاسم في التمسّك بالأصول وتخييلها لمقاومة النسيان.ن
إن اختيار الموت راجع إذن إلى الرغبة العاتية في تأكيد الحياة. هل كان ميشيما يدري فيما هو يصوغ هذا الاعتراف أن أيامه قد صارت معدودة؟ هل كان يدري أن اليد التي برعت في استخدام القلم ستنقاد طيعة إلى غواية السيف؟ بالقلم قام ميشيما في كل ما كتبه بتخييل الأصول ومقاومة النسيان. وبالسيف وضع حدّا لحياته، مستعيدا الأصول، مجسّدا طريقة اليابانيين القدامى في ملاقاة الموت ومنازلته. فجأة حدثت التقدمة: تقدمة الجسد والروح قربانا. وعلى عجل انتقل ميشيما من الحاضر زمن التفسّخ والانحلال، زمن الموت قطرة قطرة، إلى زمن أمعن في المضيّ، الزمن الذي كان يزخر بقيم البطولة والشهامة والنبل.ن
هذا هو الدرس إذن، درس ميشيما: لا معنى للكتابة إن هي لم ترتق بالكاتب إلى مستوى التماهي مع قناعاته ومثله وطموحاته. بل إن المبدع لا ينال شرف الاسم إلا إذا تمكّن من محو المسافة الفاصلة بين نصّه وحياته. نيتشه هو الآخر كان قد نبّه إلى أن ما يتهدّد الحياة والإبداع في هذه الأزمنة الحديثة إنما هو الفجوة التي بدأت تنخر الفعل الإبداعي من الداخل على نحو بموجبه صارت العلاقة بين المبدع ونتاجه علاقة اغتراب وانفصام، وكفّ الإبداع عن كونه فعل وجود وتحوّل إلى صناعة تمعن في تغريب الكائن.ت
والناظر في نص “ما الرواية؟” وهو آخر كتاب ظلّ ميشيما يكتبه منذ ربيع 1968 حتى انتحاره في تشرين الثاني من سنة 1970، يلاحظ أن فكرة الموت قد استبدّت بالكاتب وألقت بظلالها على مجمل آرائه. كتب متحدثا عن روايته الأخيرة “بحر الخصوبة”: “حين أفرغ من كتابة هذه الرواية- إن هذه الجملة، في حد ذاتها، إنما تدخل في عداد المحرمات بالنسبة إلي. لأن العالم الذي سيتلقّفني بعد أن أفرغ من كتابة هذه الرواية عالم لا أستطيع أن أتمثّله ولا أريد أن أتخيّله وإني لأجزع منه الجزع كلّه.”م
طويلا ظلت الكتابة من جهة كونها تخييلا للأصول بمثابة منقذ في حياة ميشيما. وعديدة هي المرات التي قاومت فيها اليد التي برعت في استخدام القلم غواية السيف. لكن منازلة الموت باعتبارها تجسيدا للأصول ظلت تضطلع في كتابات ميشيما كلها بدور الخلفية التي ينحدر منها حدث الكتابة ذاته. والثابت أن إطلاع ميشيما على كتاب جورج باطاي “الأيروسية” سنة 1960 سيكون بمثابة لقية نفيسة، لقية فريدة. ومثلما هو الحال في كل حكاية لها عنفها ووهجها، ومثلما اكتملت فرحة جلجامش قديما برفيق دربه انكيدو وافتتحت الملحمة مجراها، سيتخذ ميشيما من جورج باطاي وأطروحاته معينا في رحلة بحثه عن تجسيد الأصول.م
حين قرأ ميشيما سنة 1966 كتاب “الأيروسية” احتفى بجورج باطاي احتفاء عظيما واعتبره رفيق درب استثنائيا. كان ميشيما مفتونا بنيتشه. كان مأخوذا بالكيفيّة التي دفع بها العقل إلى نهاياته واللغة إلى أقاصيها ومضى بحدث الكتابة إلى تخوم حالما بلغتها ضاع الفارق بين الشعر والفلسفة وصار التأسيس الفلسفي تأسيسا شعريا بالأساس. لذلك كتب مهلّلا: “إنه لحريّ بنا أن نسمي هذا الفيلسوف (جورج باطاي) نيتشه الأيروسية.”م
كان نيتشه مأخوذا بالفريد الذي ما يفتأ يعود. كان على وعي تام بأن ربط فكرة الحداثة بمقولة التقدّم سيقود العقل التنويري إلى ظلاميّة مهلكة. لذلك نذر كل مشروعه الفلسفي لهدم الأصنام وفضح الميتافيزيقا. وعن العودة الأبدية للفريد حدّثنا في “هكذا تكلّم زرادشت” قائلا: “سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا الأفعوان، سأعود لحياة جديدة، لا لحياة أفضل ولا لحياة مشابهة، بل إنني سأعود دائما وأبدا إلى هذه الحياة نفسها إجمالا وتفصيلا. لذلك أقول أيضا بعودة جميع الأشياء تكرارا وأبدا.” ولهذا اعتبره ميشيما رفيق درب لا غنى عنه في رحلة البحث عن الأصول.ن
لقد كان ميشيما مأخوذا بفكرة تخييل الأصول لأن العقلانية الغربية، عقلانية النهضة وما تنبني عليه من لا إنسانية وظلامية، لا يمكن أن تواجه، في نظره، إلا بالقيم الجمالية والروحية التي حرصت عقلانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على كنسها ومحوها من جميع الثقافات في الأرض قاطبة. لذلك احتفى بجورج باطاي أيضا وعدّه معلّما لا غنى للمرء عنه وعن تعاليمه في رحلة البحث عن الأصول لانتشالها من النسيان. ذلك أن كتاب “الأيروسية” إنما يتخذ طابعه الانشقاقي من كونه إنما يمثل قراءة جريئة لمحنة الكائن وحيدا منفصلا أعزل مشدودا إلى فرديته الفانية في الوقت الذي يملك فيه “هوسا باتصال أصلي يصله بالكائن عامة. ” إن كتاب “الأيروسية” هو، من هذا المنظور على الأقل، نوع من الهبوط المدوّخ نحو مناطق سحيقة، مناطق معتمة من تغريبة الإنسان ومحنته قدّام رعب الوجود. فالأيروسية ليست مجرد ألهية أو تسلية، بل هي “تعويض للكائن عن شعوره العاتي بالعزلة والانفصال بشعور من الاتصال العميق.” كما يعبّر باطاي نفسه. وهذا يعني أن الحب ليس مجرّد انجذاب إلى الآخر، إلى الصنو والشبيه والحبيب، بل هو قتل للانفصال. وهو من جهة كونه حدث اتّصال يتمّ بين كائنين منفصلين، إنما يعمّق غربة الكائن ويفتح الوجود نفسه على فكرة العدم، لأنه اتصال آني يعقبه انفصال.ت
ا“نحن كائنات منفصلة، أفراد يموتون كلّ على حدة في مغامرة مبهمة. لكننا نملك ذلك الحنين إلى الاتصال المفقود. إننا نعاني من تحمّل الوضع الذي يشدّنا إلى فرديّة المصادفة، إلى الفردية الفانية التي نمثّلها وفي نفس الوقت الذي نملك فيه الرغبة المتوتّرة في استمرار هذا الفاني، نملك أيضا هوسا باتصال أصلي يصلنا بالكائن عامّة.” هكذا يحدّثنا باطاي. إن الحب من هذا المنظور هو ميدان المواجهة: مواجهة الكائن لهشاشته، لعزلته، لانفصاله. إنه فعل وجود. لكنه عتبة مفتوحة على فكرة الموت والعدم. إنه يضعنا دائما بإزاء الموت وفي محاذاة العدم، لأن الاتصال الآني الذي ينتج عن تلاقي المحبين إنما يعمّق إحساس الكائن بعزلته وبفرديته الفانية.ا
هذا هو قدر الكائن إذن. وتلكم هي محنته العاتية الفاجعة. “فالكائنات التي تتناسل هي كائنات متميّزة ومختلفة عن بعضها بعضا. والكائنات المتولّدة عنها متميّزة فيما بينها عن الكائنات التي أنجبتها. وكل كائن متميّز ومختلف عن الآخرين كلهم. ذلك أن ولادته وموته وأحداث حياته قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى الآخرين، لكنه الوحيد المعني بذلك مباشرة. هو وحده الذي يولد. هو وحده الذي يموت. وبين كل كائن وكائن توجد هوّة، يوجد انفصال… هذه الهوة عميقة… ويمكننا جميعا أن نحسّ بدوار هذه الهوّة. ويمكنها أن تفتننا وتجذبنا. هذه الهوّة هي الموت. والموت مدوّخ. إنه فتّان.” الحب والموت صنوان إذن. الحبّ سعادة مؤقّتة. اتصال يعقبه الانفصال. امتلاء يعقبه خلاء مهلك مبيد. لذلك تكون السعادة المتولّدة عن الحب سعادة مضنية دائما. والضنى وجع، ألم، ارتباك يطال الجسد والروح معا. إنه قناع من أقنعة الموت هادم اللذات جميعها. والغبطة التي تنتج عن الحب نتيجة الاتصال بين كائنين منفصلين ليست سوى الحياة في بهائها مفتوحة على الموت ضاريا مكثفا متوحّشا.ا
ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى المعلّمين الكبار، أولئك الذين يؤمنون أن حياة المرء ليست سوى طريقه إلى نفسه كما يعبّر هرمان هيسه، فإن ميشيما لم يكتف بقراءة الكتاب للإطلاع أو للتسلّي، بل اتخذ منه معينا وسندا لاستكشاف نفسه. وفي ضوء أطروحات باطاي عاد ليقرأ ذاته ونتاجه الإبداعي. فكتب محلّلا شخصيات رواياته، معتبرا ما تحفل به تلك الروايات من قسوة وعنف، من قتل وخرق وانتهاك، أمارة على أن نتاجه الإبداعيّ يكرّس أغلب أطروحات باطاي، لأنه نتاج صادر عن روح معذّبة بالفقد، فقد الأصول والقيم التي كانت في ما مضى من الزمان تقي الإنسان من التفسّخ والاهتراء والانحلال، تلك القيم المقدّسة التي كانت تشدّ الإنسان إلى أعلى وتدفع به نحو تجاوز ذاته، وتخطّي هشاشته وضعفه، وترتقي به إلى مصاف الخارق والمتسامي والمقدّس.ا
يكتب مثلا معلّلا انتحار البطل وزوجته في كتابه “اليوكوكي”: “في لحظة تراجيدية قصوى، ودون وعي منهما، احتضن ضابط اليوكوكي وزوجته البرهة الأخيرة من حياتهما وتوغّلا، متلفين حياتيهما، في غياهب الموت ونشوة الغبطة: لقد منحا هذه الغبطة لأنهما إنما اعتنقا المبدأ نفسه، مبدأ اقتران اللذة القصوى بالوجع الجسدي الأقصى… ليلة واحدة، ليلة فريدة يصبح فيها اختيار المكان الذي نموت فيه اختيارا لأشدّ اللحظات فرحا بالحياة. هذه هي غبطتهما. وليس في هذا الاختيار أيّ طعم للهزيمة: فالحبّ الزوجي يبلغ الذروة في هذه اللحظة، ذروة التطهير والنشوة وقد امتزجا.”ل
كان اللقاء بجورج باطاي عاصفا إذن. كان زلزلة. كان نداء أسود من خلاله أمعن الموت في ممارسة سطوته وجاذبيته وفتنته على ميشيما. لقد بدأ التفكير في منازلة الموت يستبدّ بكاتب مبدع نذر مشروعه الإبداعي لتخييل الأصول وفضح عقلانية الغرب وما يتخفىّ وراء القيم الغربية المزدهية بانتشارها من نزوعات استعمارية وتوسعية وعدوانية على ثقافات الشعوب كلّها.ا
إن منازلة الموت وجها لوجه، دون مواربة وبلا مخاتلة أو إرجاء، هي ما يمكن أن يمنح المبدع شرف الاسم، ويرتقي بالكاتب إلى مستوى فنّه وأطروحاته. غير أن المنازلة نفسها لا يمكن أن تصبح تأكيدا للحياة وتمجيدا للحياة إلاّ متى كانت عاتية قاسية كالموت في توحّشه وقسوته وفظاعته.سيكتب ميشيما في الكتاب نفسه: “إن الانتحار بواسطة الحسام، وما يترتب عنه من وجع فظيع ليعادل، نتيجة ما يرافقه من شرف المنازلة مع الموت، ذاك الشرف الذي يكلّل موت المقاتلين لحظة سقوطهم في ساحات الوغى. فإذا لم نعثر على هذه الليلة، الليلة الفريدة التي نختار فيها مكان موتنا، فإن الغبطة لن تتجلّى في الحياة مطلقا. من أين جئت بهذه القناعة وكيف توصّلت إليها؟ ما أستطيع أن أقوله هو التالي: إن هذه الفكرة ذاتها هي التي تعبّر عمّا تعلّمته من تجاربي في الحرب ومن تجربتي مع نيتشه (الذي قرأته طوال سنوات الحرب). وفي هذه الفكرة أيضا، يجب أن أبحث عن سرّ تعاطفي مع جورج باطاي الذي يمكن أن ننعته بنيتشه الأيروسية.”ا
آن لليد التي برعت في استخدام القلم أن تستسلم لغواية السيف إذن. لكن الانتحار على طريقة “الهراكيري” لم يكن اتّفاقا ولم يأت صدفة كما أوضحت. لقد كان ميشيما على يقين من أن إنسان هذه الأزمنة كائن مجوّف، كائن محشوّ قشّا، تتبعه اللعنة حيثما حلّ، لأنه أشاح بوجهه عن المقدّس. ولا سبيل إلى انتشال الحياة من التّفسّخ والانحلال إلا بتقديم الجسد والروح قربانا لإدراج المقدّس في الذات.”إن حياة الإنسان هي طريقه إلى نفسه. ولم يحصل إنسان ما على الوعي الكلّيّ بذاته حتى الآن. إلاّ أن ذلك هو ما يريده كل إنسان. ثمة من الناس من يحاول تحقيق ذلك بإصرار وعمل متواصلين، ومنهم من يبذل مجهودا أقل، إلا أن الجميع يحملون معهم بقايا مولدهم: اللزوجة وقشور البيض، حتى النهاية.” هكذا حدّثنا هرمان هيس. والناظر في حياة ميشيما وفي مسيرته الفكرية والإبداعية يلاحظ أنه كان منذ شبابه المبكر مأخوذا إلى حدّ الهوس بالبحث عن السبيل التي تخلّص الكائن من اللزوجة وتقيه من التّفسّخ والانحلال. كيف يلاقي المرء قدره ويجد الطريق إلى نفسه ويحقق نجاته؟ا
منذ فترة مبكّرة وجد ميشيما الإجابة على هذا السؤال المضني: لاشيء كالرعب يمكّن من تجديد الوجود وإنقاذ الكائن من اللزوجة. كتب وهو لم يبلغ بعد السنة الخامسة عشرة من عمره:ا
ليلة، فليلة تمرّ الليالي تباعا، وواقفا أظل قرب النافذة
أمنّي النفس بحدوث كارثة،ا
كنت أنتظر أن تتدفّق من الجانب الآخر من المدينة
مثل قوس قزح ليليّ
سحابة من غبار الرزيّة بلا رحمة.ا
إن الرعب وحده كفيل بتجديد الوجود. ولا شيء أشدّ فظاعة وأكثر توحّشا من الموت. ومواجهة الموت اختيارا، مواجهة الموت وجها لوجه دون مواربة أو زيغ، هي الحدث الوحيد الذي يمكن أن يضع المرء في حضرة الرعب مكثّفا.من هذه القناعة انطلق ميشيما حين جعل أبطاله في نص “دروب أرواح الأبطال” يختارون الموت مواجهة، فينقضّون بطائراتهم على جسر حاملة طائرات العدوّ، وكتب “دون وجع، مكفّنا كان بإشراقات نورانية ناصعة البياض، إشراقات تجعل المرء يفقد وعيه، مركّزا حدقتيه على ذلك الخطّ الفضّي المتموج الذي يقترب. لا بدّ أن يجمّع كل قوّاه حتى يبلغ ذروة الوضوح والصفاء: لا بدّ أن يرى، أن يرى ويكشف.” وهذا الذي يكشفه المقاتل الذي اختار الموت (الكاميكاز) في لحظة الموت نفسها إنما هو هذه الحقيقة المدوّخة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مقدرة على الارتقاء إلى ذروة التسامي.ا
هذا التصور ذاته كان قد أرّق جورج باطاي فكتب جازما: “لا بدّ أن يكون المرء قد انخطف بالمقدّس حتى يواجه الموت.” لكن ميشيما يعمد إلى توضيح هذه الرؤية قصد الإمعان في تبيانها والتشديد عليها، فيجعل أبطاله يختارون الموت مواجهة وانتحارا وهم على يقين من أنهم إنما يقدمون أنفسهم قرابين لانتشال الكائن وإقامة المقدسات بعد أن نسيت في هذه الأزمنة الحديثة فصارت الحياة أفرغ من الفراغ، وصار وجود الإنسان على الأرض خلاء.ا
في رواية “طريق أرواح الأبطال” نقرأ قول الأبطال وهم يضحّون بأنفسهم معلنين: “إننا لم نعد نؤمن بوجود شيء غامض على الأرض. سنصبح نحن أنفسنا الغامض والغموض حتى نتمكّن من جعل الناس يشرعون في عبادة شيء ما، ويعتقدون في وجود شيء ما. وموتنا لن يكون سوى التجسيد لذلك الشيء.”هذه السلوكات والأفعال التي تحكمت بأبطال روايات ميشيما، هذا الانشداد إلى القسوة والعنف والقتل، هذا التبشير بالانتحار تمجيدا للذات وإعلاء للكائن، جميعها لم تكن مجرد مواقف وأحداث أملتها مقتضيات النسق الروائي أو قادت إليها كيفيات حبك الحكايات، بل إنها راجعة إلى رؤية ميشيما نفسه للعالم. فلقد كان ميشيما مثل باطاي بالضبط. كان يؤمن إيمانا كليا بالإشراق والانخطاف. وعن الإشراق والانخطاف يحدّث جورج باطاي جازما: “ما معنى الإشراق وما طبيعته؟ فإذا كان توهّج نور الشمس يعميني من الداخل ويشعلني حرائق ونيرانا، فإن زيادة قليل من النور أو نقصانه لا يغيّر من الأمر شيئا. ومهما يكن من أمر، هل نور الإشراقة مثل نور الشمس أم لا؟ ليس هذا مهمّا مادام الإنسان هو الإنسان. أن لا نكون سوى بشر، أن لا نقدر على الانعتاق من هذا النفق، فمعناه أننا نختنق.”ا
رحالة كان ميشيما إذن. عابر سبيل لا يكلّ. غريب مقيم في الترحال والسفر. ومفتونا كان بالغرباء جميعهم، أولئك الذين نذروا كتباتهم لفضح الأصنام وتهزئة الأكاذيب، أولئك الذين رأوا ما تنبني عليه مقولة التقدم الغربي من ليل وظلمات وويلات ستطال البشر أجمعين وتمضي بالكائن قُدُما إلى خرابه. كان احتفاؤه بنيتشه عظيما. “وكان احتفاؤه بجورج باطاي وبودلير وأندريه مالرو وجون جينيه عظيما هو الآخر.” يكتب مثلا في كتابه “بحر الخصوبة”: “أن يكون المرء إنسانا حركيا وصاحب قلم في الآن نفسه، أن يكون هو القائل وهو موضوع القول، هو الحاكم والمحكوم، أن يكون في النهاية محكوما بالإعدام وهو الذي ينفّذ حكم الإعدام، هذا هو الإشكال الصعب الذي يستحقّ فعلا أن ننعته بكون مأزقا حديثا. وهو الإشكال الذي طرحه بودلير في ما مضى من الزمان. وهو عينه الإشكال الذي تمكّنت روايات أندريه مالرو في القرن العشرين من ابتناء النموذج المجسّد له.”ا
لقد كان ميشيما على يقين من أن “الشقاء لن ينتهي من العالم”. وقبله لهج فان كوخ بهذه الجملة وهو يحتضر بعد أن أطلق النار على نفسه. هل الشقاء هو نصيب الإنسان تحت الشمس؟ اليتم والمنزلة البشرية صنوان إذن. وميشيما قد كان مأخوذا بهذا البرق. كان مأسورا في هذه الدائرة، دائرة الوعي التراجيدي بأن العدم هو الذي يمدّ الوجود بالمعنى. والمعنى إنما يتأتّى من حدث منازلة العدم اختيارا. لا انتظار إذن. لا إرجاء أيضا. على المرء أن يختار. عليه أن يتشوّف تباشير تلكم اللحظة الفريدة، لحظة التقدمة. وعليه أيضا أن يختار مكان موته. يكتب متحدّثا عن هذا القدر العاتي: “مرغم هو المرء على أن يكدح، يحثّ الخطى ويبذل الجهد. ومرغم هو أيضا، على أن يتلقّى من الضربات ما يودي به إلى السقوط. هذا هو نصيب الإنسان.”ا
طويلا كان استخدام القلم ينوب عن الاحتماء بالسيف. وعديدة هي المرات التي كانت فيها غواية السيف تستبدّ باليد التي برعت في استخدام القلم. فلقد كان ميشيما يتخذ من الكتابة كشّافا أو دليلا ليجد “الطريق إلى نفسه”. لم تكن الكتابة تسلية أو صناعة وحرفة. كانت فعل وجود. وكان ميشيما على يقين من أن تخييل الأصول بواسطة الكتابة لا يمكن أن ينوب عن تجسيد الأصول على طريقة المقاتل الياباني القديم، ذاك الذي كان يحيا في منطقة الخطر منتظرا اللحظة الفريدة، لحظة ملاقاة الموت ومنازلته. لذلك ألحّ على أن لا خيار قدّام الكتابة وقدّام كل فعل إبداعيّ إلا المواجهة، مواجهة السقطة القاسية التي يحياها الكائن. يكتب مثلا: “لا يمكن لأية رواية مهما كانت أن تجسّد، وصفا أو تخييلا، ذلك الرعب الذي يطبق على الكون حين يأتي المساء… إن قدر روايتي ليكمن في تناولي ارتباكات بني البشر من جهة كونهم مجرّد بشر. وما تقدر الرواية أن تقوله من هذا الموضوع ليس سوى حطام ومزق من اليأس المتولّد عن امتزاج الحب بالاندهاش من لامعقولية بني البشر.”ا
ولأن تخييل الأصول لا يمكن أن يغني عن تجسيد الأصول، لأن ميشيما كان على يقين من أن الكتابة ليست سوى بحث مضن عن السبيل المؤدّية إلى الذات، لأن حياة الإنسان ليست سوى طرقه إلى نفسه، ولأن خلاص المرء مشروط بوقوعه على اللحظة الفريدة التي يتمكّن خلالها من منازلة عدمه الخاص – لهذا كلّه- كان من الطبيعي أن تستسلم اليد التي برعت في استخدام القلم لغواية السيف ذات مساء.ا
في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1970 وضع الكاتب الياباني يوكيو ميشيما حدّا لحياته. لقد اختار الانتحار على طريقة اليابانيين القدامى، طريقة المحاربين النشامى، الطريقة المسمّاة “هراكيري”، تلك الطريقة التي يطلق عليها اليابانيون اسم “سبّكو” (بقر البطن بواسطة حسام مسنون). لم يكن الانتحار لحظة ضعف وهروب من الحياة، بل كان موقف كبرياء واحتجاج. كان انشقاقا وتمرّدا. كان درسا. إنه آخر درس أراد ميشيما أن يتوجّه به إلى اليابانيين وإلى العالم ليفضح فظاعة الغزو الحضاري الغربي ووحشيته.ب
لقد كان ميشيما ، في كل ما كتب، على وعي تام بأن التقدّم العلمي المدوّخ الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إنما يحمل في تلاوينه أخطر ما يمكن أن يتهدد شعوب الأرض قاطبة: نسيان ما يزخر به الماضي من قيم أصيلة واستبدالها بقيم غربية هجينة جاءت توهم بكونيتها وإنسانيتها فيما هي تخفي وجها توسّعيا عدوانيا على العالم وشعوبه وثقافاته.ب
الموت، في الظاهر، حدث نهاية، ولا رجعة. وهو أفول يؤكد أن الكلّ باطل وقبض الريح. لكن طريقة ملاقاته هي التي تفتحه من الداخل على فكرة البطولة. لذلك كثيرا ما يصبح الموت اختيارا تأكيدا للحياة وإعلاء للذات. ههنا تتنزّل طريقة الهراكيري التي اعتمدها ميشيما في ملاقاة الموت. ومن هنا أيضا تستمدّ رمزيتها وبهاءها ومضاءها. لأن الموت، في مثل هذه الحال، إنما يتخذ طابع المنازلة. وفي فعل المنازلة نفسه يصبح الموت إقرارا للحياة.ا
لقد جاء إتلاف ميشيما لنفسه على هذا النحو الفاجع بمثابة نشيد أسود يذكّر اليابانيين جميعا بالفجوة الهائلة التي خلّفها غياب القيم الأصيلة التي ابتنتها الأجيال المتعاقبة في رحلة مواجهتها لنكد الحياة ورعب الوجود. والناظر في كتابات ميشيما كلها يلاحظ، في يسر، أن الكتابة لديه كانت حدث مواجهة وفعل مجابهة. ثمّة في كتاباته جميعها حرص واضح على تخييل الأصول والدعوة إلى تمثّلها وتملّكها من جديد. لقد كان ميشيما يصدر عن نوع من الوعي المأهول بالرعب من الكيفية التي ما فتئت القيم الغربية حمّالة خراب البشر أجمعين تتوسّع بها وتنتشر في العالم مجبرة القيم الأصيلة على التراجع والأفول. إنه الوعي ذاته، الوعي المعذّب المضني الذي صدر عنه ميشال فوكو حين كتب: ” ثمّة موقع معيّن للحصة الغربية التي جرى تأسيسها عبر التاريخ لتؤمّن الأساس الضروري لعلاقة الغرب بالمجتمعات الأخرى بأسرها.”ل
* * *
صار الأصيل غريبا إذن.صار الأصيل غريبا قدّام الهجانة الزاحفة. ولا خيار قدّام الكاتب. لا توسّط أيضا. إن الدروب جميعها مقفلة ولا خلاص إلا بتقديم جسده أو فنّه قربانا لتمجيد الحياة وإعلائها.م
* * *
بهذا حدّثنا ميشيما قبل رحيله الفاجع. كتب في كتابه الأخير “ما الرواية”: “إن حريتي أوسع من أن تتحقق في الكتابة. إنها لتكمن في هذا الخيار: هجر الكتابة أو هجر الحياة.” ولم يكن هذا التصور مجرد موقف من الكتابة بل كان فعل إشهاد على أن العالم المعاصر قد ضاق بالقيم الأصيلة وكنسها من الدنيا كنسا. وهو إشهاد أيضا على محدودية كل فعل إبداعي وعجزه عن النهوض بدور حاسم في التمسّك بالأصول وتخييلها لمقاومة النسيان.ن
إن اختيار الموت راجع إذن إلى الرغبة العاتية في تأكيد الحياة. هل كان ميشيما يدري فيما هو يصوغ هذا الاعتراف أن أيامه قد صارت معدودة؟ هل كان يدري أن اليد التي برعت في استخدام القلم ستنقاد طيعة إلى غواية السيف؟ بالقلم قام ميشيما في كل ما كتبه بتخييل الأصول ومقاومة النسيان. وبالسيف وضع حدّا لحياته، مستعيدا الأصول، مجسّدا طريقة اليابانيين القدامى في ملاقاة الموت ومنازلته. فجأة حدثت التقدمة: تقدمة الجسد والروح قربانا. وعلى عجل انتقل ميشيما من الحاضر زمن التفسّخ والانحلال، زمن الموت قطرة قطرة، إلى زمن أمعن في المضيّ، الزمن الذي كان يزخر بقيم البطولة والشهامة والنبل.ن
هذا هو الدرس إذن، درس ميشيما: لا معنى للكتابة إن هي لم ترتق بالكاتب إلى مستوى التماهي مع قناعاته ومثله وطموحاته. بل إن المبدع لا ينال شرف الاسم إلا إذا تمكّن من محو المسافة الفاصلة بين نصّه وحياته. نيتشه هو الآخر كان قد نبّه إلى أن ما يتهدّد الحياة والإبداع في هذه الأزمنة الحديثة إنما هو الفجوة التي بدأت تنخر الفعل الإبداعي من الداخل على نحو بموجبه صارت العلاقة بين المبدع ونتاجه علاقة اغتراب وانفصام، وكفّ الإبداع عن كونه فعل وجود وتحوّل إلى صناعة تمعن في تغريب الكائن.ت
والناظر في نص “ما الرواية؟” وهو آخر كتاب ظلّ ميشيما يكتبه منذ ربيع 1968 حتى انتحاره في تشرين الثاني من سنة 1970، يلاحظ أن فكرة الموت قد استبدّت بالكاتب وألقت بظلالها على مجمل آرائه. كتب متحدثا عن روايته الأخيرة “بحر الخصوبة”: “حين أفرغ من كتابة هذه الرواية- إن هذه الجملة، في حد ذاتها، إنما تدخل في عداد المحرمات بالنسبة إلي. لأن العالم الذي سيتلقّفني بعد أن أفرغ من كتابة هذه الرواية عالم لا أستطيع أن أتمثّله ولا أريد أن أتخيّله وإني لأجزع منه الجزع كلّه.”م
طويلا ظلت الكتابة من جهة كونها تخييلا للأصول بمثابة منقذ في حياة ميشيما. وعديدة هي المرات التي قاومت فيها اليد التي برعت في استخدام القلم غواية السيف. لكن منازلة الموت باعتبارها تجسيدا للأصول ظلت تضطلع في كتابات ميشيما كلها بدور الخلفية التي ينحدر منها حدث الكتابة ذاته. والثابت أن إطلاع ميشيما على كتاب جورج باطاي “الأيروسية” سنة 1960 سيكون بمثابة لقية نفيسة، لقية فريدة. ومثلما هو الحال في كل حكاية لها عنفها ووهجها، ومثلما اكتملت فرحة جلجامش قديما برفيق دربه انكيدو وافتتحت الملحمة مجراها، سيتخذ ميشيما من جورج باطاي وأطروحاته معينا في رحلة بحثه عن تجسيد الأصول.م
حين قرأ ميشيما سنة 1966 كتاب “الأيروسية” احتفى بجورج باطاي احتفاء عظيما واعتبره رفيق درب استثنائيا. كان ميشيما مفتونا بنيتشه. كان مأخوذا بالكيفيّة التي دفع بها العقل إلى نهاياته واللغة إلى أقاصيها ومضى بحدث الكتابة إلى تخوم حالما بلغتها ضاع الفارق بين الشعر والفلسفة وصار التأسيس الفلسفي تأسيسا شعريا بالأساس. لذلك كتب مهلّلا: “إنه لحريّ بنا أن نسمي هذا الفيلسوف (جورج باطاي) نيتشه الأيروسية.”م
كان نيتشه مأخوذا بالفريد الذي ما يفتأ يعود. كان على وعي تام بأن ربط فكرة الحداثة بمقولة التقدّم سيقود العقل التنويري إلى ظلاميّة مهلكة. لذلك نذر كل مشروعه الفلسفي لهدم الأصنام وفضح الميتافيزيقا. وعن العودة الأبدية للفريد حدّثنا في “هكذا تكلّم زرادشت” قائلا: “سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا الأفعوان، سأعود لحياة جديدة، لا لحياة أفضل ولا لحياة مشابهة، بل إنني سأعود دائما وأبدا إلى هذه الحياة نفسها إجمالا وتفصيلا. لذلك أقول أيضا بعودة جميع الأشياء تكرارا وأبدا.” ولهذا اعتبره ميشيما رفيق درب لا غنى عنه في رحلة البحث عن الأصول.ن
لقد كان ميشيما مأخوذا بفكرة تخييل الأصول لأن العقلانية الغربية، عقلانية النهضة وما تنبني عليه من لا إنسانية وظلامية، لا يمكن أن تواجه، في نظره، إلا بالقيم الجمالية والروحية التي حرصت عقلانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على كنسها ومحوها من جميع الثقافات في الأرض قاطبة. لذلك احتفى بجورج باطاي أيضا وعدّه معلّما لا غنى للمرء عنه وعن تعاليمه في رحلة البحث عن الأصول لانتشالها من النسيان. ذلك أن كتاب “الأيروسية” إنما يتخذ طابعه الانشقاقي من كونه إنما يمثل قراءة جريئة لمحنة الكائن وحيدا منفصلا أعزل مشدودا إلى فرديته الفانية في الوقت الذي يملك فيه “هوسا باتصال أصلي يصله بالكائن عامة. ” إن كتاب “الأيروسية” هو، من هذا المنظور على الأقل، نوع من الهبوط المدوّخ نحو مناطق سحيقة، مناطق معتمة من تغريبة الإنسان ومحنته قدّام رعب الوجود. فالأيروسية ليست مجرد ألهية أو تسلية، بل هي “تعويض للكائن عن شعوره العاتي بالعزلة والانفصال بشعور من الاتصال العميق.” كما يعبّر باطاي نفسه. وهذا يعني أن الحب ليس مجرّد انجذاب إلى الآخر، إلى الصنو والشبيه والحبيب، بل هو قتل للانفصال. وهو من جهة كونه حدث اتّصال يتمّ بين كائنين منفصلين، إنما يعمّق غربة الكائن ويفتح الوجود نفسه على فكرة العدم، لأنه اتصال آني يعقبه انفصال.ت
ا“نحن كائنات منفصلة، أفراد يموتون كلّ على حدة في مغامرة مبهمة. لكننا نملك ذلك الحنين إلى الاتصال المفقود. إننا نعاني من تحمّل الوضع الذي يشدّنا إلى فرديّة المصادفة، إلى الفردية الفانية التي نمثّلها وفي نفس الوقت الذي نملك فيه الرغبة المتوتّرة في استمرار هذا الفاني، نملك أيضا هوسا باتصال أصلي يصلنا بالكائن عامّة.” هكذا يحدّثنا باطاي. إن الحب من هذا المنظور هو ميدان المواجهة: مواجهة الكائن لهشاشته، لعزلته، لانفصاله. إنه فعل وجود. لكنه عتبة مفتوحة على فكرة الموت والعدم. إنه يضعنا دائما بإزاء الموت وفي محاذاة العدم، لأن الاتصال الآني الذي ينتج عن تلاقي المحبين إنما يعمّق إحساس الكائن بعزلته وبفرديته الفانية.ا
هذا هو قدر الكائن إذن. وتلكم هي محنته العاتية الفاجعة. “فالكائنات التي تتناسل هي كائنات متميّزة ومختلفة عن بعضها بعضا. والكائنات المتولّدة عنها متميّزة فيما بينها عن الكائنات التي أنجبتها. وكل كائن متميّز ومختلف عن الآخرين كلهم. ذلك أن ولادته وموته وأحداث حياته قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى الآخرين، لكنه الوحيد المعني بذلك مباشرة. هو وحده الذي يولد. هو وحده الذي يموت. وبين كل كائن وكائن توجد هوّة، يوجد انفصال… هذه الهوة عميقة… ويمكننا جميعا أن نحسّ بدوار هذه الهوّة. ويمكنها أن تفتننا وتجذبنا. هذه الهوّة هي الموت. والموت مدوّخ. إنه فتّان.” الحب والموت صنوان إذن. الحبّ سعادة مؤقّتة. اتصال يعقبه الانفصال. امتلاء يعقبه خلاء مهلك مبيد. لذلك تكون السعادة المتولّدة عن الحب سعادة مضنية دائما. والضنى وجع، ألم، ارتباك يطال الجسد والروح معا. إنه قناع من أقنعة الموت هادم اللذات جميعها. والغبطة التي تنتج عن الحب نتيجة الاتصال بين كائنين منفصلين ليست سوى الحياة في بهائها مفتوحة على الموت ضاريا مكثفا متوحّشا.ا
ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى المعلّمين الكبار، أولئك الذين يؤمنون أن حياة المرء ليست سوى طريقه إلى نفسه كما يعبّر هرمان هيسه، فإن ميشيما لم يكتف بقراءة الكتاب للإطلاع أو للتسلّي، بل اتخذ منه معينا وسندا لاستكشاف نفسه. وفي ضوء أطروحات باطاي عاد ليقرأ ذاته ونتاجه الإبداعي. فكتب محلّلا شخصيات رواياته، معتبرا ما تحفل به تلك الروايات من قسوة وعنف، من قتل وخرق وانتهاك، أمارة على أن نتاجه الإبداعيّ يكرّس أغلب أطروحات باطاي، لأنه نتاج صادر عن روح معذّبة بالفقد، فقد الأصول والقيم التي كانت في ما مضى من الزمان تقي الإنسان من التفسّخ والاهتراء والانحلال، تلك القيم المقدّسة التي كانت تشدّ الإنسان إلى أعلى وتدفع به نحو تجاوز ذاته، وتخطّي هشاشته وضعفه، وترتقي به إلى مصاف الخارق والمتسامي والمقدّس.ا
يكتب مثلا معلّلا انتحار البطل وزوجته في كتابه “اليوكوكي”: “في لحظة تراجيدية قصوى، ودون وعي منهما، احتضن ضابط اليوكوكي وزوجته البرهة الأخيرة من حياتهما وتوغّلا، متلفين حياتيهما، في غياهب الموت ونشوة الغبطة: لقد منحا هذه الغبطة لأنهما إنما اعتنقا المبدأ نفسه، مبدأ اقتران اللذة القصوى بالوجع الجسدي الأقصى… ليلة واحدة، ليلة فريدة يصبح فيها اختيار المكان الذي نموت فيه اختيارا لأشدّ اللحظات فرحا بالحياة. هذه هي غبطتهما. وليس في هذا الاختيار أيّ طعم للهزيمة: فالحبّ الزوجي يبلغ الذروة في هذه اللحظة، ذروة التطهير والنشوة وقد امتزجا.”ل
كان اللقاء بجورج باطاي عاصفا إذن. كان زلزلة. كان نداء أسود من خلاله أمعن الموت في ممارسة سطوته وجاذبيته وفتنته على ميشيما. لقد بدأ التفكير في منازلة الموت يستبدّ بكاتب مبدع نذر مشروعه الإبداعي لتخييل الأصول وفضح عقلانية الغرب وما يتخفىّ وراء القيم الغربية المزدهية بانتشارها من نزوعات استعمارية وتوسعية وعدوانية على ثقافات الشعوب كلّها.ا
إن منازلة الموت وجها لوجه، دون مواربة وبلا مخاتلة أو إرجاء، هي ما يمكن أن يمنح المبدع شرف الاسم، ويرتقي بالكاتب إلى مستوى فنّه وأطروحاته. غير أن المنازلة نفسها لا يمكن أن تصبح تأكيدا للحياة وتمجيدا للحياة إلاّ متى كانت عاتية قاسية كالموت في توحّشه وقسوته وفظاعته.سيكتب ميشيما في الكتاب نفسه: “إن الانتحار بواسطة الحسام، وما يترتب عنه من وجع فظيع ليعادل، نتيجة ما يرافقه من شرف المنازلة مع الموت، ذاك الشرف الذي يكلّل موت المقاتلين لحظة سقوطهم في ساحات الوغى. فإذا لم نعثر على هذه الليلة، الليلة الفريدة التي نختار فيها مكان موتنا، فإن الغبطة لن تتجلّى في الحياة مطلقا. من أين جئت بهذه القناعة وكيف توصّلت إليها؟ ما أستطيع أن أقوله هو التالي: إن هذه الفكرة ذاتها هي التي تعبّر عمّا تعلّمته من تجاربي في الحرب ومن تجربتي مع نيتشه (الذي قرأته طوال سنوات الحرب). وفي هذه الفكرة أيضا، يجب أن أبحث عن سرّ تعاطفي مع جورج باطاي الذي يمكن أن ننعته بنيتشه الأيروسية.”ا
آن لليد التي برعت في استخدام القلم أن تستسلم لغواية السيف إذن. لكن الانتحار على طريقة “الهراكيري” لم يكن اتّفاقا ولم يأت صدفة كما أوضحت. لقد كان ميشيما على يقين من أن إنسان هذه الأزمنة كائن مجوّف، كائن محشوّ قشّا، تتبعه اللعنة حيثما حلّ، لأنه أشاح بوجهه عن المقدّس. ولا سبيل إلى انتشال الحياة من التّفسّخ والانحلال إلا بتقديم الجسد والروح قربانا لإدراج المقدّس في الذات.”إن حياة الإنسان هي طريقه إلى نفسه. ولم يحصل إنسان ما على الوعي الكلّيّ بذاته حتى الآن. إلاّ أن ذلك هو ما يريده كل إنسان. ثمة من الناس من يحاول تحقيق ذلك بإصرار وعمل متواصلين، ومنهم من يبذل مجهودا أقل، إلا أن الجميع يحملون معهم بقايا مولدهم: اللزوجة وقشور البيض، حتى النهاية.” هكذا حدّثنا هرمان هيس. والناظر في حياة ميشيما وفي مسيرته الفكرية والإبداعية يلاحظ أنه كان منذ شبابه المبكر مأخوذا إلى حدّ الهوس بالبحث عن السبيل التي تخلّص الكائن من اللزوجة وتقيه من التّفسّخ والانحلال. كيف يلاقي المرء قدره ويجد الطريق إلى نفسه ويحقق نجاته؟ا
منذ فترة مبكّرة وجد ميشيما الإجابة على هذا السؤال المضني: لاشيء كالرعب يمكّن من تجديد الوجود وإنقاذ الكائن من اللزوجة. كتب وهو لم يبلغ بعد السنة الخامسة عشرة من عمره:ا
ليلة، فليلة تمرّ الليالي تباعا، وواقفا أظل قرب النافذة
أمنّي النفس بحدوث كارثة،ا
كنت أنتظر أن تتدفّق من الجانب الآخر من المدينة
مثل قوس قزح ليليّ
سحابة من غبار الرزيّة بلا رحمة.ا
إن الرعب وحده كفيل بتجديد الوجود. ولا شيء أشدّ فظاعة وأكثر توحّشا من الموت. ومواجهة الموت اختيارا، مواجهة الموت وجها لوجه دون مواربة أو زيغ، هي الحدث الوحيد الذي يمكن أن يضع المرء في حضرة الرعب مكثّفا.من هذه القناعة انطلق ميشيما حين جعل أبطاله في نص “دروب أرواح الأبطال” يختارون الموت مواجهة، فينقضّون بطائراتهم على جسر حاملة طائرات العدوّ، وكتب “دون وجع، مكفّنا كان بإشراقات نورانية ناصعة البياض، إشراقات تجعل المرء يفقد وعيه، مركّزا حدقتيه على ذلك الخطّ الفضّي المتموج الذي يقترب. لا بدّ أن يجمّع كل قوّاه حتى يبلغ ذروة الوضوح والصفاء: لا بدّ أن يرى، أن يرى ويكشف.” وهذا الذي يكشفه المقاتل الذي اختار الموت (الكاميكاز) في لحظة الموت نفسها إنما هو هذه الحقيقة المدوّخة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مقدرة على الارتقاء إلى ذروة التسامي.ا
هذا التصور ذاته كان قد أرّق جورج باطاي فكتب جازما: “لا بدّ أن يكون المرء قد انخطف بالمقدّس حتى يواجه الموت.” لكن ميشيما يعمد إلى توضيح هذه الرؤية قصد الإمعان في تبيانها والتشديد عليها، فيجعل أبطاله يختارون الموت مواجهة وانتحارا وهم على يقين من أنهم إنما يقدمون أنفسهم قرابين لانتشال الكائن وإقامة المقدسات بعد أن نسيت في هذه الأزمنة الحديثة فصارت الحياة أفرغ من الفراغ، وصار وجود الإنسان على الأرض خلاء.ا
في رواية “طريق أرواح الأبطال” نقرأ قول الأبطال وهم يضحّون بأنفسهم معلنين: “إننا لم نعد نؤمن بوجود شيء غامض على الأرض. سنصبح نحن أنفسنا الغامض والغموض حتى نتمكّن من جعل الناس يشرعون في عبادة شيء ما، ويعتقدون في وجود شيء ما. وموتنا لن يكون سوى التجسيد لذلك الشيء.”هذه السلوكات والأفعال التي تحكمت بأبطال روايات ميشيما، هذا الانشداد إلى القسوة والعنف والقتل، هذا التبشير بالانتحار تمجيدا للذات وإعلاء للكائن، جميعها لم تكن مجرد مواقف وأحداث أملتها مقتضيات النسق الروائي أو قادت إليها كيفيات حبك الحكايات، بل إنها راجعة إلى رؤية ميشيما نفسه للعالم. فلقد كان ميشيما مثل باطاي بالضبط. كان يؤمن إيمانا كليا بالإشراق والانخطاف. وعن الإشراق والانخطاف يحدّث جورج باطاي جازما: “ما معنى الإشراق وما طبيعته؟ فإذا كان توهّج نور الشمس يعميني من الداخل ويشعلني حرائق ونيرانا، فإن زيادة قليل من النور أو نقصانه لا يغيّر من الأمر شيئا. ومهما يكن من أمر، هل نور الإشراقة مثل نور الشمس أم لا؟ ليس هذا مهمّا مادام الإنسان هو الإنسان. أن لا نكون سوى بشر، أن لا نقدر على الانعتاق من هذا النفق، فمعناه أننا نختنق.”ا
رحالة كان ميشيما إذن. عابر سبيل لا يكلّ. غريب مقيم في الترحال والسفر. ومفتونا كان بالغرباء جميعهم، أولئك الذين نذروا كتباتهم لفضح الأصنام وتهزئة الأكاذيب، أولئك الذين رأوا ما تنبني عليه مقولة التقدم الغربي من ليل وظلمات وويلات ستطال البشر أجمعين وتمضي بالكائن قُدُما إلى خرابه. كان احتفاؤه بنيتشه عظيما. “وكان احتفاؤه بجورج باطاي وبودلير وأندريه مالرو وجون جينيه عظيما هو الآخر.” يكتب مثلا في كتابه “بحر الخصوبة”: “أن يكون المرء إنسانا حركيا وصاحب قلم في الآن نفسه، أن يكون هو القائل وهو موضوع القول، هو الحاكم والمحكوم، أن يكون في النهاية محكوما بالإعدام وهو الذي ينفّذ حكم الإعدام، هذا هو الإشكال الصعب الذي يستحقّ فعلا أن ننعته بكون مأزقا حديثا. وهو الإشكال الذي طرحه بودلير في ما مضى من الزمان. وهو عينه الإشكال الذي تمكّنت روايات أندريه مالرو في القرن العشرين من ابتناء النموذج المجسّد له.”ا
لقد كان ميشيما على يقين من أن “الشقاء لن ينتهي من العالم”. وقبله لهج فان كوخ بهذه الجملة وهو يحتضر بعد أن أطلق النار على نفسه. هل الشقاء هو نصيب الإنسان تحت الشمس؟ اليتم والمنزلة البشرية صنوان إذن. وميشيما قد كان مأخوذا بهذا البرق. كان مأسورا في هذه الدائرة، دائرة الوعي التراجيدي بأن العدم هو الذي يمدّ الوجود بالمعنى. والمعنى إنما يتأتّى من حدث منازلة العدم اختيارا. لا انتظار إذن. لا إرجاء أيضا. على المرء أن يختار. عليه أن يتشوّف تباشير تلكم اللحظة الفريدة، لحظة التقدمة. وعليه أيضا أن يختار مكان موته. يكتب متحدّثا عن هذا القدر العاتي: “مرغم هو المرء على أن يكدح، يحثّ الخطى ويبذل الجهد. ومرغم هو أيضا، على أن يتلقّى من الضربات ما يودي به إلى السقوط. هذا هو نصيب الإنسان.”ا
طويلا كان استخدام القلم ينوب عن الاحتماء بالسيف. وعديدة هي المرات التي كانت فيها غواية السيف تستبدّ باليد التي برعت في استخدام القلم. فلقد كان ميشيما يتخذ من الكتابة كشّافا أو دليلا ليجد “الطريق إلى نفسه”. لم تكن الكتابة تسلية أو صناعة وحرفة. كانت فعل وجود. وكان ميشيما على يقين من أن تخييل الأصول بواسطة الكتابة لا يمكن أن ينوب عن تجسيد الأصول على طريقة المقاتل الياباني القديم، ذاك الذي كان يحيا في منطقة الخطر منتظرا اللحظة الفريدة، لحظة ملاقاة الموت ومنازلته. لذلك ألحّ على أن لا خيار قدّام الكتابة وقدّام كل فعل إبداعيّ إلا المواجهة، مواجهة السقطة القاسية التي يحياها الكائن. يكتب مثلا: “لا يمكن لأية رواية مهما كانت أن تجسّد، وصفا أو تخييلا، ذلك الرعب الذي يطبق على الكون حين يأتي المساء… إن قدر روايتي ليكمن في تناولي ارتباكات بني البشر من جهة كونهم مجرّد بشر. وما تقدر الرواية أن تقوله من هذا الموضوع ليس سوى حطام ومزق من اليأس المتولّد عن امتزاج الحب بالاندهاش من لامعقولية بني البشر.”ا
ولأن تخييل الأصول لا يمكن أن يغني عن تجسيد الأصول، لأن ميشيما كان على يقين من أن الكتابة ليست سوى بحث مضن عن السبيل المؤدّية إلى الذات، لأن حياة الإنسان ليست سوى طرقه إلى نفسه، ولأن خلاص المرء مشروط بوقوعه على اللحظة الفريدة التي يتمكّن خلالها من منازلة عدمه الخاص – لهذا كلّه- كان من الطبيعي أن تستسلم اليد التي برعت في استخدام القلم لغواية السيف ذات مساء.ا