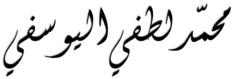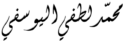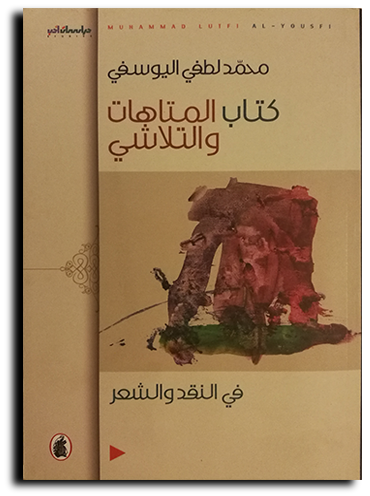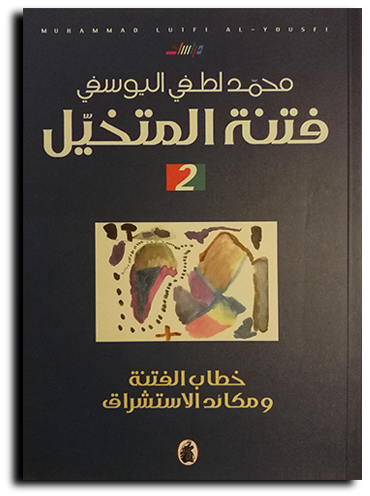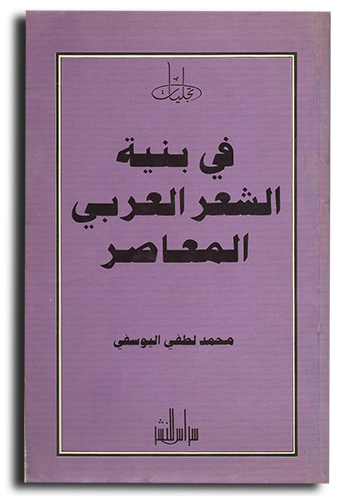ثمّة نوع من التماهي المروّع ينشأ في لحظة الكتابة بين صورة المؤلّف وصورة المستبدّ، حتّى لكأن المؤلّف في الثقافة العربية المعاصرة إنما يصدر عن الإحساس الفاجع باستحالة الخلاص، فيمارس الكتابة لا باعتبارها نشاطا له دوره التاريخي في تجديد أسئلة الثقافة العربية، بل يتّخذ منها فلك نجاةٍ ليحقق خلاصه الفرديّ فيما هو يوهم بأنه منشغل بالخلاص الجماعي؛ أو لكأنه إنّما يوهم بأنّه منشغل بالبحث عن سبل الخلاص الجماعيّ ليُعلي نفسه ويمجّدها متّخذا من المتلقّين جميعا وسائل لتحقيق استيهاماته الفرديّة فيما هو يتكتّم على افتتانه بالغلبة والقهر والاستبداد، وافتتانه بصورة المستبدّ.ا
إنه لأمر مدوّخ أن ينظّر “العالِم” لإطعام المساكين. والحال أن وجود المسكين إنما يمثّل، في حدّ ذاته، وصمة عار في جبين المجتمع. أن يوجد مسكين واحد يكون معناه أن العدالة في خطر. ومعناه أيضا أن الكرامة البشرية قد انتهكت.ا
إن القصيدة العربية المعاصرة منشغلة إلى حدّ الهوس بالبحث الدائم. لذلك نراها تنزع نحو التجريبية، تجريب جميع المسالك الممكنة، والبحث عن آفاق جديدة. إنها تتحرّك داخل معاناة البحث، وتسير فوق دروب ملغومة بالتناقضات هي، في نهاية التحليل، دروب المغامرة الكبرى التي بدأت بالخروج على المؤسسة الشعرية القديمة. ولقد أدّى ذلك البحث إلى نتيجة هامّة تتمثّل في تطوير الشعر العربي ودفعه باتجاه المغامرة والإبداع.ا
لحظة المكاشفة الشعرية هي تلك اللحظة التي ينهض فيها الشعر والشاعر. لذلك فإنّ ماهيتها متحقّقة في النص الشعري، حاضرة فيه. ولكنها متكتّمة على نفسها تتراءى عبر صوره إيماء وخطفاكما بيّنّا. فتبدو كما لو أنّها مجرّد وهم. والحال أنّها المدار الذي ينحدر منه الشعر الأصيل. وهو إذ يرتاده وينحدر منه ليحلّ بينن، يعلق بجسمه منه ما يكفي ليومئ إلى ماهية تلك اللحظة الهائلة.ب
كيف نلتقط تلك الإيماءات ونحاولها على نفسها حتّى تتحوّل إلى مسارب تضع مرتادها على عتبات المكاشفة. هذا هو الدّرب.ب
تظلّ الكلمات على خطرها وعنفها ومضائها مجرّد هشاشة تضع المحتمي بها من نكده تحت الشمس في حضرة هشاشة الكائن مطلقا. صحيح أنها تمكّنه من إعادة ابتناء العالم وإنتاجه، إذ بواسطتها وفيها يتمكّن من مواجهة المطلقات والمحرّمات، ويفلت من سلطة الممنوعات والمسلّمات. وصحيح أيضا أنها مأوى جراحات الانسان وجزء من هشاشته. لذلك تظلّ الكتابة قدرا ممضّا عاتيا يواجهه الشاعر. وهي في الآن نفسه القدر الجميل الذي يحتمي منه به، لأنه لا معنى للكائن خارج حدود هشاشته، ولا معنى للكلمات خارج ما تسمح به من مدائح في إعلاء الحياة وتمجيدها.ا
لقد نظر الفلاسفة والمنظّرون العرب في النص الشعري من منظور بنائي بياني. نظّروا لفعل الشعر وانشغلوا به، فجاءت مباحثهم تنظيرا للشعرية بصفتها صفة للشعر لا ماهية… معنى ذلك أنهم نظروا في النص القديم من زاوية وظيفية تفي بحاجات وجودهم. ألا يعني هذا أن النص القديم نفسه ما يزال في حاجة إلى الكشف؟ ألا يكون النص الحديث المبدع قد وقع، لحظة تشكّله ذاتها، على سرّ قوّة النص القديم؟ا
ثمّة نوع من التماهي المروّع ينشأ في لحظة الكتابة بين صورة المؤلّف وصورة المستبدّ، حتّى لكأن المؤلّف في الثقافة العربية المعاصرة إنما يصدر عن الإحساس الفاجع باستحالة الخلاص، فيمارس الكتابة لا باعتبارها نشاطا له دوره التاريخي في تجديد أسئلة الثقافة العربية، بل يتّخذ منها فلك نجاةٍ ليحقق خلاصه الفرديّ فيما هو يوهم بأنه منشغل بالخلاص الجماعي؛ أو لكأنه إنّما يوهم بأنّه منشغل بالبحث عن سبل الخلاص الجماعيّ ليُعلي نفسه ويمجّدها متّخذا من المتلقّين جميعا وسائل لتحقيق استيهاماته الفرديّة فيما هو يتكتّم على افتتانه بالغلبة والقهر والاستبداد، وافتتانه بصورة المستبدّ.ا
عبثًا يظلّ الخطاب النقديّ العربيّ المعاصر يواجه هذا الواقع الفاجع بالسكوت حينًا، وبالمداورة والمواربة والرياء أحياناً، فسواء أهمل النّقد هذه الظاهرة أو احتفى بها واعتبرها علامة على الحداثة والابتداء، فإنّ النتيجة تظلّ واحدة: ثمّة تواطؤ بين الشاعر والناقد، بل إنّ الناقد والشاعر قد افتضح أمرهما تمامًا.ا
إن القصيدة العربية المعاصرة منشغلة إلى حدّ الهوس بالبحث الدائم. لذلك نراها تنزع نحو التجريبية، تجريب جميع المسالك الممكنة، والبحث عن آفاق جديدة. إنها تتحرّك داخل معاناة البحث، وتسير فوق دروب ملغومة بالتناقضات هي، في نهاية التحليل، دروب المغامرة الكبرى التي بدأت بالخروج على المؤسسة الشعرية القديمة. ولقد أدّى ذلك البحث إلى نتيجة هامّة تتمثّل في تطوير الشعر العربي ودفعه باتجاه المغامرة والإبداع.ا
إنه لأمر مدوّخ أن ينظّر “العالِم” لإطعام المساكين. والحال أن وجود المسكين إنما يمثّل، في حدّ ذاته، وصمة عار في جبين المجتمع. أن يوجد مسكين واحد يكون معناه أن العدالة في خطر. ومعناه أيضا أن الكرامة البشرية قد انتهكت.ا
تظلّ الكلمات على خطرها وعنفها ومضائها مجرّد هشاشة تضع المحتمي بها من نكده تحت الشمس في حضرة هشاشة الكائن مطلقا. صحيح أنها تمكّنه من إعادة ابتناء العالم وإنتاجه، إذ بواسطتها وفيها يتمكّن من مواجهة المطلقات والمحرّمات، ويفلت من سلطة الممنوعات والمسلّمات. وصحيح أيضا أنها مأوى جراحات الانسان وجزء من هشاشته. لذلك تظلّ الكتابة قدرا ممضّا عاتيا يواجهه الشاعر. وهي في الآن نفسه القدر الجميل الذي يحتمي منه به، لأنه لا معنى للكائن خارج حدود هشاشته، ولا معنى للكلمات خارج ما تسمح به من مدائح في إعلاء الحياة وتمجيدها.ا
لحظة المكاشفة الشعرية هي تلك اللحظة التي ينهض فيها الشعر والشاعر. لذلك فإنّ ماهيتها متحقّقة في النص الشعري، حاضرة فيه. ولكنها متكتّمة على نفسها تتراءى عبر صوره إيماء وخطفاكما بيّنّا. فتبدو كما لو أنّها مجرّد وهم. والحال أنّها المدار الذي ينحدر منه الشعر الأصيل. وهو إذ يرتاده وينحدر منه ليحلّ بينن، يعلق بجسمه منه ما يكفي ليومئ إلى ماهية تلك اللحظة الهائلة.ب
كيف نلتقط تلك الإيماءات ونحاولها على نفسها حتّى تتحوّل إلى مسارب تضع مرتادها على عتبات المكاشفة. هذا هو الدّرب.ب
لقد نظر الفلاسفة والمنظّرون العرب في النص الشعري من منظور بنائي بياني. نظّروا لفعل الشعر وانشغلوا به، فجاءت مباحثهم تنظيرا للشعرية بصفتها صفة للشعر لا ماهية… معنى ذلك أنهم نظروا في النص القديم من زاوية وظيفية تفي بحاجات وجودهم. ألا يعني هذا أن النص القديم نفسه ما يزال في حاجة إلى الكشف؟ ألا يكون النص الحديث المبدع قد وقع، لحظة تشكّله ذاتها، على سرّ قوّة النص القديم؟ا