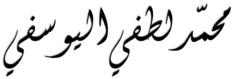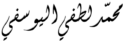ثمة في المتون العربية القديمة صحائف سوداء تؤرّخ لمحن الكتّاب الذين ابتلتهم الأقدار بحرفة الأدب. غير أن عملية التأريخ هذه تأخذ طابعا مواربا إذ لا يحدّث الكاتب عن محنته الفردية، بل يحدّث عن فساد الدنيا بأسرها فترتسم اللحظة التي يرسمها كما لو أنها لحظة الأفول الكوني الشامل. لكأن الكاتب لا يكتب عَدَمَهُ الخاص إلا بعد أن يفتحه على العدم الشامل الذي يتربّص بكلّ شيء. هذا الوعي المأسوي بالخراب لازمَ أجيالا من الكتّاب طيلة أحقاب. يكفي أن نتلفّت إلى كتابات التوحيدي أو كتابات المعري أو صلاح الدين الصفدي، وابن تغري بردي، وعبد الرحيم العباسي مثلا، وسنلاحظ أنها لا تخرج من هذه الدائرة. ولعل كتاب أحمد البديري الحلاّق ”حوادث دمشق اليومية“ إنما يمثّل لحظة من اللحظات التي استبدّ فيها هذا الوعي المأسوي بعامة الناس أيضا.

فلقد كان البديري مجرّد حلاّق من عامة الناس. وهو يفاخر بأنه حلق شَعْرَ شيخ الزمان وشاعره الأوحد عبد الغني النابلسي. لكن كتابه جاء طافحا بالهلع نفسه. لا يحدّث البديري عن مِحَنِهِ بل يرسم ناس دمشق مرتعبين جائعين لا قُوتَ ولا أَمَلَ. وتتوالى عبارات الاستنكار والاستفظاع من نوع: ”ولكنّ الغلاء قائم على قدم وساق، مع الكرب والخوف والشقاق.“ أو من نوع: ”في تلك الأيام كثر الجراد وأضرّ بالعباد… وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والغلاء والشرور.“ لذلك يطفح الكتاب بنبرة قياميّة فاجعة. يكتب البديري: ”وفي تلك الأيّام ظهر كوكبٌ وصار يطلع كل ليلة من جهة رجل في فراشِهِ بقرية زبدين… وفي ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان من هذه السنة خسف القمر خسوفا بليغا، حتى لم يظهر منه شيء.“ لقد توالت العلامات الدالّة على أن الدنيا قد فسدت وآن وقت بطلانها. يذكر البديري أن الأرض زلزلت وصارت تلفظ موتاها: ”وفي منتصف مربعانية الشتاء وقعت صخرة بنهر بردى، سدّت النهر وانقطع ثلاثة أيّام بلياليها، فأخرجوا الصخرة قِطَعاً قِطَعاً، فوجدوها قبرا قديما من قبور الحكماء.“ ثمة في الكتاب نوع من التسليم المضمر بأن الزلازل والانكسافات والخسوف وتساقط المذنّبات والنيازك بين الحين والآخر، ليست سوى علامات الأفول الآتي. لذلك يتوسّع في ذكرها قائلا مثلا: ”في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل خامس ربيع الأوّل انشقّت السماء وسُمع صريخ ودمدمة ودويّ وهول عظيم، حتى إن بعض أهل الكشف رأى السقوف ارتفعت وظهرت النجوم ثم عادت السقوف.“ وتتوالى المشاهد التي تجسّد فكرة الأفول. من ذلك مشهد تهاوي النجوم ودمدمة الجبال. لم يكتب البديري تاريخا، بل دوّن يوميّات حافلة بالتفاصيل التي يتعالى عليها المؤرّخ عادة. لم يهتمّ بالوقائع السياسيّة الكبرى، بل نقل ما رآه وما سمعه من حوادث يوميّة. لكنّه صدر في كلّ ذلك عن الوعي الفاجع المستبدّ بوجدان الكتّاب العرب طيلة أحقاب.
ثمة في المتون العربية القديمة صحائف سوداء تؤرّخ لمحن الكتّاب الذين ابتلتهم الأقدار بحرفة الأدب. غير أن عملية التأريخ هذه تأخذ طابعا مواربا إذ لا يحدّث الكاتب عن محنته الفردية، بل يحدّث عن فساد الدنيا بأسرها فترتسم اللحظة التي يرسمها كما لو أنها لحظة الأفول الكوني الشامل. لكأن الكاتب لا يكتب عَدَمَهُ الخاص إلا بعد أن يفتحه على العدم الشامل الذي يتربّص بكلّ شيء. هذا الوعي المأسوي بالخراب لازمَ أجيالا من الكتّاب طيلة أحقاب. يكفي أن نتلفّت إلى كتابات التوحيدي أو كتابات المعري أو صلاح الدين الصفدي، وابن تغري بردي، وعبد الرحيم العباسي مثلا، وسنلاحظ أنها لا تخرج من هذه الدائرة. ولعل كتاب أحمد البديري الحلاّق ”حوادث دمشق اليومية“ إنما يمثّل لحظة من اللحظات التي استبدّ فيها هذا الوعي المأسوي بعامة الناس أيضا.

فلقد كان البديري مجرّد حلاّق من عامة الناس. وهو يفاخر بأنه حلق شَعْرَ شيخ الزمان وشاعره الأوحد عبد الغني النابلسي. لكن كتابه جاء طافحا بالهلع نفسه. لا يحدّث البديري عن مِحَنِهِ بل يرسم ناس دمشق مرتعبين جائعين لا قُوتَ ولا أَمَلَ. وتتوالى عبارات الاستنكار والاستفظاع من نوع: ”ولكنّ الغلاء قائم على قدم وساق، مع الكرب والخوف والشقاق.“ أو من نوع: ”في تلك الأيام كثر الجراد وأضرّ بالعباد… وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والغلاء والشرور.“ لذلك يطفح الكتاب بنبرة قياميّة فاجعة. يكتب البديري: ”وفي تلك الأيّام ظهر كوكبٌ وصار يطلع كل ليلة من جهة رجل في فراشِهِ بقرية زبدين… وفي ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان من هذه السنة خسف القمر خسوفا بليغا، حتى لم يظهر منه شيء.“ لقد توالت العلامات الدالّة على أن الدنيا قد فسدت وآن وقت بطلانها. يذكر البديري أن الأرض زلزلت وصارت تلفظ موتاها: ”وفي منتصف مربعانية الشتاء وقعت صخرة بنهر بردى، سدّت النهر وانقطع ثلاثة أيّام بلياليها، فأخرجوا الصخرة قِطَعاً قِطَعاً، فوجدوها قبرا قديما من قبور الحكماء.“ ثمة في الكتاب نوع من التسليم المضمر بأن الزلازل والانكسافات والخسوف وتساقط المذنّبات والنيازك بين الحين والآخر، ليست سوى علامات الأفول الآتي. لذلك يتوسّع في ذكرها قائلا مثلا: ”في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل خامس ربيع الأوّل انشقّت السماء وسُمع صريخ ودمدمة ودويّ وهول عظيم، حتى إن بعض أهل الكشف رأى السقوف ارتفعت وظهرت النجوم ثم عادت السقوف.“ وتتوالى المشاهد التي تجسّد فكرة الأفول. من ذلك مشهد تهاوي النجوم ودمدمة الجبال. لم يكتب البديري تاريخا، بل دوّن يوميّات حافلة بالتفاصيل التي يتعالى عليها المؤرّخ عادة. لم يهتمّ بالوقائع السياسيّة الكبرى، بل نقل ما رآه وما سمعه من حوادث يوميّة. لكنّه صدر في كلّ ذلك عن الوعي الفاجع المستبدّ بوجدان الكتّاب العرب طيلة أحقاب.
ثمة في المتون العربية القديمة صحائف سوداء تؤرّخ لمحن الكتّاب الذين ابتلتهم الأقدار بحرفة الأدب. غير أن عملية التأريخ هذه تأخذ طابعا مواربا إذ لا يحدّث الكاتب عن محنته الفردية، بل يحدّث عن فساد الدنيا بأسرها فترتسم اللحظة التي يرسمها كما لو أنها لحظة الأفول الكوني الشامل. لكأن الكاتب لا يكتب عَدَمَهُ الخاص إلا بعد أن يفتحه على العدم الشامل الذي يتربّص بكلّ شيء. هذا الوعي المأسوي بالخراب لازمَ أجيالا من الكتّاب طيلة أحقاب. يكفي أن نتلفّت إلى كتابات التوحيدي أو كتابات المعري أو صلاح الدين الصفدي، وابن تغري بردي، وعبد الرحيم العباسي مثلا، وسنلاحظ أنها لا تخرج من هذه الدائرة. ولعل كتاب أحمد البديري الحلاّق ”حوادث دمشق اليومية“ إنما يمثّل لحظة من اللحظات التي استبدّ فيها هذا الوعي المأسوي بعامة الناس أيضا.


فلقد كان البديري مجرّد حلاّق من عامة الناس. وهو يفاخر بأنه حلق شَعْرَ شيخ الزمان وشاعره الأوحد عبد الغني النابلسي. لكن كتابه جاء طافحا بالهلع نفسه. لا يحدّث البديري عن مِحَنِهِ بل يرسم ناس دمشق مرتعبين جائعين لا قُوتَ ولا أَمَلَ. وتتوالى عبارات الاستنكار والاستفظاع من نوع: ”ولكنّ الغلاء قائم على قدم وساق، مع الكرب والخوف والشقاق.“ أو من نوع: ”في تلك الأيام كثر الجراد وأضرّ بالعباد… وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والغلاء والشرور.“ لذلك يطفح الكتاب بنبرة قياميّة فاجعة. يكتب البديري: ”وفي تلك الأيّام ظهر كوكبٌ وصار يطلع كل ليلة من جهة رجل في فراشِهِ بقرية زبدين… وفي ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان من هذه السنة خسف القمر خسوفا بليغا، حتى لم يظهر منه شيء.“ لقد توالت العلامات الدالّة على أن الدنيا قد فسدت وآن وقت بطلانها. يذكر البديري أن الأرض زلزلت وصارت تلفظ موتاها: ”وفي منتصف مربعانية الشتاء وقعت صخرة بنهر بردى، سدّت النهر وانقطع ثلاثة أيّام بلياليها، فأخرجوا الصخرة قِطَعاً قِطَعاً، فوجدوها قبرا قديما من قبور الحكماء.“ ثمة في الكتاب نوع من التسليم المضمر بأن الزلازل والانكسافات والخسوف وتساقط المذنّبات والنيازك بين الحين والآخر، ليست سوى علامات الأفول الآتي. لذلك يتوسّع في ذكرها قائلا مثلا: ”في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل خامس ربيع الأوّل انشقّت السماء وسُمع صريخ ودمدمة ودويّ وهول عظيم، حتى إن بعض أهل الكشف رأى السقوف ارتفعت وظهرت النجوم ثم عادت السقوف.“ وتتوالى المشاهد التي تجسّد فكرة الأفول. من ذلك مشهد تهاوي النجوم ودمدمة الجبال. لم يكتب البديري تاريخا، بل دوّن يوميّات حافلة بالتفاصيل التي يتعالى عليها المؤرّخ عادة. لم يهتمّ بالوقائع السياسيّة الكبرى، بل نقل ما رآه وما سمعه من حوادث يوميّة. لكنّه صدر في كلّ ذلك عن الوعي الفاجع المستبدّ بوجدان الكتّاب العرب طيلة أحقاب.
محمد لطفي اليوسفي
ثمة في المتون العربية القديمة صحائف سوداء تؤرّخ لمحن الكتّاب الذين ابتلتهم الأقدار بحرفة الأدب. غير أن عملية التأريخ هذه تأخذ طابعا مواربا إذ لا يحدّث الكاتب عن محنته الفردية، بل يحدّث عن فساد الدنيا بأسرها فترتسم اللحظة التي يرسمها كما لو أنها لحظة الأفول الكوني الشامل. لكأن الكاتب لا يكتب عَدَمَهُ الخاص إلا بعد أن يفتحه على العدم الشامل الذي يتربّص بكلّ شيء. هذا الوعي المأسوي بالخراب لازمَ أجيالا من الكتّاب طيلة أحقاب. يكفي أن نتلفّت إلى كتابات التوحيدي أو كتابات المعري أو صلاح الدين الصفدي، وابن تغري بردي، وعبد الرحيم العباسي مثلا، وسنلاحظ أنها لا تخرج من هذه الدائرة. ولعل كتاب أحمد البديري الحلاّق ”حوادث دمشق اليومية“ إنما يمثّل لحظة من اللحظات التي استبدّ فيها هذا الوعي المأسوي بعامة الناس أيضا.


فلقد كان البديري مجرّد حلاّق من عامة الناس. وهو يفاخر بأنه حلق شَعْرَ شيخ الزمان وشاعره الأوحد عبد الغني النابلسي. لكن كتابه جاء طافحا بالهلع نفسه. لا يحدّث البديري عن مِحَنِهِ بل يرسم ناس دمشق مرتعبين جائعين لا قُوتَ ولا أَمَلَ. وتتوالى عبارات الاستنكار والاستفظاع من نوع: ”ولكنّ الغلاء قائم على قدم وساق، مع الكرب والخوف والشقاق.“ أو من نوع: ”في تلك الأيام كثر الجراد وأضرّ بالعباد… وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والغلاء والشرور.“ لذلك يطفح الكتاب بنبرة قياميّة فاجعة. يكتب البديري: ”وفي تلك الأيّام ظهر كوكبٌ وصار يطلع كل ليلة من جهة رجل في فراشِهِ بقرية زبدين… وفي ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان من هذه السنة خسف القمر خسوفا بليغا، حتى لم يظهر منه شيء.“ لقد توالت العلامات الدالّة على أن الدنيا قد فسدت وآن وقت بطلانها. يذكر البديري أن الأرض زلزلت وصارت تلفظ موتاها: ”وفي منتصف مربعانية الشتاء وقعت صخرة بنهر بردى، سدّت النهر وانقطع ثلاثة أيّام بلياليها، فأخرجوا الصخرة قِطَعاً قِطَعاً، فوجدوها قبرا قديما من قبور الحكماء.“ ثمة في الكتاب نوع من التسليم المضمر بأن الزلازل والانكسافات والخسوف وتساقط المذنّبات والنيازك بين الحين والآخر، ليست سوى علامات الأفول الآتي. لذلك يتوسّع في ذكرها قائلا مثلا: ”في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل خامس ربيع الأوّل انشقّت السماء وسُمع صريخ ودمدمة ودويّ وهول عظيم، حتى إن بعض أهل الكشف رأى السقوف ارتفعت وظهرت النجوم ثم عادت السقوف.“ وتتوالى المشاهد التي تجسّد فكرة الأفول. من ذلك مشهد تهاوي النجوم ودمدمة الجبال. لم يكتب البديري تاريخا، بل دوّن يوميّات حافلة بالتفاصيل التي يتعالى عليها المؤرّخ عادة. لم يهتمّ بالوقائع السياسيّة الكبرى، بل نقل ما رآه وما سمعه من حوادث يوميّة. لكنّه صدر في كلّ ذلك عن الوعي الفاجع المستبدّ بوجدان الكتّاب العرب طيلة أحقاب.